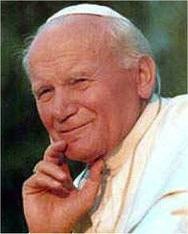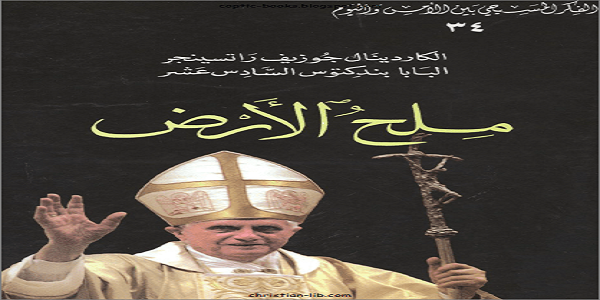رسالة إلى أساقفة الكنيسة الكاثوليكية حول التعاون بين الرجل والمرأة-قداسة البابا يوحنا بولس الثاني-ترجمة الأب/ مارون لحام
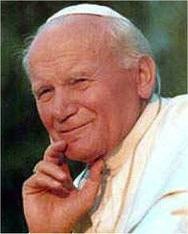
مقدمة:
1. الكنيسة “متخصّصة بأمور البشرية”، وتهتمّ دوما بكل ما يختص بالرجل والمرأة. وقد دار الحديث كثيرا في أيامنا الأخيرة حول كرامة المرأة وحقوقها وواجباتها في أكثر من مجال من الحياة الاجتماعية والكنسية. وقد ساهمت الكنيسة في هذا المجال، خصوصًا بفضل تعاليم البابا بولس الثاني، وهي ترى الآن أن عليها أن تواجه بعض التيارات الحديثة التي لا تتناسب تعاليمُها مع فكر الكنيسة حول إعلاء شأن المرأة بشكل حقيقي.
والوثيقة الحالية تنوى أن تجيب على بعض الأفكار المغلوطة حول الإنسان، ثم تعرض فكرًا مستوحى من العقيدة الكتابية حول الانسان- وهو أمر لابد منه لحماية هوية الشخص الإنسانية- وحول الأسس السليمة لقيام تعاون فعّال بين الرجل والمرأة في الكنيسة وفي العالم، مع الاعتراف بنقاط الاختلاف بينهما. من جهة ثانية، تكوّن هذه الأفكار مرحلة أولى لتعميق لاحق داخل الكنيسة ولبدء حوار مع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة، بهدف البحث الصادق عن الحقيقة والالتزام المشترك لنوع من العلاقات الصادقة.
القسم الأول: المعضلة
2. رأينا في الآونة الأخيرة توجُّهات جديدة في معالجة مسألة المرأة. أوّل توجّه يركّز بشكل كبير على خضوع المرأة بغية إثارة مواقف منتقِدة. وهكذا، لكي تكون المرأة ما هي عليه، يجب أن تكون منافسًا للرجل. فإن كان الرجل يبالغ في ممارسة سلطته، عليها هي أن تتّخذ استراتيجية البحث عن السُّلطة. وهذا النمط من التفكير يقود إلى وضع منافسه بين الجنسين، منافسة تحقق هوية الواحد ودوره فيها على حساب هوية ودور الآخر، مما يقود إلى أنثروبولوجية (علم الإنسان) تتصف بالغموض الفوضى، والعائلة هي التي تتضرّر من جراء ذلك أكثر من أي جهة أخرى.
هنالك اتجاه ثانٍ يسير في نفس الخط. فبغية تجنّب أي تسامي من جنس على الآخر، يتم انكار الاختلاف بين الجنسين، أو تفسير هذه الاختلافات على أنها وليدة الظروف التاريخية والثقافية. وهكذا فالاختلاف في الجسد، المدعو الجنس، يفقد الكثير من أهمّيته، بينما يتم التركيز على البعد الثقافي المدعو النوع. محاولة التستير على الاختلاف أو ازدواجية الجنس تقود إلى نتائج بالغة الأهمية، وعلى أكثر من صعيد. فهذه الأنثروبولوجية التي تهدف إلى تحرير المرأة من أي محدودية بيولوجية هي أساس بعض الأيديولوجيات التي تشكّك مثلاً في وضع الأسرة التي تفترض من طبيعتها وجود والدين، أي أب وأم، كما أنها تضع على نفس المستوى الميول الجنسية الطبيعية (ذكر/أنثى) والميول المثلية، مما يسبب نمطًا جديدًا في الحياة الاجتماعية والكنسية.
3. نجد الأصل المباشر لهذا النمط من التفكير في إطار معضلة المرأة. لكن أساسها البعيد هو في محاولة الشخص الإنساني أن يتحرّر من أية تحديدات بيولوجية. فحسب هذه النظرية، لا توجد في الطبيعة البشرية ميزات تفرض نفسها بشكل مطلق. فلكل شخص الحرية في أن يكون ما يريد أن يكون، ما دام غير خاضع لأي وضع تفرضه عليه الطبيعة بشكل جوهري. وهذا أمر له نتائج عديدة. فهو يؤكد النظرية القائلة أن تحرّر المرأة أمر يتناقض مع معطيات الكتاب المقدس، وهي معطيات تركّز على فكرة “بطريركية، ذكورية” عن الله، وقد أنتجت حضارة وثقافة “ذكورية” متعصّبة. ثم تعتبر هذه النظرية أنه لا توجد أهمية لكون ابن الله قد تجسّد في الطبيعة البشرية في بُعدها الذكوري.
4. إن الكنيسة، أمام هذه التيارات الفكرية، تستنير بإيمانها بيسوع المسيح، وتتكلم عن تعاون فعّال بين الرجل والمرأة، من خلال الاعتراف بما يميّزهما من اختلافات. وكي نفهم فكر الكنيسة بشكل أفضل، لا مناص من العودة الى الكتاب المقدس، الغني بالحكمة البشرية، والذي فيه عبّر الله عن جوابه بفضل تدخّله في حياة البشر لخلاصهم.
القسم الثاني: المعطيات الأساسية للأنثروبولوجية الكتابية.
5. أول نصوص تجدر دراستها هي الفصول الثلاثة الأولى من سفر التكوين. تضعنا هذه النصوص في سياق البداية، حيث تشكّل حقيقةُ خلقِ الله للإنسان “على صورته ومثاله” القاعدةَ الأساسية وغير المتغيّرة للأنثروبولوجية المسيحية.
ففي النص الأول (تك1،1-2، 4) نجد وصفًا لقدرة كلمة الله التي تضع نظامًا في الكون، فيظهر النور والظلمة، والبحر واليابسة، والنهار والليل، والمزروعات والأشجار، والسمك والطيور، كل “حسب صنفه”. وهكذا يلد عالم منظّم، مع اختلافاته التي هي في نفس الوقت، وعودٌ مستقبلية لعالم كبير من العلاقات. هذا هو الإطار العام الذي فيه سيتم خلق الإنسان. قال الله: “لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا… فخلق الله الانسان على صورته، على مثاله، ذكرًا وأنثى خلقهما” (تك1، 26–27). تظهر البشرية هنا وكأنها مؤسّسة، منذ بدايتها الأولى، على العلاقة بين الذكر والأنثى. البشرية المجنّسة هذه هي التي خلقها الله على صورته ومثاله.
6. النص الثاني من سفر النكوين (2، 4-25) يؤكّد أهمية اختلاف الجنسين بشكل قاطع. فبعد أن خلقه الله ووضعه في جنة عدن ليحرسها، الشخص الذي دُعي آدم- وهو اسم عام- يشعر بالوحدة، والظاهر أن وجود الكمّ الهائل من الحيوانات حوله لا يهمّه كثيرًا. يريد عونا له يتجاوب معه. الدور المعطى هنا للشخص الثاني ليس دور خضوع، بل دور عون حياتي. الهدف من ذلك هو منع أن تضيع حياة آدم في علاقته مع ذاته فقط، وهي علاقة عقيمة وتقود في النهاية إلى الموت. يجب أن يدخل في علاقة مع شخص آخر يكون في نفس مستواه. المرأة فقط، المخلوقة من نفس المادة، والمحاطة بنفس السرّ الإلهي، تعطي لحياة الإنسان أملاً في المستقبل. وهذا أمر يدخل في تكوين الإنسان الداخلي، بمعنى أن الله الخالق أراد أن يخلق حواء ليجعل من الوجود البشري وجودًا علاقاتياً في الجوهر. ومن هذا الالتقاء، ينطق آدم لأوّل مرة جملة متكاملة وباندهاش: “هذا عظم من عظمي ولحم من لحمي” (تك 2، 23).
يقول البابا في تلميح إلى نص سفر التكوين أن المرأة هي “أنا” آخر في الجماعة البشرية. فقد ظهر الاثنان (الرجل والمرأة) منذ البداية على أنهما “وحدة الاثنين”. وهذا يعني تخطّي الوحدة التي شعر به الإنسان من قبل، فوجد “معاونًا مشابهًا له” (تك1،22). هل يقتصر الموضوع على مساعدة كي “تعمل معه” فقط أو كي “تُخضع الأرض” معه؟ الظاهر أن الوحدة المقصودة هي وحدة حياة يتّحد بها الرجل والمرأة فصبحان “جسدًا واحدًا”، ويتركان في سبيل هذه الوحدة “أباهما وأمهما” (تك2، 24).
الاختلاف الحياتي موجّه نحو التواصل والشركة، وهو يُعاش بشكل سلس ومسالم، يعبّر عن ذلك كونهما عريانين دون خجل. لذا نقول أن الجسد البشري، المجنّس ذكرًا أو أنثى يتضمّن “منذ البداية، البُعد الزوجي، أي القدرة على التعبير عن الحب، الحب الذي من خلاله يصبح الإنسان- الشخص هبةً، ومن خلال هذه الهبة، يحقق معنى جوهره ووجوده. ويتابع البابا قائلاً: “وهكذا يصبح الجسد تعبيرًا عن الروح، ويصبح مدعوًّا، في سرّ خلقه، إلى الوجود في وحدة الأشخاص “على صورة الله”.
من هذه النظرة “الزوجية” يمكننا أن نفهم معنى نص التكوين القديم، الذي يقدّم المرأة أساسًا على أنها خُلقت “من أجل الآخر”. وهذا التأكيد لا يعني خضوع المرأة بأي شكل من الأشكال ل”الآخر”، بقدر ما يعني تشابهًا مع سر الثالوث الذي قال لنا المسيح أن أشخاصه الثلاثة يعيشون فيما بينهم شركة محبة متبادلة. ففي “وحد الاثنين”، يُدعى الرجل والمرأة منذ البدء لا لأن يعيشا “الواحد بجانب الآخر”، أو “معًا”، بل أن يعيشا “الواحد من أجل الآخر”. يقول نص سفر التكوين 2، 18-25 أن الزواج هو البُعد الأول، والأساسي نوعًا ما، لهذه الدعوة، لكنه ليس البُعد الوحيد. وحياة الإنسان على الأرض تتحقق من خلال هذه الدعوة. ومن منطلق أن كل شخص يعيش “من أجل الآخر” في شركة الأشخاص، برزت في تاريخ البشر التسمية التي أرادها الله منذ البداية: ذكر وأنثى، رجل وامرأة.
والوضع المريح الذي يصفه نص سفر التكوين هو صدى لقول الكتاب أن الله وجد ذلك “حسنًا جدًّا”. نحن هنا في قلب المخطط الإلهي الأساسي، وفي الحقيقة الجوهرية عن الرجل والمرأة، كما أرادهما الله وخلقهما. لا شك أن الخطيئة أضرّت بهذا التناغم، لكنها لن تستطيع أن تمحيه أبدًا.
7. شوّهت الخطيئة الأصلية الطريقة التي بها يقبل الرجل والمرأة كلمة الله، كما شوّهت علاقتهما بالخالق. فبعد أن وضعهما الله في جنة عدن، أعطاهما تعليمات ايجابية (تك 2،16)، تبعتها تعليمات ناهية (تك 2، 17)، تعليمات تبرز فيها بوضوح المسافة التي تفصل الله الخالق عن عالم المخلوقات. سؤال الحية يضع الاختلاف بين الرجل والمرأة موضوع الشك. ونتيجة لذلك، تشوهّت أيضًا الطريقة التي يعيشان بها اختلافهما الجنسي. المعنى المقصود من نص سفر التكوين هو: عندما تعتبر البشرية الله عدوًّا لها، تتشوّه العلاقة بين الرجل والمرأة. وعندما تتشوّة العلاقة بين الرجل والمرأة، يصعب الوصول إلى وجه الله الحقيقي.
وفي الكلمات التي يقولها الله للمرأة بعد الخطيئة، يظهر بشكل سريع وواضح نوع العلاقة التي ستسود من الآن وصاعدًا بين الرجل والمرأة. “إلى بعلك تنقاد أشواقك، وهو يسود عليك” (تك 3، 16). وهذا وضع يتحوّل فيه الحب الى مجرّد البحث عن الذات، وذلك في علاقة تشوّه معنى الحب لا بل تقتُله، وتستعيض عنه بنير ثقيل يحمّله جنس للجنس الآخر. وتاريخ البشرية مليء بالمواقف والأحداث التي تعيد إلى ذهننا اللذات الثلاثة التي يتكلم عنها القديس يوحنا في إنجيله: لذة الجسد ولذة العين ولذة المال (را 1يو2، 16). مواقف دراماتيكية تختفي فيها المساواة والاحترام والمحبة التي تفترضها العلاقة بين الرجل والمرأة كما أرادها الله منذ البدء.
8. لذا نقول أن الرجوع إلى النصوص الكتابية يسمح لنا بالتركيز على بعض المعطيات الأساسية في الانتروبولوجية الكتابية. يجب أوّلاً التركيز على الميزة الشخصية للكائن البشري. فالإنسان هو شخص، وهذا أمر يتساوى فيه الرجل والمرأة. الإثنان خُلقا على صورة الله ومثاله. والتساوي في الكرامة عند الأشخاص يتحقق في التكامل البيولوجي والنفسي والجوهري. وهذا التكامل يسمح بوجود تناغم في “الوحدة الثنائية” والعلاقاتية. وهي علاقات أصبحت موضع أزمة وتشويه بسبب الخطيئة الفردية والخطيئة “المؤسساتية”. وعندما توجد مشاكل، على المستوى الفردي أو العام، بسبب اختلاف الجنسين، فإن الكنيسة توصي بمعالجة ذلك من خلال مقاربة “علاقاتية” للمشاكل، دون اللجوء إلى مبدأ المنافسة أو المنازعة.
ثانيا، يجب التركيز على أهمية معنى اختلاف الجنسين كونه حقيقة مطبوعة في عمق الرجل والمرأة. فالجنس يميّز الرجل والمرأة، ليس فقط على المستوى البيولوجي، بل أيضا على المستوى النفسي والروحي، الذي ينطبع بميزات كلٍّ منهما. لا يمكن اقتصار الفرق بين الجنسين على الاختلافات في التكوين الجسمي فقط، الفرق هو عنصر أساسي للشخصية، وهو يحدّد شكل وجودها والتعبير عنها وعلاقتها مع الآخرين، وشعورها وأحاسيسها، وفهمها للحب وعيشه. وهذه المقدرة على الحب، وهي انعكاس عن صورة الله الذي هو محبة، تجد تعبيرًا عنها في البُعد الزوجي للجسد، الذي فيه يكون الذكر ذكرًا والأنثى أنثى.
الموضوع هو البُعد الأنتروبولوجي للجنس، وهو بُعدٌ لا يمكن فصله عن البُعد اللاهوتي. فالخليقة البشرية، في وحدة الجسد والروح، خُلقت منذ البدء كي تقيم علاقة مع غيرها. وهذه العلاقة هي في نفس الوقت حسنة ومشوّهة. حسنة لأن الله خلقها هكذا منذ البدء، لكنها مشوّهة بسبب فقدان التناغم في العلاقة بين الله والإنسان، نتيجة الخطيئة. بيد أن هذا التشويه لا يتناسب مع ما أراده الله منذ البدء للرجل والمرأة، ولا مع حقيقة العلاقة بين الجنسين. من هنا نقول أن العلاقة الحسنة والمشوّهة بين الجنسين تحتاج الى علاج.
ما هي طرق هذا العلاج؟ لا يمكن التفكير بالمشاكل المتعلّقة بما يربط بين الجنسين. تحليل هذه المشاكل انطلاقًا من الواقع المتأثر بالمشاكل نفسها يقود حتمًا إلى الأخطاء التي ذكرناها أعلاه. يجب التوقف عن منطق الخطيئة، والبحث عن مخرج يسمح بالتخلّص من هذا المنطق من قلب الانسان الخاطئ. ونجد قبسًا من النور من خلال الوعد بالمخلّص، وعدٌ، للمرأة فيه ولنسلها دورٌ ( را. تك 3، 15). وعد سيمرّ بوقت طويل من التحضير قبل أن يتحقّق.
9. نجد أول انتصار على الشر في الكتاب المقدس في قصة نوح، الرجل الصديق الذي يخلص وهو وعائلته من الطوفان، بإرشاد من الله، وتخلص معه مختلف أنواع الحيوانات (تك 6-9). لكن الأمل بالخلاص يتأكد في اختيار الله لإبراهيم ولنسله (تك12، 1 وتابع). يبدأ الله بالكشف عن وجهه، كي تتعلّم البشرية، من خلال الشعب المختار، كيف تتشبّه بالله، بالقداسة وبتغيير القلب. وبين الطرق المختلفة التي يستعملها الله المربي ليكشف نفسَه لشعبه، بصبر كبير، نجد ذِكرًا مستمرًا لفكرة العهد بين الرجل والمرأة وهذا أمر في غاية الأهمية، خصوصًا في سياق المأساة التي يذكرها سفر التكوين (الخطيئة والطوفان)، وتكرارها في زمن الأنبياء، وفي سياق الخلط بين الألوهية والجنس في الأديان المحيطة بإسرائيل في العهد القديم. وهذا التشبيه (العهد بين الرجل والمرأة) يبدو لا غنى عنه لفهم كيف وكم يحب الله شعبه. فالله يكشف عن ذاته كعريس يحب عروسه (شعبه).
وإن كان الله يوصف نفسَه في هذه العلاقة على أنه “إله غيّور” (خر20، 5)، وإن كان شعب إسرائيل يوصَف على أنه “العروس الزانية” أو “البغيّة” (هو2، 4-15 وحز16، 15-34)، فالسبب هو أن الأنبياء غذّوا، بالرغم من كل ذلك، الأمل في أن تكون أورشليم الجديدة هي “العروس المثلى”: “فإنه كما أن شابًا يتزوّج بكرًا كذلك بنوك يتزوّجونك، وكسرور العروس بالعروس يُسرّ بك إلهك” (أش 62، 5). فالمرأة التي ابتعدت لتبحث عن حياة سعيدة عند الآلهة الكذبة ستعود، وستجيب على من سيتزوّجونها “بالعدل والحكم والرأفة والمراحم” (هو 2، 19)، “كما في أيام صباها” (هو 2، 17)، وستسمعه يقول لها: “عريسك هو خالقك” (أش 54، 5). ونفس الأمر نجده جوهريا عندما يذكر الله ما سيُجريه من خلاص من خلال المسيح العبد المتألم (رجل)، يقابل ذلك ما يذكره النبي أشعيا عن صهيون (صورة الفتاة) المزيّنة بالقداسة والتي ترمز بشكل مسبق إلى هبة الخلاص المقدّم لإسرائيل.
أما سفر نشيد الأناشيد، ففيه أفضل استعمال لهذا البُعد من الوحي. فمن خلال استعمال الحب البشري الذي يُعلي شأن جمال الجسد، والفرح في البحث المتبادل بين الجنسين عن بعضهما البعض، يعبّر الله عن حبه لشعبه. لذا لم تخطئ الكنيسة عندما وجدت في هذا الوصف سرّ علاقتها بالمسيح، وجمعت بشجاعة كبيرة، مستعملة نفس التعابير، ما في الحب من وجه بشري وإلهي. وفي العهد الجديد، نجد تاريخ الخلاص يتجلّى تدريجيا، باستعمال صورة المشاركة بين الرجل والمرأة. فتعابير مثل العريس والعروس، والعهد، تتكلم عن دينامكية الخلاص، ولا شك أن فيها سمة الرموز، لكنها أكثر من مجرّد رموز. فالتعابير “الزوجية” تصيب العلاقة الأساسية التي يقيمها الله مع شعبه، ولو أن هذه العلاقة أوسع بكثير مما نختبره العلاقة بين البشر. ونفس الأمر نجده في أشعيا عندما يتكلم عن أحداث الخلاص الذي سيجريه الله. فهذا الخلاص يوجه القارئ إمّا إلى وجه رجل، المسيح عبد الله المتألم، وإمّا إلى وجه فتاة (صهيون). ويتابع أشعيا الكلام عن المسيح وعن صهيون إلى أن ينتهي في كتابه إلى رؤية أورشليم الجديدة التي تلد شعبًا كاملا في يوم واحد (أش66، 7-14)، وهي نبوءة عن التجديد الكبير الذي ينوي الله تحقيقه (أش 48، 6-8).
10. تجد كل هذه الرموز تحقيقها في العهد الجديد. فمريم – بيت صهيون – تجدّد وتسمو، بأنوثتها، صورة إسرائيل العروس التي تنتظر يوم خلاصها. ويسوع- الرجل- يجمع في شخصه كل رموز العهد القديم عن حب الله لشعبه. وصورة المسيح وأمه مريم لا تشكل فقط الاستمرارية الموجودة بين العهد القديم والعهد الجديد، بل تتخطاه، لأنه مع المسيح، كما يقول القديس ايريناوس “يظهر كلّ شيء جديدًا”. وهذا الأمر يظهر جلياً في إنجيل القديس يوحنا. ففي عرس قانا الجليل، تطلب مريم من يسوع أن يخترع معجزة – ويدعوها يسوع “امرأة” – كي يقدّم خمر جديدة كعلامة عن اتحاده المُقبل بالبشرية في عرس جديد وشامل. وهذا العرس الجديد سيتحقق على الصليب، بوجود مريم المدعوة مرّة أخرى “امرأة”، حيث سيخرج من القلب المطعون الدم / الخمر اللازم للعهد الجديد. لذا لا نستغرب عندما قال يوحنا المعمدان عن نفسه، عندما سئل، أنه صديق العريس الذي يفرح عندما يسمع صوت العريس، والذي يجب أن يصغر هو كي يكبر العريس (المسيح): “من له العروس فهو العريس، وأما صديق العروس الواقف يسمعه فهو يفرح فرحًا لصوت العروس. ففرحي هذا قد تم. وله ينبغي أن ينمو ولي أن أنقص” (يو3، 29-30).
ويتطرق بولس الرسول في تبشيره إلى نفس الموضوع (البُعد الزواجي لسر الخلاص). فهو يقول لكنيسة كورنتس: “فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدّم للمسيح بكرًا عفيفة” (2كو 11، 2). ونفس الصورة تعود في رسالته إلى كنيسة أفسس وبشكل أعمق. ففي العهد الجديد، العروس المحبوبة هي الكنيسة، وكما يقول البابا في رسالته إلى الأُسر، هذه العروس موجودة في كلّ معمّد، وهي تقدّم ذاتها إلى نظر العريس الذي “أحب كنيسته وبذل نفسه لأجلها ليقدسها مطهرًا إياها بغسل الماء وكلمة الحياة ليهديها لنفسه كنيسة مجيدة لا كلف فيها ولا غَضَن ولا شيء مثل ذلك، بل تكون مقدّسة منـزّهة بلا عيب” (أف 5، 25-27). ثم يتأمل الرسول في اتحاد الرجل والمرأة كما خلقه الله منذ البدء فيقول: “إن هذا السر لعظيم، وأعني به سرّ المسيح والكنيسة” (أف 5، 32). لذا، عندما يُعاش حب الرجل والمرأة حسب متطلّبات العماد، فإنه يصبح سر المحبة التي تجمع بين المسيح والكنيسة، وشهادةً لسر الإخلاص والوحدة التي تلد من “حواء الجديدة”، ومنه تعيش في مسيرتها الأرضية في انتظار ملء الإتحاد الأبدي.
11. عندما يدخل العروسان في السر الفصحي ويصبحان علامات حيّة للمحبة التي تجمع بين المسيح والكنيسة، فإن قلبهما يتجدّد، ويصبح بإمكانهما أن يتجنّبا العلاقات المبنيّة فقط على اللذة وعلى الميل إلى التسلّط، وهي أمور دخلت في حياة الأسرة الأولى، نتيجة الخطيئة. وهكذا يصبح صلاح الحب الأساسي ممكنًا، لأن ذكراه ما زالت حيّة، ويتم التعبير عنه بإمكانات جديدة. هذا ما عناه المسيح عندما سألوه عن الطلاق، فأجابهم أنه لم يكن الأمر في البدء هكذا، أي قبل أن تدخل الخطيئة والترتيبات اللاحقة لشريعة موسى. فجواب يسوع ليس جوابًا قاسيًا، بل هو بشرى سارّة، أعني بشرى الأمانة التي هي أقوى من الخطيئة. وبقوّة القيامة، يصبح انتصار الأمانة على مواطن الضعف التي سبّبتها الخطيئة أمرًا ممكنًا. وبفضل نعمة المسيح الذي يجدّد القلب، يصبح الرجل والمرأة قادرين على التحرّر من الخطيئة وعلى اختبار فرح العطاء المتبادل.
12. “أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم، المسيح لبستم … لم يعد هناك رجل أو امرأة” (غل 3، 27-28). لا يعني الرسول بهذا الكلمات إلغاء الفروقات بين الرجل والمرأة، لأنه في مكان آخر يقدّمها على أنها تشكّل جزءًا من مخطط الله الأساسي. ما يريد أن يقوله بولس هو: أن المنافسة والعداوة والعنف التي كانت تشوّه العلاقة بين الرجل والمرأة، يمكن التغلّب عليها، وقد تمّ فعلاً التّغلب عليها بالمسيح. وهكذا فإن الفروقات التي تميّز العلاقة بين الرجل والمرأة، والتي نراها باستمرار في الكتاب المقدس، تزداد وضوحًا وتأكيدًا. وفي ختام التاريخ الحاضر، وفيما يتكلّم سفر الرؤيا عن أرض جديدة وسماء جديدة، نرى صورة أنثوية، صورة أورشليم “مهيّأة كالعروس المزيّنة لرجلها” (رؤ21، 2). ونقرأ في ختام سفر الرؤيا هذه الكلمات التي تنتظر فيها العروس رجوع العريس: “تعال أيها الرب يسوع” (رؤ22، 20).
هكذا نرى أن المذكر والمؤنث تركيبة جوهرية في الخليقة، وهي مُعدّة لأن تستمرّ بعد هذه الحياة، ولو بشكل روحاني. وهكذا تصبح تعبيراً عن الحب الذي لا يزول، ولو أنها ستحرّر من البعد الفسيولوجي للجنس والنسل كما ستحرّر من واقع الموت. وما التكريس في العزوبية المكرّسة إلاّ استباقًا لهذه الحياة الأخروية للرجل والمرأة. ولمن يعيش هذا التكريس، فهو تذوّق مسبق لحياة، يبقى فيها الرجل رجلاً والمرأة امرأة، لكنهما لا يعودان خاضعين لمحدودية العلاقة الزوجية. وأما بالنسبة لمن يعيش الحياة الزوجية، تشكّل العزوبية المكرّسة تذكيرًا وتنبؤاً للكمال الذي ستعيشه علاقتهما في مشاهدة وجه الله. إن الرجل والمرأة المختلفين منذ بدء الخليقة إلى نهايتها، يدخلان في سر المسيح الفصحي، فلا يعودان يشعران أن اختلافهما هو سبب فرقة يجب التغلّب عليها إمّا بالتشابه في كل شيء أو بالسيطرة، بل كإمكانية تعاون يتم في الاحترام المتبادل لاختلافاتهما. من هنا، تنفتح أمامنا آفاق جديدة لفهم كرامة المرأة ولدورها في الكنيسة والمجتمع بشكل أعمق.
القسم الثالث: قيم أنثوية في حياة المجتمع.
13. بين القيم الأساسية المتعلّقة بحياة المرأة العملية، هنالك ما يُدعى “إمكانياتها على استيعاب الآخر”. فالمرأة تتمتع بحَدَس طبيعي يحملها على الاعتقاد أن أفضل ما تقوم به يتجه نحو الآخر، نحو نموّه وحمايته، بالرغم من أن بعض ما يقال في الحركات النسائية اليوم يريد أن يكون ما تفعله المرأة موجّهًا “نحو ذاتها فقط”.
هذا الحَدَس يعود إلى قدرتها البيولوجية على إعطاء الحياة. وهذه القدرة تشكّل أساسًا عميقًا للشخصية النسائية. فهي تسمح للمرأة بالنضوج بشكل مبكّر، والوعي لمعنى الحياة وقيمتها والمسؤوليات التي تنتج عنها. وهذا ينمي فيها معنى واحترام الأمور العملية، وهو أمر يتناقض مع ما نراه في حياة الأفراد والمجتمع من نظريات تقود إلى الموت (الإجهاض…). والمرأة هي الوحيدة القادرة، حتى في أحلك الظروف والأحوال – والتاريخ الماضي والحاضر يشهدان على ذلك – على الصمود أمام العداوة، وعلى جعل الحياة أمرًا ممكنًا حتى في أصعب الظروف، وعلى المحافظة بعناد على الأمل في المستقبل، وعلى التذكير– ولو بدموعها – بمعنى الحياة وقيمتها.
ولو كانت الأمومة عنصرًا أساسيًّا في هوية المرأة، فهذا لا يعني أن نعتبر المرأة فقط من ناحية قدرتها على الإنجاب. فقد تحصل في هذا المجال مبالغات غير مقبولة، تُعلى من شأن النسل بشكل متطرّف وتقود إلى احتقار المرأة. من هنا تبرز أهمية التكريس البتولي، مع ما تشكله من ثورة في منطق العهد القديم، وفي منطق المجتمع الحالي. فالتكريس شهادة ناصعة على أنه لا يمكن حصر المرأة فقط في وظيفتها وقدرتها على الإنجاب. فكما أن التكريس الرهباني يأخذ من بُعد الأمومة الفسيولوجي معنى أنه لا توجد دعوة مسيحية إلا في إطار بذل الذات، هكذا، تأخذ الأمومة الفسيولوجية من التكريس الرهباني المعنى أن دعوتها هي، في الأساس، روحية. المعنى هو أنه لا يكفي أن نعطي الحياة بيولوجيًّا كي نكون فعلاً قد أعطينا حياة، وأنه يمكن أن تجد الأمومة أشكالاً أخرى تعبرّ فيها عن ذاتها، حتى بدون ولادة بيولوجية.
ومن هذا المنظار، نفهم دور المرأة الأساسي في جميع مستويات الحياة العائلية والاجتماعية، والتي تتضمن علاقات بشرية واهتمامًا بالآخر. هنا يبرز ما دعاه البابا يوحنا بولس “عبقرية المرأة”. هذا يفترض أن تكون المرأة موجودة بشكل فعّال وفاعل وصامد في حياة الأسرة، وهي نواة المجتمع الأولى والتي لا يمكن إغفالها. ففي العائلة تتفصّل معالم الشعوب، وفي العائلة يستلم الأشخاص المبادئ الأساسية لحياتهم. في الأسرة يتعلمون أن يحبوا، لأنهم يشعرون أنهم يحَبّون فيها بشكل مجاني، وفيها يتعلمون احترام الشخص الآخر لأنهم يشعرون بالاحترام، وفيها يكتشفون صورة الله الأب، لأنهم يختبرون صورة الأب والأم الذين يوجهون إليهم كل الاهتمام. وفي كلّ مرّة تنقص هذه الخبرات الأساسية، يتأثر المجتمع ويلد عنفًا بأكثر من شكل. وهذا يفترض أيضًا وجود المرأة في حياة العمل وفي الحياة الاجتماعية، وأن يكون لها فيها مواقع مسؤولية تسمح لها بإبداء رأيها في سياسات الأمم، وبالبحث عن حلول جديدة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، يجب الاعتراف أن ازدواجية وجود المرأة في العائلة وفي المجتمع لها نتائج تختلف عنها عند الرجل. المطلوب هو وضع قوانين تأخذ بعين الاعتبار متطلّبات العمل وواجبات المرأة في أن تتواجد في العائلة. والموضوع ليس موضوعًا قانونياً أو تنظيمياً أو اقتصادياً، بل موضوع ثقافة وعقلية واحترام. لأن المطلوب هو تقدير أهمية العمل الذي تقوم به المرأة في داخل الأسرة. من هنا، تستطيع من تريد من النساء أن تكرّس حياتها كلها لخدمة بيتها، دون أن تشعر أنها أقل قيمة من غيرها اجتماعياً ودون أن تدفع ثمنًا على المستوى الاقتصادي. كما تستطيع من تريد أن تعمل أن تتمتع بحالة تسمح لها بالتوفيق بين عملها وبيتها، دون أن توضع في موضع يلزمها أن تختار بين عملها وبين بيتها، ودون أن تخضع لضغط نفسي مستمرّ، لأنّ في ذلك ضررًا لاتزانها النفسي وللتناغم الأسري. كتب البابا يوحنا بولس: “شرف للمجتمع أن يؤمّن للأم امكانية تربية أبنائها وتكريس نفسها لهم في مختلف مراحل حياتهم، دون أيّ تعدٍّ على حريتها، ودون تفرقة نفسية أو عملية، ودون أن تدفع أيّ ثمنٍ بالنسبة لباقي الأمهات”.
14. يجدر التذكير أن القيم الأنثوية التي ذكرناها هي أوّلاً قيم إنسانية. فالطبيعة البشرية عند الرجل والمرأة، المخلوقين على صورة الله، هي واحدة ولا تتجزّأ. لكن المرأة، في الواقع، أقرب إلى ممارسة هذه القيم، وتبدو وكأنها تجسّدها بشكل مميّز. بيد أن الواقع هو أن كل كائن بشري، رجلاً كان أم امرأة، مخلوق “من أجل الآخر”. ومن هذا المنظور، ما يدعي “أنوثة” لا يقتصر على كونه صفة من صفات “المرأة”. فالكلمة تعني القدرة البشرية الأساسية أن نعيش في سبيل الآخر وبفضله. من هنا يجب فهم إعلاء شأن المرأة من منطلق “الأنسنة” من خلال قيم يُعاد اكتشافها بفضل المرأة. وكل منطق ينطلق من فكرة الصراع بين الجنسين ما هو إلاّ خداع، ولا يمكن أن يقود إلاّ إلى مواقف تمييز ومنافسة بين الرجل والمرأة، وتشجع إنسانيّة منغلقة على الذات، مغلّفة بغلاف كاذب من الحرية.
لا تريد هذه الملاحظات أن تناهض الجهود المبذولة لحصول المرأة على حقوقها في الأسرة وفي المجتمع. ما تريده هو تصليح المنطلق الذي يعتبر الرجال وكأنهم خصم يجب التغلّب عليه. لا يمكن للعلاقة بين الرجل والمرأة أن تجد لها حلاّ مرضيًّا في سياق التضادّ والمنافسة والهجوم والدفاع عن النفس. يجب أن تُعاش هذه العلاقة في السلام وفي فرح المحبة المتبادلة. وعملياً، إن كان على السياسات الاجتماعية المختصة بالتربية والعائلة والعمل وتوفير الخدمات والمشاركة في الحياة العامة، أن تتجنّب أي تمييز مبني على الجنس، عليها أيضًا أن تستمع إلى احتياجات وتمنيات كل فرد. فتشجيع وحماية مبدأ التساوي في الكرامة والقيم الشخصية المشتركة، يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الاعتراف بالفروقات عندما يعني ذلك ميزات إنسانية خاصة بالرجل كرجل أو بالمرأة كامرأة.
15. أما فيما يختص بالكنيسة، فعلامة المرأة مركزية وخصبة. وهذا أمر مصدره هوية الكنيسة نفسها، وهي هوية تستلمها من الله وتتقبّلها في الإيمان. ويجب أن تكون هذه الهوية “السرّانية” حاضرة في ذهننا عندما نفكّر في دور الرجل والمرأة في الكنيسة.
اعتبرت الكنيسة نفسها، منذ بدء تاريخها على الأرض، جماعة وُلدت في المسيح وتجمعها به علاقة محبة، وهي علاقة تشكّل العلاقة الزوجية رمزًا من أقوى رموزها. من هنا يأتي أول واجب على الكنيسة، وهو أن تبقى دومًا في حضور سرّ محبة الله هذه، الذي ظهر في المسيح، وأن تتأمل فيه وتحتفل به. ويشكّل وجود مريم العذراء في الكنيسة في هذا المجال مرجعًا أساسيًَّا. يمكننا أن نشبه ذلك قائلين أن مريم العذراء تقدّم للكنيسة مرآة ينبغي على الكنيسة أن تجد فيها هويتها واستعدادات قلبها والمواقف والأعمال التي ينتظرها الله منها.
حياة مريم العذراء هي في النهاية دعوة للكنيسة كي تُجذِّر وجودها في السماع لكلمة الله واستقبالها. ذلك أن الإيمان ليس بحث الإنسان عن الله بقدر ما هو اعتراف الإنسان أن الله يبحث عنه ويزوره ويتكلم معه. وهذا الإيمان، الذي به “لا شيء يُعجز الله” (تك 18، 14، لو 1، 37) يُعاش ويتعمّق في الطاعة المتواضعة والمُحبّة التي من خلالها تتوجه الكنيسة إلى الله الآب: “ليكن لي حسب قلوك” (لو1، 38). الإيمان يعيدنا باستمرار إلى يسوع “افعلوا ما يأمركم به” (يو2، 5) ويرافقه في طريقه حتى الجلجلة. وفي أحلك ساعات الظلمة، تبقى مريم أمينة وشجاعة، يسندها في ذلك ثقتها في كلمة الله. ومريم هي التي تعلّم الكنيسة أن تعرف المسيح معرفة حميمة. وهي التي حملت يسوع الطفل في بيت لحم، تعلّمنا تواضع الله اللامتناهي. وهي التي قبلت بين ذراعيها جسد المسيح المتألم المُنـزل عن الصليب، تعلّم الكنيسة كيف تقبل هي أيضًا جميع أصناف الحياة التي يشوّهها العنف والخطيئة. تتعلم الكنيسة من مريم قوّة المحبة، كما يُظهرها الله في حياة ابنه الحبيب. “حطّ المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين…” (لو1، 51). كما يتعلّم الرسل من مريم العذارء معنى وطعم تسبيح الله أمام عظمة أعمال يديه “إن القدير صنع بي العظائم” (لوقا 1، 49)، ويتعلّمون أن يسهروا في انتظار مجيء الرب.
16. بيد أن النظر إلى مريم العذراء والتأمل في وجهها لا يعني موقفًا سلبياً تتخذه الكنيسة، ولا فكرة بائدة عن عالم الأنوثة محكوم عليه بالضعف والمجروحية، لا سيما في عالم اليوم المتميّز بتسلّط القوي. طريق المسيح ليس طريق التسلّط (فيل 2، 6)، ولا طريق القوة كما يفهمها العالم (يو 18، 36). نفهم من المسيح أن طريق الألم والتحمّل التي سلكها هي في الواقع طريق المحبة. هي قوّة ملوكيّة تنتصر على العنف وتخلّص العالم من الخطيئة ومن الموت، كما تُعيد خلق البشرية من جديد. وعندما أوكل يسوع أمه لتلميذه يوحنا، دعا المصلوب كنيسته إلى أن تتعلّم من مريم العذارء سرّ المحبة المنتَصرة.
الرجوع إلى مريم لا يعطي الكنيسة هوية مؤسسة على نموذج عابر من الأنوثة. فمثال مريم، بما فيه من جاهزية للسماع وللتواضع وللإخلاص وللتسبيح والانتظار، يضع الكنيسة في استمرارية التاريخ الروحي لشعب الله. وهذه المواقف تصبح، في المسيح وبالمسيح، دعوة كل معمّد. وهذه المواقف، بغض النظر عن الظروف ونوع الحياة والدعوات المختلفة، ووجود مسئوليات المدنية أم لا، ( هذه المواقف) تحدّد منحنىً أساسيًّا من هوية الحياة المسيحية. وإن كانت هذه المواقف مطلوبة من كل إنسان معمّد، فهي مطلوبة بشكل خاص وبَدَيهيّ، من المرأة. من هنا، يكتسي دور المرأة في الكنيسة أهمية خاصة، من جهة بتذكير جميع المؤمنين بهذا المواقف، ومن جهة ثانية بإظهار الوجه الحقيقي للكنيسة، عروس المسيح وأم المؤمنين.
نفهم أيضًا أن عدم ارتقاء النساء إلى درجة الكهنوت الخدمي لا يحطّ من شأنهنّ ولا يقلّل من مكانتهنّ في قلب الحياة المسيحية. فالنساء مدعوات في الكنيسة إلى أن يكنّ أمام جميع المعمّدين، نماذج وشهوداً للطريقة التي بها تجيب الكنيسة العروس على عريسها المسيح.
خاتمة
17. يصبح كلّ شيء جديدًا في المسيح (رؤ 21، 5). بيد أن التجديد بالنعمة لا يمكن الحصول عليه دون ارتداد القلب. يجب أن نتعرّف، في نظرنا إلى يسوع واعترافنا به ربّا، على طريق المحبة التي تغلب الخطيئة، وهي الطريق التي يعرضها المسيح على الرسل.
هكذا تتحوّل العلاقة بين الرجل والمرأة. والشهوة المثلّثة التي يتكلم عنها القديس يوحنا تخسر الرهان. يجب اعتبار الشهادة التي تعطيها المرأة على أنها كشف عن قيم لا يمكن للبشرية أن ترفضها أو أن تعيش بدونها، وإن هي عملت، عاشت منطوية منغلقة على نفسها ووقعت في فخّ العنف. وأما المرأة، فيجب أن تعترف هي أيضًا بالقيم الخاصة بها كأنثى، والتي تحملها على محبة الآخر. وفي كلا الحالتين، يتعلق الأمر برجوع الخليقة إلى الله. بحيث يعترف الرجل والمرأة أن “عونهما” يأتي من الرب، الخالق والمحب البشر، والمخلّص الذي “هكذا أحب العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد” (يو 3، 16).
هذا الرجوع إلى الله لا يمكن أن يحدث دون صلاة متواضعة إلى الله كي يعطينا شجاعة نعترف بها بخطيئتنا، ويعطينا في نفس الوقت النعمة التي تشفي. يجب التوسل إلى مريم العذراء، المرأة التي هي “حسب قلب الله”، “المباركة بين جميع النساء” (لو1، 42)، والتي اختارها الله لتكشف للبشرية، برجالها ونسائها، طريق المحبة. هكذا يمكن أن تبرز في كل رجل وكل امرأة، كل حسب نعمته الخاصة، “صورة الله” التي خُتموا بها (تك 1، 27). هكذا فقط يمكن أن نجد طريق السلام والاندهاش الذي يُعبّر عنه التقليد الكتابي من خلال سفر نشيد الأناشيد، حيث يشترك الجسد والقلب في نشيد تسبيح واحد.
إن الكنيسة واعية لقوّة الخطيئة التي تعمل في الأفراد والمجتمعات، والتي قد تقود أحيانًا إلى عدم الإيمان بصلاح الحياة الأسرية. لكن الكنيسة واعية أيضاً، بإيمانها بالمسيح المتألم والمنتصر على الموت، لقوّة المغفرة وبذل الذات بالرغم من جميع الجروح والمظالم. إن السلام والاندهاش اللذين تعرضهما الكنيسة على رجال ونساء اليوم، هو سلام واندهاش البستان الذي تمّت فيه القيامة، سلام أضاء على العالم وكشف له أن ” الله محبة” (1يو4، 8 و 16).
وافق الحبر الأعظم، في المقابلة التي منحها للكاردينال رئيس مجمع الإيمان، على نشر هذه الرسالة. روما في 31 أيار 2004، عيد زيارة سيدتنا مريم العذراء.
+ الكاردينال يوسف راتسنجر، رئيس المجمع
+ المطران انجلو أماتو، سكرتير.