آلهة الشرق القديم- ترجمة شماس ماهر عدلي

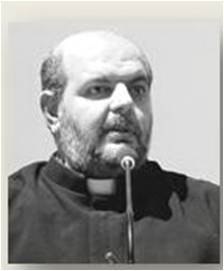
في هذا العدد نبدأ نشر ثلاث مقالات تمت ترجمتها عن الإيطالية من مجلة “عالم الكتاب المقدس Il mondo della bibbia”، عدد رقم 2 لسنة 1999، وهي مجلة تصدر بالفرنسية والإيطالية. وهذه الثلاث مقالات تعطينا فكرة عن تطور مفهوم شعوب الشرق الأدنى القديم عن الله حتى الوصول إلى عقيدة التوحيد في مصر القديمة.
1- الاشتياق للآلهة القدماء
برنارد لانج من جامعة بادربورن بألمانيا فقط منذ 150 عاماً نعرف جيداً خصائص ديانات الشرق الأدنى القديم لقد تطور، في حضارات الشرق الأدنى قديماً، نوع من الفكر الديني، على مدار آلاف السنين، قادر على إدراك الألوهية. إن نظرتنا لهذا العالم لهي نظرة ساخرة، بقدر ما يسيطر عليه من الصور التي تضمن تناغم الكون، وبقدر ما هو عامر بالآلهة، التي كثيراً ما تُخلع عليها صفات البشر، والتي كانت تكفل للعالم حماية الفرد وتماسك المدينة أو الدولة. هذه القوى الحارسة هي قريبة من البشر تعتني بهم، حتى وإن كان لديها القدرة على هجر الإنسان الأمين لها أو الانقلاب ضده بوحشية.
إن كل الحضارات القديمة في “الهلال الخصيب” (ما بين النهرين، سوريا، فلسطين، مصر) قد اختفت اليوم، وحلّت المسيحية والإسلام محل دياناتها المنقرضة. كان أفراد هذه الحضارات يؤمنون بنوع من تعددية الآلهة والإلهات، وبين الديانات الحالية بقي واحد فقط من هذه الآلهة، ألا وهو إله إسرائيل. وما يرويه لنا الكتاب المقدس عن العالم المتعدد الآلهة يجعل لدينا نوعاً من الصعوبة في تخيّل مدى الاتساع والنوعية الروحية للديانات الوثنية. فمحرري الكتاب المقدس لم يكن لديهم الاهتمام بدراسة الديانات الأخرى بطريقة “موضوعية” كما نود نحن الآن. فالحديث عن ديانات أخرى كان يحمل دائماً في طياته جدلاً وخصومة، فعندما يفشل طقس وثني في الحصول على الأمطار من إله الزوابع الكنعاني، نجد أحد الأنبياء الإسرائيليين يسخر قائلاً: “اصرخوا بصوت أعلى، فإنه إله: فلعله في شغل أو في خلوة أو في سفر، أو لعله نائم فيستيقظ” (1مل27:18). والتقليد الكتابي لا يقبل على الإطلاق العادة الوثنية لنحت الآلهة والإلهات، فهو يقول إن من يصنع صنماً من خشب الأرز على شكل إنسان هو أحمق، لأن إسرائيل لا يمثل إلهه بصورة (أش 13:44).
فقط، منذ ما يقرب من مائة وخمسين عاماً، استطعنا أن نحصل على رؤية أدق وأكثر موضوعية عن الديانات الوثنية في البيئة الكتابية. وهذا بفضل اكتشاف ودراسة حفريات هذه الحضارات، وفك شفرات كتاباتهم وترجمة نصوصهم. فنحن نملك اليوم مكتبة موثوقاً فيها عن الوثنية في الشرق الأدنى، وعن الأماكن المقدسة وصيغ العبادة وأيضاً عن أسماء الآلهة وأساطيرها.
الآلهة أسياد العالم
إن العالم الذي يعيش فيه الإنسان هو “الطبيعة Natura” أو “الكون Cosmo”. وتدل هاتان الكلمتان (واحدة من أصل لاتيني والأخرى من أصل يوناني) على نفس الحقيقة. فعلى الكون يسيطر آلهة الطبيعة أو الآلهة الكونيون. ويقال أيضاً إنه يوجد آلهة حاضرون في الطبيعة ويسيطرون عليها، وهم- كما يعتقد القدماء- يلعبون دوراً هاماً. لكن السؤال هنا من هم هؤلاء الآلهة، وكيف يسلكون؟إن ملحمة أطراحسيس تمدنا بإجابات متعددة. فهي تشير إلى خلق البشر من جانب الآلهة ومحاولاتها- التي تنتهي بالفشل- للقضاء على البشرية التي لتكاثرها تسبب لها ضوضاء وإزعاجاً. فنامتار Namtar، إله الموت والوباء، مسئول عن إطلاق المرض على البشر. لكن إنكي Enki، تأخذه الرحمة بالبشر، ويصمم أنه عندما يبدأ الوباء في إصابة البشر، سيعطي أطراحسيس- الإنسان الذي يحتمي به- طقساً معيناً للقضاء على الوباء: لا يتم إكرام أيَّة ألوهية باستثناء نامتار، حتى يضع إله الوباء- بعد استرضائه بتقدمات كثيرة- حداً لسلوكه الظالم. هكذا يكون الحال، لا يقدم البشر التقدمات إلى الآلهة الأخرى، فيرضى نامتار وتهدأ ثورة غضبه في الحال، وتنجو البشرية. هذه القصة المؤلمة يمكن أن تتكرر، فيقرر الآلهة أن يصاب البشر بالقحط والمجاعة: فإلهة الحنطة نيصابا Nisaba، لا تسمح بنمو أي شيء (حرفياً: “تغلق نيصابا ثديها”)، ويمنع أداد Adad إله الزوابع الأمطار عن الهطول. ولكن إنكي، من جديد، يعارض هذا المخطط التخريبي مرشداً البشر إلى ضرورة ترك آلهتهم الشخصية لإكرام أداد فقط (ومن المحتمل أيضاً نيصابا) إلى أن يهطل المطر وتنمو النباتات فيستطيع البشر الحياة. هذه القصة مكتوبة على ألواح بالكتابة المسمارية التي يمكن تأريخها نحو 1700 ق.م. وتوجد أيضاً بعض الأجزاء تعود إلى القرن السابع ق.م، أي أن الرواية قد ذاعت لأكثر من ألف عام. فهي تُظهر بوضوح أن علاقات الصداقة بين الآلهة والبشر ليست فطرية. بل، على العكس، يجب على البشر إكرام وتهدئة الآلهة عن طريق التقدمات لنوال رضاهم. وندرك منها أيضاً أن بعض الآلهة لهم مهام خاصة: أداد هو إله الطقس الذي يعطي الندى؛ نامتار ينشر الوباء… فالإكرام القاصر على إله واحد فقط أو زوج من الآلهة، الذي ينصح به إنكي، له هدف خاص. ففي أسطورة أطراحسيس، من المحتمل أن تكون هذه العبادة لفترة محددة أو لعدة أسابيع محددة، وفي خلال هذه الفترة يعبد إله واحد فقط حتى يحفظ البشرية ويصبح مخلصها. وفيما بعد، نجد إسرائيل، آخذاً عبادة معروفة منذ أكثر من ألف عام، لا يعترف إلا بإله واحد فقط كمخلص. فليست لكل الآلهة وظيفة كونية مثل نامتار إله الوباء، أداد إله الطقس ونيصابا إلهة الحنطة.
الإله القومي والحرب المقدسة
يمكن تصنيف ثلاث “نماذج” للآلهة: آلهة كونيون، آلهة حارسون وآلهة شخصيون. يسيطر كثير من الآلهة فقط على أقاليم صغيرة، يُعتبَرون فيها حماة لشعب معين أو دولة معينة. ويستشهد الكتاب المقدس بهؤلاء الآلهة القوميين، ويهوه، إله إسرائيل، هو واحد منهم. ومن بين هؤلاء الآلهة نجد كاموش Kamos إله الموآبيين [(1مل 7:11)] وكانوا يقطنون عبر الأردن. هذا الإله عُرف- ولوقت طويل- من خلال الكتاب المقدس فقط، حتى اكتشف الراعي والمرسل F.A. Klein والمستشرق C. C Ganneau في القرن 19، في الأردن الشرقية، الشواهد التاريخية للملك الموآبي ميشا Mesa (القرن التاسع ق.م)، وهي محفوظة الآن في متحف اللوفر.
إن النُصب الذي كان يحمل هذه الشواهد كان قائماً في معبد كرّسه هذا الملك للإله المحلي لشعبه، كاموش. ونقرأ أن كاموش غضب على شعبه لمدة أربعين عاماً، ففي خلال هذه الفترة كان إسرائيل يسيطر على جزء من الأرض الموآبية، وكان على الشعب أن يدفع لإسرائيل الضرائب. ويسترد الملك ميشا هذه الأرض فيما بعد. وتقول الشواهد بدقة: “لكن كاموش قد استردها [الأرض المحتلة]”. فكاموش لم يعد غاضباً على شعبه، بل عاد يحميه كإله محارب. وتبرز الشواهد أيضاً أن ميشا قد قاد حرباً أخرى ضد إسرائيل وانتصر عليه. وهذه الحرب تقدمها الشواهد “كحرب مقدسة” بقيادة ميشا: فالتحريض الإلهي يسبق الحرب (“قال لي كاموش: اذهب وخذ نبي من إسرائيل”). وفي النهاية يُقتل كل الأعداء، ويتم تقديمهم كمحرقات لكاموش. لقد قاد كل شعوب العالم القديم حروبهم هكذا بمساعدة وباسم آلهتهم القوميين، سواء كانوا ممالك صغيرة مثل موآب وإسرائيل، أم قوى عملاقة مثل آشور وبابل ومصر.
الإله “الشخصي”
إن الوثني الذي يحفر في خشب الأرز أو شجر الغار، صورة لإلهه، يصنع هذا حتى يرتمي تحت أقدامه مصلياً: “أنقذني، فإنما أنت إلهي” (أش 17:44). في هذه الحالة، تكون هذه الصلاة القصيرة هي الأهم وليس الوثن في ذاته. فالإله الذي يلجأ إليه الإنسان يجب أن “يخلص”، أي- وبتعبيرات عصرية- يجب أن يساعد المتضرع في المواقف الصعبة: يشفيه من مرض معين، يضع حداً للشرور الإنسانية، أو يحرره من خطر الأعداء في الحروب… فالمتضرع، يلجأ، في طلبته، إلى إله اعتبره هو “إلهه”، مظهراً بذلك الارتباط الدائم بهذه الألوهية. ونجد، في جميع حضارات الشرق الأدنى القديم، شهادات على هذه الصيغة للإيمان، والتي يمكن مقارنتها مع الإيمان المسيحي “بالملاك الحارس”. وهذه الألوهية، التي تنادى (“يا إلهي”)، يمكن أن تكون أية ألوهية من ألوهيات المعبد المحلي لجميع الآلهة Pantheon، فأي إله كان يمكنه ظاهرياً ممارسة هذه المهمة. فالمتضرع يقيم مع الألوهية التي يختارها مسبقاً علاقة حميمة ويعتبرها حاميته أو حاميه. وغالباً ما كان الفرد في الشرق الأدنى القديم يرتبط بإله واحد فقط، ولكن في بعض الأحيان نجد حالات لتعدد الآلهة الشخصية لفرد واحد. وكما يُقال، إن الإله الشخصي قد حمى المتضرع وهو في رحم أمه. فهو يعطي النجاح والصحة والرخاء؛ يمنح الخلاص في وقت الضيق. وإذا كان الفرد على علاقة بآلهة أخر، فإن إلهه الشخصي يساعده كشفيع ووسيط. ونجد في القرن 13 ق.م أحد المصريين، من ذوي المناصب العليا، يُرجع كل نجاحه إلى إلهته الحارسة “موت Mutt “. فقد كتب على جدار مدفنه: “إنه قد تأمل في ذاته باحثاً عن ألوهية حارسة، ووجد “موت” في أعلى مراتب الآلهة… كم هي جميلة حياة من تضعه “موت” تحت حمايتها! فإحسانات الملك لأجل جسد من وضعه في قلبه”. ويوجد أيضاً في مدفن المتضرع (“سيموت Simut المدعو كيكي Kiki”) صورة لهذه الإلهة (طيبة، مدفن رقم 409).
إن البشر المتدينين، مثل سيموت، ليسوا شيئاً غير عادي، فيوجد الكثير منهم في مصر القديمة كما في كل الشرق الأدنى. وتحتوي أيضاً المزامير، في الكتاب المقدس، على الكثير من الشهادات عن هذه التقوى الشخصية.
ربما يكون مفهوم الإله الشخصي هو الأحدث بين الثلاث وظائف الإلهية، التي استعرضناها من قبل. إن الآلهة الكونيين يمكن اعتبارهم أزليين، فمنذ بداية البشرية اعتُقد في قوى الطبيعة الغامضة. وبعد ذلك بكثير، بتنظيم المجتمع الأوسع، ولد الإيمان بالإله القومي. ثم جاءت مرحلة أخرى جديدة عندما أصبح الفرد واعياً بذاته، ولم يعد يُعتبر فقط عضواً في مجتمع معين. في هذه اللحظة فقط ظهر الإيمان بألوهية شخصية.هذا الإيمان يبدو قديماً جداً، بينما في الشرق الأدنى ومصر يظهر في الألف الثاني. إن المعطيات المتاحة عن تاريخ الأديان لهي من الندرة بحيث لا يمكن معها تكوين رؤية أكيدة عن مراحل تطورها. لكن على أية حال، الفكرة العامة تساعدنا على إعطاء تفسير بسيط جداً. فإنسان “ما بين النهرين” بدءاً من الألف الثاني والأول قبل المسيح، كان معروفاً عنه أنه محاط بالآلهة، وكان يُرى في وسط عالم مكوّن من دوائر متحدة المركز: في الدائرة الأولى، الأضيق، يوجد الإله (أو الإلهة) الشخصي الحارس، الذي يمنحه الأمان والصحة والخلاص من الأخطار؛ وعلى الدائرة الثانية يملك الإله القومي للشعب، وهو الإله المحارب الذي يدفع الأعداء وينصر شعبه ليجعله مسيطراً؛ أما الآلهة الكونيون فهم يحتلون الدائرة الثالثة التي هي العالم بكامله، هؤلاء الآلهة يحرسون أساسيات الطبيعة والحياة (أو يمنعونها عن الإنسان).
في الواقع، يوجد في كل دائرة من هذه الدوائر الثلاثة الشر والألم أيضاً: فالإله الشخصي يمكن أن يهجر الفرد فجأة وينزع عنه حمايته؛ وأيضاً الإله المحارب يمكنه أن ينتفض ضد شعبه وينصر عليه جيوش الأعداء؛ والآلهة الكونيون قد يمنعون فجأة بركتهم وينشرون الوباء. ولكن كثيراً ما نجد الإنسان قادراً على التحالف مع القوى المحيطة به، أي أنه يعرف كيف يكون آمناً بين القوى الخيرة. إن هذا هو ما يمنحه الأمان بهذا المعنى، والذي يغيب بصفة عامة عنّا نحن العصريين. فمن يفهم آلهة القدماء لا يملك إلا أن يتحسر لأن عالمهم قد انتهى!
عن مجلة صديق الكاهن العدد الثاني 2001



















