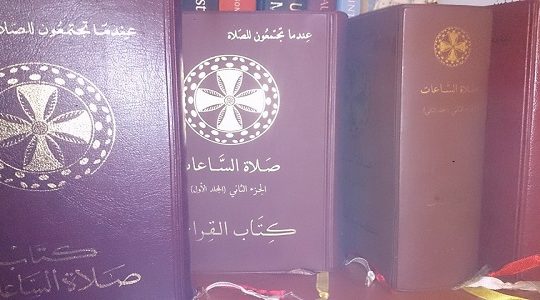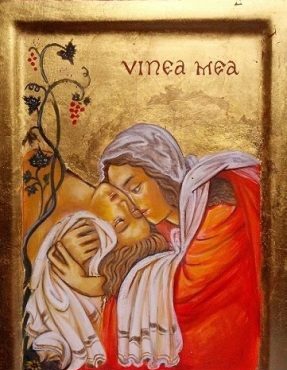البلوغ إلى الحرية / أشرف ناجح
البلوغ إلى الحرية / أشرف ناجح
سأغني الحرية، سأجاهد مِن أجلها ما حيتُ، لا وبل سأموت _إنْ لزم الأمر_ في سبيلها!
فالحرية هي أغنية عذبة، ورائحة زكية، ونسمة مملوءة بالروائح وبالعطور؛ ولكنها هي أيضاً مشوار طويل، ومسيرة شائقة وشاقة، فهي طريق مكتظ بالأحجار والأشواك والصلبان!أحلم بالحرية ليلاً ونهاراً، فهي حلم الليل في منامي وحلم النهار في يقظتي. إنها المنطق الذي تنبعث منه كل أفكاري ومشاعري. إنني أعيش من أجلها، وأود أن أموت في سبيلها! أخشى على نفسي وعلى أهلي وعلى أمتي مِن فقدان الحرية، فالحرية هي الهواء الذي نتنسَّمه، وهي الماء الذي نشربه؛ فبدون الحرية لا ثَمَّة حياة، وبدونها ما جدوى الحياة. إنني أُفضِّل أنْ أموت حراً من أنْ أعيش عبداً، وأرغب في الموت وأنا مرفوع الرأس ومشدود اليدين ومنتصب القدمين، مِن أنْ أعيش سجيناً لحياتي ومخاوفي! أحلم باليوم الذي أرى فيه كلَّ إنسان حراً ويتغنى حريته. أحلم بالحرية للأطفال وللشيوخ، للرجال وللنساء، للفقراء وللأغنياء، للبيض وللسود، للأصحاء وللمرضى، للمتدينين وللملحدين! أجل، سيأتي اليوم الذي فيه ستسكن الحرية في كل مكان وفي داخل كل الشعوب، لأنها ستسكن في قلب كل إنسان.
أجل، فلكي نحرر بلادنا وأراضينا وعالمنا، علينا أولاً أن نحرِّر أنفسنا وأن نكون أحراراً مِن ذواتنا ومطامحنا ومطامعنا! ولكن كيف يبلغ الإنسان إلى الحريّة الحقيقيّة؟! في الواقع، لا أملك خطة أو برنامجاً أو نظريّة ليحصل كلُّ إنسان على حريته، وحتى إنْ امتلكتهم يوماً، لن أجد السبيل والوسيلة لتحقيقهم. ولكنني أود هنا أن أقترح أمراً يقدر عليه كل إنسان، مهما كان عمره وجنسه وجنسيته ودينه ومستواه الاجتماعي وإلى آخره مِن تصنيفات. إن الأمر الذي أقترحه هو أن يبدأ كل إنسان في تحرير نفسه، أو بالأحرى أن يبدأ في استرداد حريته المفقودة؛ فكل إنسان منذ نشأته يحمل في داخله الحرية كإمكانية، فلا أحد خُلق عبداً. ولكن يحدث أن كل إنسان يختار إمَّا أن يعيش ليحقق حريته الموجود بداخله، وإما ليفقدها بالتدريج على مر حياته! لذلك سأظل أصرخ في ضمير كل إنسان حتى يسترد حريته التي هي بداخله، والتي هي طبيعته؛ فالإنسان خُلق حراً ليعيش حراً، لا ليموت عبداً!
لقد ولدتُ إنساناً يحمل بداخله الحرية كإمكانية! ولكن أحداث حياتي وقراراتي المصيرية واختياراتي اليومية جعلتني أغفل حريتي وأعيش كما وإن كنت عبداً. لقد أرسلت حريتي في نعاس طويل ونوم عميق عندما بدأت أحيا بشكل أنانيتي، منغلقاً في نرجسيتي وقَصري الذي بنيته برغباتي الشريرة وزينته بمطامعي الظالمة المظلمة. كنتُ أتمادي يوماً فيوماً في عبوديتي ظناً أنني أعيش حراً. لقد كنت أعتقد أن الحرية هي أن أرفع نفسي فوق الآخرين، جعلاً منهم عبيداً لي. إن هذا يذكرنني-ولو من بعيد- بـ”جدلية العبد والسيد” لهيجل: حيث يأمر السيدُ العبدَ بأن يعمل ويكد لأجله، وكان يظن أنه سيداً لأنه يملك عبداً؛ ولكن الحقيقة هي أن مَن كان يعتبره عبداً كان هو السيد الحقيقي، فهو الشخص الحر الذي بدأ يعمل ويصلح في الأرض ويسعى لتعميرها، فبحريته بدأ في إعادة جمالها؛ أما السيد فهو الذي كان عبداً لأنه لم يكن ممكناً له أن يحيا إلا بفضل العمل الذي كان يقوم به العبد الحر!!
إن الحرية الحقيقة تنبع من الداخل، فمن يريد الحرية عليه أن يكتشفها في داخله، ولا يبحث عنها خارجاً، ظناً بأنه بقدر ما يملك ويحكم سيكون حراً وسيداً؛ فكم مِن ملوك وأمراء وحكام كانوا عبيداً! لقد قال يسوع المسيح يوماً: «تعرفون الحقَّ، والحقُّ يُحرِّركم […] فإذا حرَّركم الابنُ كنتم أحراراً حقاً» (يو 8/32، 36)! وقد اكتشفت هذه الحقيقة يوماً مِن الأيام، ومنذ لحظتها وأنا أجاهد كل يوم حتى أحقق أكثر فأكثر حريتي وحرية الآخرين. وينبغي علىَّ أن أعترف أن هذه القفزة، أعني قفزة اكتشاف حريتي، لم أكن قادراً على إتمامها بدون عون الآخرين وبدون عون الأخر الأكبر.
إن الله، الأخر الأكبر، هو المحرِّر الأول والأخير للإنسان الذي يسعى لاكتشاف ولاستعادة حريته المفقودة؛ والآخرين هم مَن يساعدنني في أن أحقق ذاتي وحريتي! يمكننا في الواقع أن نقول بحقٍ أن الإنسان بدون الله خالقه هو كائن محكوم عليه بالشقاء والتعاسة والموت الأبدي، لأنه سيحيا في نرجسيته وأنانيته، وبذلك سيظل فاقداً لحريته الموجودة كإمكانية في داخله.
إنَّ الإنسان- كل إنسان وأي إنسان وكل الإنسان- خُلق حراً ويحمل في داخله الحرية، ولكنه يحتاج إلى مَن يوقظ حريته. إن الله الخالق هو مَن يضرم قلب الإنسان ليبحث عن حريته المفقودة الكامنة في داخله. فهو يريده كائناً حراً بين جميع خلائقه ومحاوراً حراً له؛ لذلك ينتظر بشوقٍ وتلهفٍ اليوم الذي فيه يكتشف الإنسان حريته (لو 15/11-32)؛ وليس هذا فحسب، بل ينتظر أيضاً اليوم الذي فيه يشارك في حرية الثالوث ذاتها (يو 14/1-3)! فكذبوا مَن قالوا أنَّ وجود الله يلغي حرية الإنسان؛ فإن الله لا يُحرم الإنسان مِن أي شيء خير وحق وجميل، وإنما يريد أن يرشده إلى الطريق الحقيقي الذي يبلغ به إلى الحرية الكاملة، الحرية المتحررة المحررة. إن طريق حصول الإنسان على حريته هو الطريق الذي علَّمه الله ذاته للإنسان، فهو الطريق الذي مرَّ به الله نفسه، جاعلاً مِن ذاته مثالاً وقدوة، وليس هذا فحسب، وإنما معضداً وشفيعاً أيضاً للإنسان في سعيه للحرية.
إنَّ الطريق الذي اختاره الله هو طريق يسوع المسيح، اللوغوس المتجسد، أي الطريق المملوء بالأحجار والأشواك والصلبان، ولكنه المؤدي إلى الحرية والسعادة والقيامة والحياة الأبدية؛ إنه باختصار “طريق الجلجثة”! لقد قال يسوع المسيح عندما كان مقيماً هنا على الأرض وكان يبلغ مِن العمر أكثر مِن ثلاثين عاماً: «الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إنَّ حبة الحنطة التي تقع في الأرض إنْ لم تَمُت تبقى وحدها. وإذا ماتت، أخرجت ثمراً كثيراً. مَن أحبّ حياته فقدها ومَن رغب عنها في هذا العالم حفظها للحياة الأبدية» (يو 12/24-25). ويقول أيضاً في موضع أخر: «مَن أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. لأن الذي يريد أن يُخلِّص حياته يفقدها. وأمَّا الذي يفقد حياته في سبيلي فإنه يُخلِّصها.
فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله، وفقد نفسه وخسرها؟» (لو 10/23-25). لقد شرح بكلماته العذبة هذه أنه ليس ثْمَّة طريقٌ للبلوغ إلى الحرية إلا طريق “عطاء الذات”، أعني طريق المحبة وليست الأنانية والنرجسية. وكأنه بهذه الكلمات أراد أن يقول: مَن يريد أنْ يصير حراً عليه أنْ يُحب حتى عطاء الذات. هذه هي “الحقيقة” التي تحرر حقاً، أعني “حقيقة المحبة”. لقد قال يسوع بحقٍ: «تعرفون الحق، والحق يحرِّركم» (يو 8/32)؛ وما هو الحق غير المحبة؟! ومَن هو المحبة غير “شخص يسوع المسيح” ذاته؟ فبعد أنْ علَّمنا بكلماته الصادقة طريق البلوغ إلى الحرية، قام هو بذاته بالعبور في هذا الطريق المكتظ بالأحجار والأشواك والصلبان، وليس هذا فقط، بل المملوء أيضاً بالإهانات والإنكار والجحود؛ ولكن هذا الطريق ليس هكذا محزناً كئيباً لأنه في النهاية يؤدي إلى القيامة والحياة. فطريق الصليب المحمول مِن أجل محبة الآخرين، هو الطريق المؤدي بلا شك إلى القيامة والحياة الأبدية. إن طريق عطاء الذات مِن أجل الآخرين هو طريق البلوغ إلى الحرية. فليس ثَمَّة حرية لمن يرفض أن يصبح حراً، ولا طريق للبلوغ إلى الحرية غير عطاء الذات بمحبة!! ليس فقط الأخر الأكبر، أي الله، الذي مِن خلال عون ابنه يسوع المسيح وعون روحه القدس، يجعلني أكتشف حريتي أكثر فأكثر وأعيشها يومياً؛ وإنما أيضاً الآخرين الذي يحيطون بي، أو بكلمات أفضل الله مِن خلال عون الآخرين. فإنَّ «الله لم يخلق الإنسان وحيداً، بل إنه منذ البداية “خلقهما ذكراً وأنثى” (تك1/27). وهذا الاتحاد بين الرجل والمرأة هو أوّل وجه من وجوه المشاركة بين الأشخاص.
ذلك لأن الإنسان في صميم طبيعته كائن اجتماعيّ، وما لم يقم علاقات مع الغير فإنه لن يستطيع أن يعيش ولا أن تزدهر مواهبه»[1]. لقد عشتُ مخدوعاً _كما لا يزال يعيش الكثيرون الآن_ باعتقادي أنَّ حريتي تكمن في أن أصنع مِن الآخرين عبيداً لي، أو على أقله أدوات مِن أجل راحتي وحريتي! لقد كنت حقاً مخدوعاً لزمن طويل بعبارات وشعارات مزيفة كتلك التي قالها نيتشه وسارتر _ على سبيل المثال لا الحصر_ ؛ لقد كانا يظنان أنه مِن خلال الزعم بـ”موت الله” و التخلص من “جحيم الأخر” يمكنهما أن يحصلا على الحرية الكاملة! يالتعاسة الإنسان الذي لا يزال يعتقد أن حريته تكمن في إنكار الله ومحو الآخرين، فحضور الله وحضور الآخرين، لا إنكارهما، هما مَن يجعلنه يبلغ حقاً إلى حريته الكاملة الحقيقة!! يعيش الكثيرون ظانين أنَّ حريتهم تنمو وتزدهر عندما يصنعون مِن الآخرين عبيداً، وعندما يبنون لهم سجوناً وأسواراً عالية ويضعونهم فيها، أو على الأقل عندما يُضعفون مِن قوة وغنى الآخرين! إنَّمَّا الحقيقة هي: إن الإنسان الذي يحبس الأخر في سجون وبين أسوار يحبس معه أيضاً حريته الشخصية! كلنا يتذكر جيداً قصة “شمشون ودليلة” (قض 16/4-22)، لقد ظنت دليلة الجميلة بأنها مِن خلال خيانتها لعشيقها شمشون، ومِن خلال اكتشافها لسر قوته، وبالتالي مِن خلال تحويله إلى إنسان ضعيف، ستحصل هي على أموال كثيرة ومراكز عالية، وبالتالي على حرية تفوق الخيال! ولكن الحقيقة المرة هي أنه في ذات اليوم الذي فقد فيه شمشون بصره وقوته، هو اليوم عينه الذي فقدت فيه دليلة معهما جمالها وحريتها! لأنها استغلت جمالها في إشباع لذاتها ومطامعها الرديئة! إنني أظن أن قلبها ظل يؤخزها ويعذبها طوال حياتها؛ وإنني أتخيله يقول لها هذه الكلمات: “دليلة، ماذا صنعت بالإنسان الذي أحبك حتى الجنون، فبرهان حبه لكِ هو أنه باح لكِ بأسرار قلبه المصيرية؟!
وماذا صنعت بي أنا قلبك المسكين؟! لقد كنت أحب شمشون حباً فاق الخيال، فهو الإنسان الذي جعلني أشعر بالعواطف والحب الذي طالما بحثت عنهما طويلاً في قصور الملوك والأمراء وبين أحضان الأغنياء! أتظنين أنك الآن حرة ويمكنك أن تعيشي سعيدة مطمئنة؟! إنه خداع، يا عزيزتي دليلة! إن الحرية لا تكمن في المال والقصور المزينة، إنما تسكن في القلب الذي يسكنه الحب الحقيقي، الذي يحب حتى عطاء الذات، حتى الموت مِن أجل مَن يحب”!! أجل إن الحرية لا تسكن في قلبٍ كارهٍ ورافضٍ للآخرين، إنما في قلب محب ومنفتح على الآخرين! إن حريتي متعلقة بشكل لا يقبل الانفصال أو الفصل بحرية وكرامة الآخرين؛ فكلما تركت للأخر مجالاً في قلبي حتى يدخل ويسكن فيه، كلما حصلت أنا أكثر فأكثر على حريتي؛ أجل، إنها جدلية، “جدلية حريتي وحرية الآخرين”. فإنَّ الآخرين، شئنا أم أبينا، هم مَن يساعدونا في اكتشاف حريتنا والبلوغ إليها! إن حياتنا اليومية منذ نشأتنا تعتمد اعتماداً دائماً على الآخرين، ولكن اعتمادنا على الآخرين المقصود هنا ليس هو الاعتماد على أدوات ووسائل نستغلها في نمونا ونضوجاً؛ فحديثنا هنا يتمحَّور حول “مقابلة بين أشخاص” وحول “حوار بين حريات حقيقية”! فبقدر ما أساعد الآخرين على أن يعيشون حريتهم وبقدر ما أقدم لهم حياتي عطية سخية بمحبة، كلما اكتشفت وعشتُ حريتي أكثر فأكثر أنا أيضاً. إن البلوغ إلى حريتي هو مسيرة مشتركة بيني وبين الآخرين، فكلما سمحتُ للأشخاص الآخرين بالدخول في حياتي، كلما أصبحتُ أنا أيضاً شخصاً حراً، يزداد في حريته كل يومٍ! إنَّ الحريّة التي أتحدَّث عنها هنا هي الحرية التي تنبع مِن “حياة الشركة والمشاركة”!
فمن يعيش وحيداً منعزلاً ورافضاً للأخر سيظل أبداً عبداً لنرجسيته ولأنانيته، وبالتالي سيعيش أبداً في تعاسته وشقاءه، ولن ينعم أبداً بالراحة ولا يذوق أبداً مذاق السعادة؛ لأن «الإنسان، وهو الخليقة الوحيدة التي أرادها الله لذاتها على وجه الأرض، لا يستطيع أن يحقّق نفسه كاملاً إلاَّ بالعطاء المتجرّد عن حبّ الذات [الأنانيّ]»[2]! فمَن يرغب إذاً في البلوغ إلى الحرية، عليه أنْ يسلك طريق “عطاء الذات” أو بتعبير أخر طريق “حياة الشركة والمشاركة” مع الآخرين؛ فالآخرين هم من يساعدونني في أنْ أعيش حراً، وبالتالي في أنْ أعيش سعيداً؛ فالسعادة تنبع مِن الحرية، والحرية هي عطيةٌ وثمرةٌ لحضور الله والآخرين في حياتي!
—————————————-
[1] وثائق المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ المسكونيّ، المكتبة الكاثوليكيّة، السكاكيني، القاهرة، 2000، دستور راعويّ “الكنيسة في العالم المعاصر”، بند 12، 55. [2] المرجع السابق، بند 24، 66.