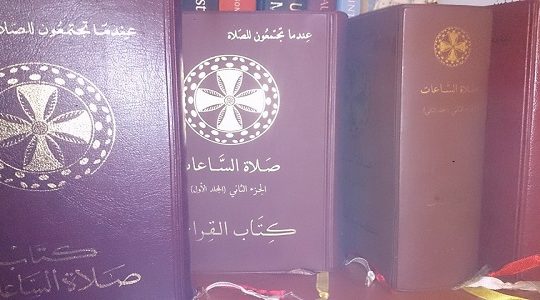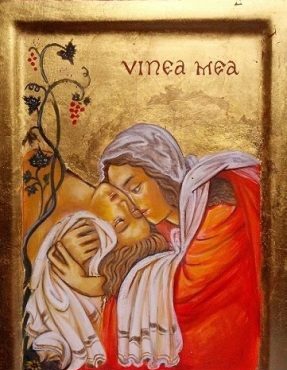الطبيعةُ المجروحة / أعده أشرف ناجح

 الطبيعةُ المجروحة / أعده أشرف ناجح
الطبيعةُ المجروحة / أعده أشرف ناجح
لقد وقفتُ مِراراً عديدة أمام نفسي، وقد طرحتُ عليها تساؤلات كثيرة ومتنوعة مرة ومرات: مَن أنا؟ وماذا يوجد بداخلي؟ ولماذا أعيش في مثل هذه الحالة؟! فبداخلي توجد أرادة ملحة تدفعني نحو خدمة جميع الناس، فأريد أن أخدمهم جميعاً، أريد أن أعاملهم جميعاً بشكل حسن مهذب، أريد أن أعطيهم جميعاً مما أملك سواء أكان وقتاً أو مالاً أو جسداً؛ أريد أن أعيش كل أيام حياتي في سلام وحب ومصالحة… أريد وأريد!! ولكنني لا أقوى على فعل شيء! فلماذا أشعر وكأن إرادتي مقيدة؟ فالخير الذي أريد فعله لا أستطيع إنجازه؛ فالإرادة موجودة فيّ، ولكنها لا تستطيع إنجاز شيئاً! «فالذي أريده لا أفعله، وأمَّا الذي أكرهه فإيَّاه أفعل. […] لأنَّ الخير الذي أريده لا أفعله، والشَّر الذي لا أريده إيَّاه أفعل. […] ما أشقاني مِن إنسان! فمَن ينقذني مِن هذا الجسد الذي مصيره الموت؟» (روم 7/ 15، 19، 24)!!
ذهبتُ في مسيرة بحث طويلة، رحتُ أبحث فيها عن إجابات لتساؤلاتي وشفاء للوعتي؛ مضيتُ أبحث بالتحديد عن ردٍّ شافٍ للتساؤل الذي طرحته مِراراً عديدة: فمِن جهةٍ، لماذا توجد بداخلي تلك الرغبة إلى فعل الخير؟ ومِن جهةٍ أخرى، لماذا برغم وجودها لا أقوى على إنجاز الخير الذي أريده؟! ولم يكن الهدف الجوهري مِن القيام بهذا البحث الشاق هو الوصول إلى رد نموذجيّ فلسفيّاً ولاهوتيّاً، أو إلى ردٍّ نظريّ وكأن التساؤل خارجاً عن كياني؛ ولكنني بحثت أول ما بحثت عن إجابة تروي عطشي وتخلق فيَّ إنساناً جديداً! فبدأتْ مسيرتي المؤلمة الصعبة، عندما قابلتُ ذات مرة بعضاً مِن العارفين والفهماء؛ فطرحتُ عليهم تساؤلي المحيِّر؛ فأخذ واحد منهم الكلمة وقال لي: اسمع يا ولدي، أنتَ بحاجة إلى تمارين وتدريبات ذهنيّة وباطنيّة، حتى تستطيع أنْ تضع إرادتك ومشاعرك تحت قيادة عقلك، وأنْ تضع جسدك تحت سيطرة نفسك، فعندها لن تفعل إلا ما يقوله عقلك وما ترغبه نفسك!! لقد أعجبتني بحقٍ هذه الإجابة؛ فبدأتُ فعلاً مرحلة جديدة مِن عمري.
وقد قمتُ بممارسة تمارين وتدريبات قاسيّة، ورحتُ أجاهد ضد نفسي بعنفٍ. وكنتُ أمارس هذه التقشفات باستمرار برغم صعوبتها وقسوتها، فكم كانتْ قاسية حقاً هذه التمارين؟! ولقد نجحتُ في الواقع في تحقيق تقدماً ملحوظاً. ولكن بعد فترة مِن الزمن، بدأتُ بعمل تقييم ومراجعة لما تَغيَّر في حياتي؟! ولحظتها اكتشفتُ أموراً كثيرة: فقد صدمتني مِن جديدة هذه الهوة التي كانتْ لا تزال قائمة بين عقلي وإرادتي وقلبي؛ فقد كانتْ هوة وصراع قاس في آنٍ واحدٍ، فكل ما يفكر فيه عقلي لا ترغب فيه إرادتي، وكل ما أنجزه بإرادتي يشككني فيه عقلي! وبعد هذا التقييم الذي دام لساعاتٍ، شعرتُ بأنني لم أتقدَّم كثيراً، لا وبل بالعكس قد تألمتُ كثيراً مِن جراء التدريبات والممارسات التقشفيّة. ولذلك تركتْ هذه الوسيلة وأبعدتها عني تماماً، لأنها ليس فقط لم تجدي نفعاً، بل تركتني أيضاً في صحبة الآلام والأحزان.
مرتْ أيام وأيام، كنتْ أعاني فيها مِن التمزَّق والصراع المريرين. وأخيراً قابلتُ جماعة، هم في الحقيقة “جماعة” بكل ما في الكلمة مِن معنى، فقال لي واحد منهم: إننا يا بني، نؤمن كما آمن آباؤنا، فنحن نؤمن بأنَّ الإنسان مخلوق على “صورة الله ومثاله” (تك 1/27؛ 5/1-2). فقاطعته متسائلاً: ماذا تقصد يا سيدي، أكاد لا أفهم شيئاً؟! فأجابني مبتسماً: أقصد يا ولدي، أنَّ الإنسان الأول الذي خلقه الله كان حسناً جداً، وكانت طبيعته حسنة وجيدة وطيبة ولا تعرف شراً؛ وهذه الطبيعة الخيرة كانت تقوم بعمل الخير بسهولة وبدون تعب وكفاح، أى أنها كانت تسلك بحسب الطبيعة الحسنة المخلوقة مِن الله تعالى. وعندها سألته حزيناً: وماذا حدث لهذا الإنسان؟ أين هو الآن؟! ولماذا يصعب عليّ كإنسان أنْ أفعل الخير الذي أريده؟ فأريد حقاً أن أفعل الخير ولكنني لا أستطيع، وإنْ أنجزته مرة لا أقوى على إتمامه وإعادة تكراره مرات أخرى!
فوضع يده على كتفي وقال حزيناً وقد تغيَّرت ملامحه: أشفق عليك يا ولدي، فواضح أنك في صراع عنيف، وهو صراع ليس مع أحد خارج عنك، إنما مع طبيعتك المجروحة المنقسمة! ثم أردف قائلاً: إنَّ هذا الصراع القائم بداخلك لم يكن موجوداً في الإنسان الأول الذي يُدعي “آدم وحواء” (تك 2/7؛ 3/20)، فبالرغم مِن أنه كان يملك حقاً الحرية الكاملة المعطاة له مِن لدن الله، ولكنه كان في نفس الوقت يملك أيضاً طبيعة حسنة؛ فكانت هذه الطبيعة الحسنة تُحقِّق ذاتها الحسنة في عمل الإرادة الحسنة. فتسألتُ متشوقاً وحزيناً في نفس الوقت: ولكن ما الذي حدث لهذا الإنسان الأول، يا معلمي؟ ولماذا لا يوجد بعدُ؟! وعندما سمع هذا السؤال، أجابني في لحظتها: لقد أدَّ به الحال لما أنت عليه وما تعيشه الآن، يا بني! فقد «خلق الله الإنسان في حالة براءة. لكن الشرير استهواه منذ بدء الزمن فأساء استعمال حرِّيَّته وتطاول على اللّه، ساعياً إلى بلوغ غايته بعيداً عنه»[1].
وبذلك حرم نفسه مِن “حالة البراءة الأصليَّة والنعمة الأولى”؛ فقد راضي وسمح بحريته الكاملة أنْ تنقسم وتُجرح طبيعته الأصليّة وأنْ تتشوَّه صورة الله فيه، وإنْ كانت لم تُمحى منه ولم تخرب تماماً. لقد قرَّر أنْ يكون هو الأصل والمرجع والغاية لذاته ولحياته، فقد فضَّل أنْ يكون هو ذاته “الشريعة” لذاته ولحياته، وبذلك رفض حبَّ الله الخالق المقدَّم له لكي يقيم ويحيا فيه إلى الأبد؛ لقد بحث عن مكانة مرتفعة بعيداً عن إلهه المحبِّ وخالقه العظيم، فكانتْ هذه هي “الخطيئة الأولى”، أعنى “خطيئة الإنسان الأول”! وعندئذٍ، ابتسمتُ متهرباً: وما ذنبي أنا في ذلك؟ لقد أخطأ هو فليُحاسب هو وحده! فأجابني هذا الشيخ الحكيم: إنَّ الإنسان الأول سيحاسب بلا شك وحده على “خطيئته”، والتي تُسمَّى بالضبط “الخطيئة الأولى”، وهي التي ارتكبها الإنسان الأول في لحظةٍ ما مِن الزمن؛ أمَّا نحن يا ولدي، فقد لصق بنا ما يُسمَّى بـ “الخطيئة الأصليّة”، والتي تعني ببساطةٍ وبدون تعقيدٍ “نزوع الإنسان نحو الابتعاد عن الله”، أو بكلمات أخرى “حالة الإنسان بدون خلاص المسيح”، أى “حالة غياب النعمة الأصليّة والحرمان منها”؛ ولذلك فإنَّ طبيعتنا أصبحتْ مجروحة ومنقسمة وعاجزة وحدها عن البلوغ إلى الكمال المرجوه؛ فتلك الوحدة الباطنية التامة التي تنعَّم بها الإنسان الأول قد تحطَّمتْ وتشوَّهتْ وجُرحتْ بسبب الخطيئة. ونحن جميعاً نشارك الإنسان الأول في خطيئته هذه، لأننا ولدنا في هذا العالم الملوث بالخطيئة، ولأنَّ “آدم” كان بمثابة الإنسان كإنسانٍ، أي أنَّه يُمثِّل كلَّ الجماعة البشريّة: «فإنَّ الخطيئة دخلت في العالم عن يد إنسان واحد، وبالخطيئة دخل الموت، وهكذا سرى الموت إلى جميع الناس لأنهم جميعاً خطئوا» (روم 5/12)؛ ولأنَّ خبراتنا الواقعيّة واختياراتنا اليوميّة ومسئوليتنا الحرَّة أيضاً تؤكِّد لنا حال الانقسام والجرح والنقص والعجز عن أنْ البلوغ إلى الغايات المرجوة. وكلُُّ هذا يعني أنَّ الخطيئة الأصليّة التي هي “حالة عدم الكمال وغياب النعمة”، والتي نتج عنها الطبيعة المجروحة المنقسمة والجو الملوث بالأنانيّة، تخصنا جميعاً؛ فكلُّ إنسان يُوجد في هذا العالم تنال منه كل هذه الأمور؛ فهنا يصدق قول مَن سبقونا: «فإنه ليس أحد طاهراً مِن دنس ولو كانت حياته يوماً واحداً على الأرض»[2].
«ومن ثَمَّ فالإنسان منقسم على نفسه، وها هي ذي حياة البشر، أفراداً وجماعات، تبدو أشبه بالصراع _و آسفاه_ بين الخير والشرّ والنور والظلمة. والأكثر من ذلك أن يكتشف الإنسان أنه يعجز وحده عن التغلب فعلاً على هجمات الشرّ»[3].
وأخيراً، لا تنسْ أيضاً يا بني، ما يُسمَّى بـ “الخطيئة الجماعيّة” التي تلعب دوراً هاماً في هذا المجال، أي اشتركنا جميعاً في الخطيئة، فالإنسان الذي يرتكب الخطيئة يتسبَّب في تلويث عالمنا بالخطيئة القاتلة، كما أنه على العكس الإنسان الذي يسعى إلى تقديس ذاته يساهم في تقديس العالم كله، أي إننا مشتركين جميعاً في مسيرة الانحدار نحو الخطيئة كاشتراكنا جميعاً في مسيرة الصعود نحو القداسة والكمال. لقد قال الكتاب المقدس بحقٍ: «فكما أنَّ زلَّة إنسان واحد أفضت بجميع الناس إلى الإدانة، فكذلك برُّ إنسان واحد يأتي جميع الناس بالتبرير الذي يهب الحياة. فكما أنه بمعصية إنسان واحد جُعلت جماعة الناس خاطئة، فكذلك بطاعة واحد تُجعل جماعة الناس بارة» (روم 5/18-19)[4] !
عندما سمعتُ هذا الحديث، وضعتُ يداي على رأسي وشعرتُ بأنَّه لا مفر مِن هذه الطبيعة المجروحة المنقسمة، فأحسستُ وكأنَّه قد حُكِم عليَّ بالموت الأبديّ. فلاحظ الشيخ الوقور حيرتي، فظهرتْ على وجهه ابتسامة شفافة، وهتف في وجهي قائلاً: لا تخف ولا تبك يا بني، فهناك حل لشقائنا؛ إنَّ الله بتدبيره الأزلي وحبه الإلهي لم يشأ أنْ يستمر الإنسان في السير نحو الموت الأبدي والابتعاد عن حضنه الحنون، فأعطانا بعنايته الإلهية ابنه “الوحيد الجنس” (يو 1/18)، فأخذ نفس طبيعتنا البشريّة كاملة بدون أنْ تمسه ذرة مِن الخطيئة (عب 4/15)، فالمسيح إنسان كامل في إنسانيته وإله كامل في إلوهيته، أي أنه ذو طبيعتين (إنسانيّة/ إلهيّة) بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغير ولا انفصال. فنحن نؤمن حقاً «أن لاهوته لم يفارق ناسوتَه لحظةً واحدةً ولا طرفةَ عينٍ»[5].
ومِن جهة أخرى، لا تظنْ أنََّ الخطيئة هي التي حرَّكت الله مِن عرشه الإلهي وجعلته يرسل ابنه الحبيب للعالم، إنما كانتْ محبته الأزليّة الفيَّاضة وتدبيره الإلهيّ الحكيم الدافعان لكلِّ هذا؛ فالله في تدبيره السرمدي أراد أنْ يُوحي بنفسه للإنسان منذ بداية التاريخ البشري، لا وبل فعل “الخلق” نفسه هو بمثابة وحياً إلهياً أوليّاً قدَّمه الله للإنسان، فالله ذاته عندما خلق الإنسان الأول خرج حقاً مِن صمته! وليس هذا فحسب، بل وقد أراد الله منذ البداية أنْ يكون الإنسان شريكاً له في طبيعته الإلهية[6]! «إن الأب الأزليّ خلق الكون بتدبير حرّ مطلق وسرّي صادر عن حكمته وجوده، وأراد أن يرفع البشر إلى حدّ إشراكهم في حياته الإلهيّة، ولم يتركهم عندما زلّوا في آدم، بل ظلّ يمنحهم دائماً عوناً للخلاص، نظراً للمسيح الفادي “صورة الله الذي لا يُرى وبكر الخلائق كلّها” (كولوسي 1:15)»[7]!
ولكن الإنسان بحريته الكاملة أراد أنْ يصل إلى الكمال مِن خلاله قدرته الذاتيّة المحدودة ومجهوده البشريّ الممتلئ بالغطرسة والأنانيّة، أي أنه رفض أنْ يقبل وحي الله والحياة الأبدية كعطية مجانية مِن لدن الله المحبِّ؛ لقد رفض أنْ يستمر في فردوس الله وفي حضرة قداسته. فعدتُ أسأله متعجباً ومتحيراً: وما الذي قدَّمه يا تُرى المسيح هذا للإنسان؟! فأجاب: اسمع يا ولدي، «ليست الهبة كمثل الزَّلَّة: فإذا كانت جماعة الناس قد ماتت بزلَّة إنسان واحد، فبالأولى أن تفيض على جماعة الناس نعمة الله والعطاء الممنوح بنعمة إنسان واحد، ألا وهو يسوع المسيح. […] حتى إنه كما سادت الخطيئة للموت، فكذلك تسود النعمة بالبرِّ في سبيل الحياة الأبديّة بيسوع المسيح ربِّنا» (روم 5/15، 21)!
لقد وُلد يسوع المسيح وعاش وتعلَّم وعلَّم وعمل ومات وقام وصعد إلى السموات، وقد أظهر في كلِّ هذا أنه الإنسان الجديد الحقيقي الكامل المتحِّد بالإله الكامل إتحاداً أبديّاً بدون ذرة انفصال؛ وهذا المسيح الكامل بحبه الكامل أعاد إلى الإنسان الكمال المفقود، أي صالحه مع الله وأعاده إلى الوحدة مع إلهه المحبِّ؛ وبالتالي أعطى للإنسان إمكانية الشفاء مِن جرح الانقسام الذي بداخل طبيعته. إننا نطلق بحقٍ على المسيح لقب «حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم» (يو 1/19)، فهو وحده مَن استطاع أنْ يُحرِّر الإنسان مِن الخطيئة الأصليّة، أعني “مِن حالة الحرمان والعجز عن الوصول إلى الكامل”، وبالتالي مِن الطبيعة المجروحة المنقسمة، ويُعيده إلى الحياة الحقيقية الأبدية مع الله معطي الحياة. وبكلمات أخري، «إن السيّد المسيح بوصفه “صورة اللّه غير المنظور” (كولوسي 1: 15) هو الإنسان الكامل الذي أعاد لذرية آدم الشبه الإلهيّ غير المشوّه بالخطيئة الأولى. ولما كان السيّد المسيح قد حمل طبيعة الإنسان بدون أن تتلاشى فيه، فقد ارتفعت بذلك الطبيعة الإنسانيّة فينا إلى كرامة لا تعادلها كرامة، فكأن ابن الله بتجسّده إنما اتّحد هو نفسه بكلّ إنسان منا. لقد استخدم يدين بشريّتين وفكّر بعقل إنسانيّ وتصّرف بإرادة بشريّة وأحب بقلب بشريّ.
إنه بولادته مِن العذراء مريم أصبح في الحقيقة واحداً منّا وشبيهاً بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة»[8]. وبكلماتٍ مُختصرة، إنَّ العمل الذي قام به الآب في المسيح بالروح القدس له بعدان جوهريان: الأول، “بُعد شفائيّ”، أي أنه حرَّرنا مِن داء الخطيئة وسلطانها (أف 1/7؛ يو 8/34-36؛ قول 1/14؛ 1يو 2/1-2)؛ والثانيّ مُكمِّل للأول، “بُعد إرتقائيّ”، أي أنه رفعنا إلى منزلة رفيعة جداً، منزلة أبناء الله بالتبني، فأصبحنا أبناء في الابن (يو 1/12-13؛ 1يو 3/1-2؛ روم 8/14-17)، وقد جعلنا نلبس الإنسان الجديد بدلاً مِن الإنسان القديم الذي تفسده الشهوات الخادعة (أف 4/20-24)، وقد نقلنا أيضاً إلى ميراث النور وإلى ملكوت ابن محبته (قول 1/12-13)، وقد أصبحنا أيضاً في النور وتحت سلطان الله الذي أعد لنا ميراثاً أبديّاً لا يُفسد ومحفوظ لنا في السَّموات (رسل 26/18؛ 1بط 1/4). وبعبارةٍ واحدةٍ مُوجزة: «الله الواسع الرَّحمة، لحبه الشَّديد الذي أحبَّنا به، مع أننا كُنَّا أمواتاً بزلاتنا، أحيانا مع المسيح (بالنَّعمة نلتم الخلاص) وأقامنا معه وأجلسنا معه في السَّموات في المسيح يسوع» (أف 2/4-5).
ولذلك فنحن أمامنا مسيرة، أعدها المسيح ذاته، يجب أنْ نسلكها حتى نصل إلى “التألِّه”، أي حتى نصير «شُركاء الطبيعة الإلهيَّة» (2بط 1/4). فيسوع المسيح إذا هو “وحي الله الحقيقي والكامل والنهائيّ”؛ ولذلك فهو «النور الحق الذي ينير كلَّ إنسان» (يو 1/9). والخلاصة لحديثي هذا، يا بني، هي: «الله، غير المنظور، جعل نفسه منظوراً، وكشف عن نفسه للبشر في كلمته المتجسدة [يسوع المسيح]، الذي بدوره أخذ الطبيعة البشريّة التي قدَّسها وحوَّلها»[9]؛ ولقد صار إنساناً فأصبح للناس أخاً حبيباً وحبراً رحيماً. ولذلك فكلُّ مَن يريد أنْ يتحرَّر مِن الخطيئة الأصليّة ومِن حالة الطبيعة المجروحة المنقسمة مِن ناحية، وأنْ ينال ويتمتع بالعمل الذي أتمَّه يسوع المسيح بميلاده وحياته وأقواله وموته وقيامته مِن ناحية أخرى، ينبغي عليه أنْ يقبل ويؤمن بحريةٍ كاملةٍ بالشخص الذي جعله الله «الطريق والحقّ والحياة» (يو 14/6)، أعنى أنْ يقبل ويؤمن بشخص يسوع المسيح ورسالته الخلاصيّة! لقد كنتُ أتابع حديثه الجذاب متعطشاً إلى الاكتشاف الذي طالما سعيتُ إليه طوال أيام حياتي الماضيّة ولياليّ القاحلة؛ فقد كانت كلماته، رغم بساطتها، بمثابة دواء شاف لمرضي الأليم وماء عذب لعطشي الشديد، فقد دخلت عمق أعماقي.
وبعد هذا اللقاء الثمين الذي لن أنساه مهما حيتُ، مرت أيام قليلة كنت أفكر فيها في كل كلمة سمعتها مِن فم هذا الشيخ الجليل التقي؛ وبعدها بدأت أشعر بأنني ما عدتُ أفكر بالطريقة التي كنت أفكر بها قبلاً، بل وشعرت وكأن عقلي قد قفز قفزة كبيرة ليصل إلى علو وعمق عظيمين لم يكن يقوى أو يحلم بالوصول إليهما بقوته الذاتية و بتمارينه التقشفية. لقد تذكَّرت أيضاً أنني قد نسيتُ وابتعدتُ عن النعمة التي نلتها بالمعموديَّة المقدسة (1بط 3/ 20-21) عندما كنت طفلاً صغيراً؛ فاكتشفتُ عدم تقديري لمثل هذه العطية السمائية التي هي بمثابة “بداية الطريق”، وهي تحتاج دائماً إلى مسيرةٍ وجهادٍ مبنيين على عمل هذه النعمة وعمل الروح القدس الذي يسكن فيّ.
لقد أدركتُ وأمنتُ أنَّ الإنسان والإله يسوع المسيح ليس مجرد فكرة أو نظريّة، إنما هو بالحقيقة شخص حي مُحيي؛ فقبلته مرة أخرى وسمحتُ له مِن جديد أنْ يُكمل عمله في إعادة توحيد طبيعتي المجروحة المنقسمة. ويمكنني أنْ أعترف بصدقٍ أنني رأيته وتحدَّثته إليه، فهو بالحقيقة أعظم اكتشاف في حياتي، لأنني فيه ومعه وبواسطته ولأجله يمكنني أنْ أسعى نحو الكمال الحقيقيّ الذي يجد في الله أصله ومرجعه وغايته. وسأنتظر تحقيق واكتمال إنسانيتي ومشاركتي في الطبيعة الإلهيّة بشكلٍ كاملٍ عندما يأتي مُشرقاً مِن السماء مرة أخرى (رسل 1/11) مَن ذهب ليُعِّد لنا مقاماً في بيت أبيه (يو 14/2-3)! أخيراً، أودُّ أنْ أقول شيئاً يُلخِّص كلَّ ما قِيل سابقاً: لم ولا ولن يستطع الإنسان المنقسم والمجروح مِن الخطيئة الأصليّة أنْ يصل إلى حبٍّ دائمٍ وشاملٍ لجميع الناس بمجرد قيامه ببعض التمارين والممارسات الروحيّة؛ ولكنه يستطيع ذلك عندما يسمح لحب الآب أنْ يشمله ونعمة المسيح ابنه ترفعه ومعونة الروح القدس تعضده، فيسمح لله أنْ يُحبَّ مِن خلاله كلَّ إنسانٍ وأيّ إنسانٍ.
——————————————
[1] وثائق المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ المسكونيّ، المكتبة الكاثوليكيّة بالسكاكيني، القاهرة، 2000، دستور راعويّ “الكنيسة في العالم المعاصر”، بند 13، 56.
[2] الخولاجي المقدس وخدمة الشماس، إعداد القمص إيسيذوروس البراموسي، مكتبة مارجرجس، شبرا، مصر، 1994، 75.
[3] وثائق المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ المسكونيّ، دستور راعويّ “الكنيسة في العالم المعاصر”، مرجع سابق، بند 13، 56.
[4] إنَّ حقيقة “الخطيئة الأصليّة” (مُصطلح تقليديّ: القديس أغسطينوس) أو “خطيئة العالم” (مُصطلح كتابيّ: يو 1/29) هي مُعطى أساسيّ مِن مُعطيات الإيمان المسيحيّ وعقيدة أساسيّة مِن العقائد المسيحيّة، ولكن حولها توجد نظريات وشروحات لاهوتيّة مُتعددة. فينبغي علينا إذاً أنْ نميِّز بين وجود وحقيقة الخطيئة الأصليّة كمعطى إيمانيّ مِن ناحية، وشرحها والتعبير عن محتوها كتفكير لاهوتي مِن ناحية أخرى. ومِن خلال كلماتي هذه، لا أزعم تقديم شرحاً لاهوتيّاً وافياً، إنَّما مجرد خواطر تأمليّة بسيطة حولها.
[5] الخولاجي المقدس وخدمة الشماس، مرجع سابق، 186.
[6] بحسبِ أوريجانوس، علاَّمة وكاتب كنسيّ مِن القرون الأولى للمسيحيّة (185- 255)، «صورةُ الله هي نقطةُ الإنطلاقِ، أي هي قوةٌ أو إمكانيّةٌ للتألهِ؛ أمَّا مثالُ الله فهو التَّشبهُ بالله، أي هو نهايةُ المطافِ أو خاتمه. وهنا يكمن التَّقدُّمُ الرُّوحيّ للإنسانِ، أي المسيرةُ الرّوحيّةُ التّي يتمُّ فيها الانتقالُ مِن صورةِ الله إلى مثاله».
[G. Peters, I Padri della Chiesa, Borla, Italia 2000, 477. [7 وثائق المجمع الفاتيكانيّ الثانيّ المسكونيّ، دستور عقائديّ في “الكنيسة”، مرجع سابق، بند 2، 378.
[8] المرجع السابق، دستور راعويّ “الكنيسة في العالم المعاصر”، بند 22، 63.
[9] N. Bux, La liturgia degli orientali, Centro ecumenico “S. Nicola”- Padri Domenicani, Bari, Italia 1996, 108.