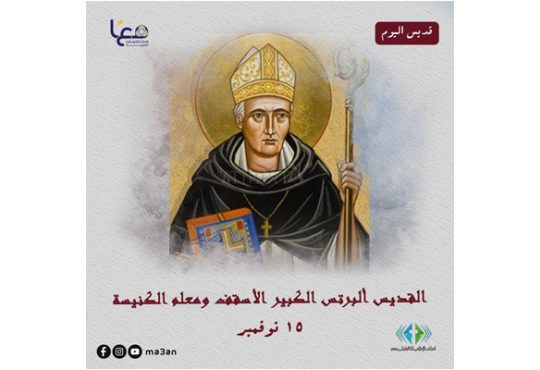المعنى الروحي لِلَاإنسانية الإنسية الملحدة-بقلم روبير شعيب


قراءة روحية لثمار العصر الحديث
لقد دمر التاريخ الحديث أوهام الطوباويات الحديثة مبينًا أن الإنسان لا يستطيع أن يصبح الإنسان المتفوق الذي يحلم أن يكون، وأن الشمولية يمكنها أن تضحي فقط حشدًا يستغل المجموعة لصالح حفنة من الأفراد الذين يشتتون الشعب بأفيون الشيوعية لكي يعيشوا على ظهره. في هذه الصورتين النموذجيتين يلفظ حلم التقدم البشري البحت أنفاسه الأخيرة، ولو بأشكال مختلفة. “فنيتشه يلتفت إلى النهضة، ويريد أن يعيش زخم النهضة الخلاق، ولكنه يجد نفسه على صعيد آخر، حيث يستحيل الوصول إلى ينابيع النهضة التاريخية. بينما يبتعد ماركس عن النهضة معتبرًا إياها مجرد عالم برجوازي باهت، ويتوق إلى ملكوت جديد، حيث لا يمكن أن يحلم الإنسان بملء الروح الخلاق” (N. Berdjaev, Nuovo Medioevo, 30).
يتساءل اللاهوتي اليسوعي الكبير هنري دو لوباك الذي كرس دارسة خاصة ثمينة جدًا لموضوع أنسية العصر الحديث: “ماذا بقي من إنسان الأنسية الملحدة؟”، ويجيب باعتدال وتشخيص ثاقب: “بقي كائن لا يمكننا أن نسميه كائنًا” بقي شيء لا يملك حياة باطنية، خلية غارقة برمتها في كتلة التطور. ‘إنسان اجتماعي وتاريخي‘، لم يبق منه إلا التجريد الصافي بمعزل عن العلاقات الاجتماعية […]. لقد خسر كل ثباته وعمقه”. ولذا ما من شيء يمنع الآن من “استخدام” إنسان من هذا النوع “كمواد أولية، أو كوسيلة لإعداد مجتمع المستقبل، ولضمان سيطرة مجموعة مفضلة” (H. De Lubac, Le drame de l’humanisme athée, 62-3).
في إطار آخر، يتحدث دو لوباك عن التصوف المسيحي، فيصرح: “لعل الاهتمام بالإنسان وحده، والرفض الجدي للمسألة التي يطرحها الإنسان على ذاته هي أسوأ خيانة للإنسان” (H. De Lubac, Mistica e mistero cristiano, Milano 1979, 7).
إن الأنسية التي لا تأخذ بعين الاعتبار دعوة الإنسان الإلهية، إنها هي أنسية لا إنسانية.ولذا فالمعنى الروحي لفشل الأنسية الملحدة هو التالي: “لم يعد هناك الإنسان، لأنه لم يعد هناك ما يتخطى الإنسان” (H. De Lubac, Le drame de l’humanisme athée, op.cit, 63). إن رفض ما هو إلهي، بدل أن يؤدي إلى السمو بالإنسان، إنما يجعله يغرق في سطحية الوجود. سطحية لا يصعب لمسها في حياتنا المعاصرة. وفي غمر تناقض محيطات العدمية التي لا تسبر وآفاقها المحدودة، يكتشف الإنسان بمرارة كيف أنه لا يملك قوة أن يكون “محبًا للبشر” (philanthropos). أراد الإنسان أن يدفن الله لكي يعيش كيتيم فرح، ولكن هذا التناقض في الكلمات هو تناقض أصعب في الواقع. لقد فشلت الأنسية الملحدة والتاريخ والإحصاءات دليل على ذلك: فإن على صعيد الحياة الفردية، الأخلاقية والإنسانية، إذ نلاحظ أن الغرب الملحد إجمالاً يسجل أعلى نسبة كآبة وانتحار في الكوكب، وإن على صعيد جماعي، كفى بنا أن نرى تهافت الشيوعية في روسيا والتاريخ الأسود الذي يرافق الحكم الشيوعي الملحد.
الأنسية من دون الله كشفت عن أنها أنسية من دون الإنسان وضد الإنسان، لأن التطور الإنساني الأصيل لا يمكن أن يكون هدفه الإنسان المجرد، بل بحسب ما يقول باسكال: الإنسان يتجاوز الإنسان (l’homme passe l’homme). الإنسان الذي يبغي التقدم منغلقًا على كينونته يطفئ في ذاته نسمة الحياة السامية، الإنسان يتقدم فقط عندما يتجاوز نفسه (Cf. B. Lonergan, Method in theology, op. cit., 104: “Man achieves authenticity in self-transcendence”).
يقدم الفيلسوف الفرنسي العظيم موريس بلوندل تشبيهًا صائبًا يبين طبيعة النفس البشرية إذ يقارنها بالبانتيون (Panteon) في روما، إن قبة هذا المبنى لا تثبت بفضل ثقل كبيرة يضغط على مختلف أجزائها، فبدل الثقل هناك فتحة على السماء تحفظ القبة وتملأ داخل المعبد بالشعاع، وكذلك النفس البشرية لا تقوم تحت ثقل قبة انغلاق، بل على انفتاح نحو المطلق، نحو الله ينير كل الكيان. إن هذا الانفتاح هو الذي يحفظ إنسانية الإنسانية كفرد وكجماعة. أما الإلحاد الأنسي فقد فشل تاريخيًا لأنه رفض ثورة المطلق الذي هو الله وحده.
إن بعض أفكار نيتشة وماركس هي عميقة وهامة. فكلاهما، على طريقتهما يؤمنان بالتسامي، ولكن خطأهما هو أنهما حذفا من هذا التسامي الكائن المتسامي نفسه واستبدلاه بأوثان دنيوية توهموا بأنهما إلهية: الطبقة العاملة والإنسان المتفوق. نيتشه هو نبوي أمام مسيحية فقدت الزخم النبوي والغرائز السليمة (القديس توما الأكويني يتحدث عن غريزة الروح القدس!) وحب الحياة التي جاء يسوع إلى العالم ليعطيها وليعطيها بوفرة (راجع يو 10، 10).
وماركس أيضًا، نوعًا ما، يردد صدى لاهوت تحرير أرضي أيضًا، لاهوت رحمة نحو الفقراء، نحو اليتيم والأرملة الذين كانوا محط اهتمام الأنبياء ومحور محبة يهوه. فهو يردد ما كان يقوله آباء الكنيسة: إن لم تساعد الفقير تكون قد قتلته (راجع باسيليوس الكبير، ويوحنا فم الذهب بشكل خاص). يلخص الفيلسوف اللبناني الأب رينيه حبشي ما يمكننا كمسيحيين أن نقبله من نظرية ماركس: “إن ما سيجذبنا دومًا في الماركسية، هو أنها تعترف للإنسان بدعوته كمفعّل للتاريخ. ولكن ما سيجعلنا نحجم عنها هو أنها ترفض التسامي وتقطع جذور دعوة الإنسان بالذات” (R. Habachi, Il momento dell’uomo, Milano 1985, 151-152).
نيتشه وماركس يحبان البشرية، ولكن البشرية التي يحبانها ليست الإنسان الواقعي، إنها بشرية مجردة غير موجودة. اهتما بالبشرية على حسب الأشخاص البشريين الملموسين، فلم ينفعا بهذا الشكل ولا حتى بشريتهما المحبوبة لأننا كما يقول بشكل صائب هنري دو لوباك: “لا نتوصل بالحقيقة إلى البشرية ما لم نطال أولاً الإنسان” (H. De Lubac, Paradoxes, Paris 1999, 22). إن محبة البشر لا تستطيع أن تقول في قلب الإنسان لوحدها، دون حب أكبر يسبق ويسند الحب المنزه ويجعله ممكنًا. لقد بين الأديب فيدور دوستويفسكي هذا الحب للبشرية المجردة بشكل جذاب وفذ:
[…] كنت أقول لنفسي: “أنا أحب البشرية، ولكني أتعجب من ذاتي: فكلما يزداد حبي للبشرية، ينقص حبي للبشر بشكل خاص أي كأفراد. وغالبًا في أحلامي، توصلت إلى ابتكار برامج خلاقة حول إمكانية خدمة البشرية، ولعلي قبلت أن أموت صلبًا من أجل البشر، إذا ما بدا الأمر ضروريًا، ولكن مع ذلك، لا أستطيع أن أتعايش لمدة يومين إثنين في غرفة واحدة مع أحد، وهذا أمر أعرفه عن طريق الخبرة. يكفي أن يقوم أحد بقربي فأشعر أنه يخنق بشخصيته حبي لذاتي ويعيق حريتي. تكفيني 24 ساعة لكي أتوصل إلى كره حتى أفضل البشر: ذاك لأنه يطيل الجلوس على المائدة لدى تناوله وجبته، وذاك لأنه مصاب الرشح ولا ينفك يتمخط”. وكنت أضيف: “أنا أضحي عدو الناس حالما يقتربون مني. بالمقابل كان يحدث لي أنه بقدر ما كنت أكره البشر بشكل خاص، كان يتقد قلبي حبًا للبشرية بشكل عام”. (F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov I, Milano 1994, 80-81).
إن ما يصفه دوستويفسكي هو دينامية هامة جدًا، وهي تشبه “الحب التيليسكوبي” الذي يتحدث عنه تشارلز ديكنز، أي موقف من يحب بغرام بطولي الفقراء في البلدان البعيدة ولكنه يغلق قلبه على قريبه وجاره. فهي تعبّر عن توقنا إلى الحب من ناحية، وعن عدم قدرتنا على الحب من ناحية أخرى.
بكلمات أخرى نجدنا بصدد نوّاس يتأرجح بين توقنا إلى بناء ما هو إنساني وتوقنا إلى الخروج من الذات وعيش الحب المنزه، وبين أنانيتنا وعدم قدرتنا على عيشه بقوانا الشخصية. فقط عندما يتخطى الإنسان عقدة النقص تجاه واقع أنه ليس هو منبع الحب، يستطيع أن يصغي إلى نداء الحب الذي يدعوه إلى الشرب والارتواء، فيتخطى الخطيئة “الأصلية”، أي تلك الخطيئة التي من خلالها يريد الإنسان أن يجعل من ذاتها الأصل بدل أن يكون الفرع الذي يثبت وينمي من الغذاء اللمفي الذي يستمده من الأصل. وفقط عندها يستطيع أن يبني التقدم الأصيل المبني على حب أبدي، حب الله، لا على حبنا الأرضي المحدود والممزوج بالأنانية.
خلاصة
إن تحليلنا في معرض هذه المقالة هو مليء بالإشارات إلى الإلحاد المعاصر، وهذا موضوع سنتطرق إليه في مقالة مقبلة تستعرض لا وجه الإلحاد الداكن وحسب، بل أيضًا وجهه التطهيري الذي يتحدى الإيمان ويساعده على أن ينقي ذاته، وجهًا يقترب من لاهوت النفي الذي ميّز روحانية وفكر آباء الكنيسة الشرقيين. أما الآن فنختم هذه المقالة ملخصين ما قد استعرضناه في سطور:
ركزنا في مطلع المقالة على أهمية القيام بتمييز معنى الحداثة، وأوضحنا، انطلاقًا من أقوال يسوع المسيح كيف أن التمييز يقوم على النظر في ثمار الحداثة: هل حملت الإنسان إلى الملء الذي وعدته به؟
ثم قدمنا ملخصًا عن نظرتين لتحقيق الوجود البشري، نموذج الدعوة، التي تشكل نواة النظرة المسيحية: الإنسان يكون ويتقدم ويحقق ذاته بدعوة من الله. ومن ناحية أخرى، نموذج البناء، وهي نظرة الحداثة التي تعتبر أن الإنسان مشروع لا يحققه إلا الإنسان المتحرر والمستقل.
من ثم انتقلنا إلى استعراض بعض مبادئ نموذج البناء في الحداثة بشكل أكثر تفصيلاً فنظرنا إلى مفهوم الحداثة كمفهوم استقلالية ومفهوم فردانية.
في مرحلة لاحقة نظرنا ببساطة إلى ثمار هذه الحداثة، فرأينا كيف أن ما بعد الحداثة تشكل حكمًا سلبيًا على الحداثة، وتبين فشلها، لا انطلاقًا من قراءة إيديولوجية بل انطلاقًا من التمحيص الموضوعي للثمار التاريخية الملموسة. فما بعد الحداثة هي شاهد لتهافت أوهام الحداثة، التي بمحاولتها أن تنفي الله لتعظم الإنسان، ما قامت بالحقيقة إلا بنفي الإنسان. وهذا النفي تم بشكلين مختلفين ومتكاملين. نفي الإنسان باسم الفرد المتفوق الخيالي (نيتشه)، ونفي الفرد باسم الجماعة الوهمية والإيديولوجية (ماركس). وبالتالي ظهر وجه الحداثة المتناقض كأنسية لا إنسانية.
وأخيرًا قدمنا قراءة مسيحية لهذا التحليل فرأينا كيف أن الإنسان يسكنه التوق إلى الحب ولكن في الوقت عينه، لا يملك القدرات الكافية ليعيش على قدر توقه، ولذا فهو بحاجة لا خيارية بل ضرورية إلى “نبع المحبة” لكي يحقق دعوته إلى الحب والتقدم.
بكلمة، الإنسان ليس معطى وضعي بل مشروع قيد الصيرورة والتحقيق، والصيرورة الإنسانية هي مشروع إلهي وحده الله يستطيع أن يجسده.
منقول عن موقع زينيت العالمية روما