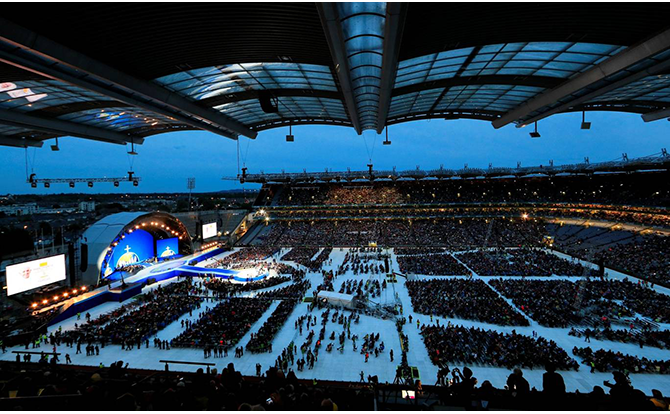حياتنا الفرد والجماعة والعائلة بين الأمس واليوم


” لا تضطرب قُلوبُكم . إنكم تؤمنون باللهِ فآمنوا بي أيضاً ” ( يوحنا ١٤ : ١ )
قبل الآمه وموته ، بدأ السيد المسيح يودّع تلاميذه الوداع الأخير ، وقد عرف أن ساعته قد حانت ، فجمعهم على العشاء السري وأعطاهم وصاياه الأخيرة . وأراد بذلك أن يعطيهم أمثولة في المحبة الأخوية لن ينسوها ابداً ، فغسل أرجلهم وأوصاهم بأن يغسل بعضهم أقدام بعض ، ” فإذا كنتُ انا الرب والمعلّمَ قد غسلتُ أقدامكم ، فيجبُ عليكم انتم أيضاً أن يغسل بعضُكم أقدام بعض . فقد جعلتُ لكم من ننفسي قُدوةً لتصنعوا انتم ايضاً ما صنعتُ إليكم ” ( يوحنا ١٣ : ١٤- ١٥ ) ، وأنبأهم بخيانة يهوذا وإنكار بطرس إياه ، ولكنه أراد أن يشدد عزائمهم أمام هذه المحن التي ستتوالى عليهم ويوطّد إيمانهم به ، فوعدهم بأنه سيصطحبهم حيث يكون فقال لهم : ” لا تضطرب قلوبكم ، آمنوا بالله وآمنوا بي أيضاً ” . لقد اصبحنا في زمن ينبغي فيه على المؤمن أن يتعمق في تعاليم إيمانه بحيث يكون إيمانه شخصياً لا تقليدياً ، ولا سيما أن الإطار القديم الذي عاشه أسلافنا من آباء واجداد ، كان يساعد على إذكاء شعلة هذا الإيمان في النفوس . ولكن هذا الإطار قد تحطم وقد أصبحنا نعيش في بيئة تنأى بالناس عن جو الإيمان والصلاة . ومن خلال مقارنة سريعة تدور على حياة الفرد والعائلة والجماعة في الأمس واليوم ، تظهر لنا الحقيقة التي تهيب بنا إلى العمل بوصية السيد المسيح القائل : ” آمنوا بالله وآمنوا بي ايضاً ” .
١ – حياة الفرد :كان الإنسان فيما مضى يعيش في جو مطبوع بطابع الدين والتقوى والحياة المسيحية البسيطة ، وكانت الكنيسة انذاك تهيمن على الحياة . فمثلاً في القرية ، كان القروي يعيش في بساطة مسيحية ، قريباً من ارضه وبيته وعائلته ، مقتنعاً بما قسم الله له من نصيب . وغالباً ما كان ينظم أوقاته على دقات جرس الدير أو الكنيسة . وينطلق صوت الجرس الفضي عند الصباح فيستبق المؤمن فيرسم على وجهه شارة الصليب ، وإذا كان تقياً ، اتجه إلى الكنيسة ، ليحضر القداس ويرفع قلبه ويقدّم نهاره واعماله ، الآمه و اوجاعه وافراحه إلى الله وإذا مر بقربها تبارك بحجارتها ، ثم يذهب إلى عمله . فكانت تمر الأيام ممهورة بطابع التقوى والإيمان . هذا بالأمس ، أما اليوم ، فقد هجر الناس القرية إلى المدينة ، وانعدم الجو الديني ، فأصبح ابن القرية في المدينة غرسة ضربتها الرياح ، ففقد الاحتكاك بالواقع ، على حد قول غوارديني ، وتجاذبته النظريات والأرقام وأصبح العيش مصطنعاً وانقلب نظام الحياة ، فلم يعد الليل ليلًا ولا النهار نهاراً ، وتداخلت الفصول ، ولم يعد هناك من يصغي إلى حديث الأشياء ، فلا يرى الإنسان إلا مادة عجماء يطاردها ليستولي عليها ويتاجر بها ، ثم يبحث عنها . وبدلاً من رنين اجراس الكنائس أصبح لا يسمع إلا صفارات المعامل تدعوه إلى العمل كما أشار إليه البابا بولس السادس : ” تبدل الإطار واختفى الجو الديني التقوي “ .
٢ – حياة العائلة :وكان الإطار العائلي يساعد العائلة على البقاء متماسكة مع بعضها . فيعيش الأولاد في كنف والديهم وهؤلاء يشددون الرقابة عليهم ويتمون بتربيتهم وتنشئتهم الروحية . وكان الجو أنيساً جميلاً تسوده روح المحبة والثقة المتبادلة ، فلا يتخذ تدبير إلا بإذن رب البيت ، ومعرفته وموافقته ، وحتى الزواج كان الرأي فيه للوالدين قبل الأبناء ، وإن عدّ ذلك من باب التجاوز على الحريات ، ولكنه أمر يظهر محبة الأهل واحترامهم وطاعتهم و تماسك أفراد العائلة وتعاطفها مع بعضها . أما العائلة اليوم فمشتتة : فالوالدان يعملان كل في قطاعه ، والأولاد موزعون في مدرسة أو مكتب أو معمل . وغالباً ما يعودون في المساء وقد أنهكهم التعب . فهذا يتصفح جريدته وذاك يسمر عينيه على شاشة التليفزيون لحضور مسلسل ترفيهي او برنامج علمي ، وآخر يتفقد المحمول الخاص به او الحاسوب الالكتروني ، فيستحيل الحديث الودي الأخوي بين أفراد العائلة . هذا إذا لم يذهب كل منهم ليقضي السهرة مع اصدقائه او حيث يريد . وما القول في الوالدين يتركون أمر تربية أبنائهم للخدم فينشأؤن وقد فقدوا تقليد العائلة وما تركه الأجداد من تراث أخلاقي ومحبة وحنان وعطف والديّ ؟ وليس في هذا الجوّ من أثر للدين وتعاليمه في العائلة الواحدة وفي المجتمع . ٣ – حياة المجتمع :كان الناس في القرية يوثّقون فيما بينهم رابطة التعارف والمودّة ، فيتعاونون ويتساندون وكانت الثقة متبادلة ، يقرض الجار جاره مبلغاً من المال سراً ، وبدون سند ولا رهن ولا شهود . وغالباً كانوا يجتمعون, يوم الأحد ، بعد القداس ، ليعقدوا اجتماعاتهم العائلية تحت السنديانة التاريخية القائمة في ساحة الكنيسة ، او في بيت كبير العائلة . وإذا نشب خلاف او زعل او سوء تفاهم ، حاولوا تسويته فيما بينهم . فكانت الأعياد مناسبةًزاهية لحضور الإحتفالات الدينية وقبول الاسرار المقدّسة فتترك بهجة وسعادةً في النفوس والقلوب ، و فرصة للزيارات والتقارب ، وغسل الحقد والكراهية . أما الإطار الاجتماعي اليوم فقد تبدّل ، وأصبح الإنسان في سباق سريع ودائم مع الوقت ، ليحصّل قوته وقوت عياله. وانقطعت العلاقة الأخوية بينه وبين عائلته وجيرانه واصدقائه . فأصبح يعيش مجهولا ً وسط قوم مجهولين في المدينة الصاخبة بالضجيج . فهو يعيش في جو قلّ فيه ذكر تعاليم الدين ووصايا الله والمسيح ، إن لم يكن فيه ما يحارب الدين كالاذاعات والتلفزيونات والمجلات والصحف والتمثيليات الخلاعية ، والانتقادات الهدامة . فكيف الثبات في مثل هذه الحالة على الإيمان ، ولا إطار تقليدي يساعد المؤمن ولا جو ديني يسعفه على المحافظة على ما ورث عن اسلافه من شعائر دينية ومحبة واحترام للكبار و للقريب . نعم ، لقد بلغنا طور الرجولة كما يقول بولس الرسول : ” فكل من كان طعامه اللّبن الحليب لا تكون له خبره بكلام البر لأنه طفل ، في حين أن الطعام القويّ هو للراشدين ، لأولئك الذين بالتدّرب روّضت بصائرهم على التمييز بين الخير والشر ” ( عبرانيين ٥ : ١٣ ) .
ولهذا أصبح على المؤمن أن يبذل الجهد ليتعمق في أصول دينه وتعاليمه ، ويتكل على نعمة ربه لا على التقاليد والعادات الشعبية ، للمحافظة على إيمانه ، و عليه أن يتأمل مليّاً وعلى ضوء جديد ما أمر به السيد المسيح القائل : ” آمنوا بالله وآمنوا بي ” ليسلم له إيمانه.