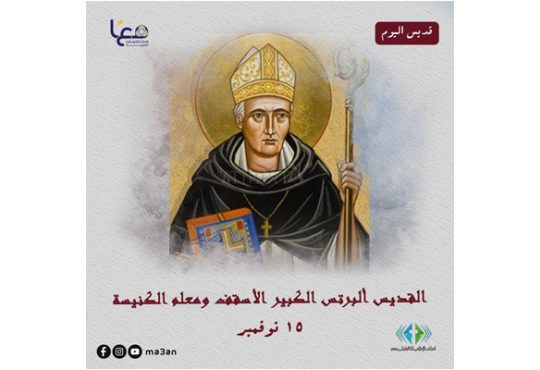شهداء ليون ( القرن الثاني الميلادي 177م )

الشهيدة بلاندينا النبيلة _ يوسابيوس القيصري

شهداء ليون (القرن الثاني الميلادي 177م)
كانت بلاد الغال هي الملكة التي أعِدَّ لهم فيها مسرح المصارعات. وأهمّ بلادها ليون وفينا، اللتان يخترقهما نهر الرون، وهو نهر متّسع يخترق كلّ تلك المنطقة. وقد أرسَلَت أشهر كنائس تلك المملكة إلى كنائس آسيا وفريجيّة وَصفًا للشهود ودوّنت ما كان يجري بينها في الكلمات التالية. وهاك كلماتها:
”خدّام المسيح المقيمون في فينا وليون ببلاد الغال إلى الإخوة في آسيا وفريجيّة، الذين يعتنقون نفس الإيمان ورجاء الفداء، سلام ونعمة ومجد من الله الآب ويسوع المسيح ربّنا”.
وبعد التحدّث عن بعض المواضيع الأخرى تبدأ روايتها بهذه الكيفيّة:
”إنّ شدّة الضيق في هذه البلاد، وهياج الوثنيّين على القدّيسين، وآلام الشهود المبارَكين – هذه لا نستطيع وَصفها بدقّة، كما لا يمكن تدوينها. فالخصم هجم علينا بكلّ قوّته، مقدّمًا إلينا عيّنة من نشاطه الذي لا يُحَدّ، الذي سيظهره عند هجومه علينا مستقبلاً، وقد بذل كلّ ما في وسعه لاستخدام أعوانه ضدّ خدّام الله. ولم يكتفِ بإبعادنا عن البيوت والحمّامات والأسواق، بل حرَّم عليهنا الظهور في أيّ مكان. ولكن نعمة الله حوّلَت الصراع ضدّه، وخلّصَت الضعفاء، وجعلَتهم كأعمدة ثابتة، قادرين بالصبر على تحمّل كلّ غضب الشرّير. واشتبكوا في الحرب معه، متحمّلين كلّ صنوف العار والأذى. وإذ استهانوا بآلامهم أسرعوا إلى المسيح، مظهِرين حقًّا: أنّ آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وأوّل كلّ شيء تحمّلوا ببسالة كلّ الأضرار التي كدّسها الغوغاء فوق رؤوسهم كالضجيج، واللطم، والجرّ على الأرض، والنهب، والرجم، والسجن، وكلّ ما يُسِرّ الغوغاء الثائرون أن يوقعوه على الأعداء والخصوم. وبعد ذلك اخذَهم فائد الألف، ورؤساء المدينة، إلى الساحة الخارجيّة، وحقّق معهم بحضور كلّ الجمهور. ولمّا اعترفوا، سُجنوا لِحين وصول الوالي. وعندما مَثلوا أمامه فيما بعد، وعاملنا بمنتهى القسوة، تدخّل في الأمر فيتيوس أباجاثوس، وهو أحد الإخوة، وكان ممتلئًا محبّة لله وللإنسان. وقد كانت حياته طيّبة جدًّا لدرجة أنّه رغم حداثة سنّه نال شهرة كشهرة زكريّا الشيخ، لأنّه كان سالكًا في جميع وصايا الربّ وأحكامه بلا لوم، وكان لا يَكَلُّ في جميع أعمال الخير من نحم الإخوة، غيورًا لله، حارًّا في الروح. وإذ كانت هذه هي صفاته لم يحتمل المحاكمة الظالمة التي كنّا نحاكم بها، با امتلأ غضبًا، وطلي أن يسمح بالشهادة في مصلحة إخوته بأنّه لا يوجد بيننا أيّ قبح أو شرّ. ولكن المحيطين بكرسيّ القضاء حرّضوا ضدّه، لأنّه كان ذا شخصيّة بارزة، ورفَض الوالي طلبه العادل، إنّما سأله عمّا إذا كان هو أيضًا مسيحيًّا. ولمّا شهد بهذا بصوت عالٍ أخِذَ هو نفسه إلى عداد الشهود، ودعا شفيع المسيحيّين، إذ كان في داخله شفيع، أي الروح الذي امتلأ به أكثر من زكريّا وقد أظهر هذا بملء محبّته، لأنّه كان يسرّه جدًّا أن يضع حياته دفاعًا عن الإخوة. لأنّه كان ولا يزال تلميذًا حقيقيًّا للمسيح، متّبعًا الخروف حيثما ذهب. حينئذٍ انقسم الباقون. فالشهود الأصليّون كانوا مستعدّين، وأكملوا اعترافهم بكلّ شجاعة. ولكن ظهر أنّ البعض لم يكونوا مستعدّين ولا متدرّبين، بل وُجدوا ضعفاء وعاجزين عن احتمال صراع شديد كهذا. وفشل نحو عشرة من هؤلاء، مسبّبين لنا حزنًا شديدًا وألَمًا لا يوصَف، ومثبطين عزيمة الآخرين الذين لم يكونوا قد ألقِيَ القبض عليهم بعد، والذين رغم تحمّلهم كلّ صنوف الآلام ظلّوا ملازمين الشهود، ولم يفارقوهم. عندئذٍ خفنا كلّنا جدًّا بسبب عدم تأكّدنا من اعترافهم، لا فَزَعًا من الآلام التي يجب تحمّلها، بل لأنّنا تطلّعنا إلى النهاية وخشينا لئلاّ يفشل البعض منهم. على أنّ المستأهلين كان يُلقى القبض عليهم يومًا بعد يوم مكملين عددهم، حتّى أنّ جميع الغيورين، الذين بُنيَت عليهم مصالحنا بصفة خاصّة، جُمعوا من الكنيستَين.
وألقِيَ القبض على بعض خدمنا الوثنيّين، لأنّ الوالي أمر بأن نفحص كلّنا جهارًا. وهؤلاء إذ أغراهم الشيطان، وخافوا على أنفسهم من التعذيب الذي رأوا أنّ القدّيسين يعانونه، وإذ حرّضهم الجند أيضًا، فقد اتّهمونا زورًا بأكل لحوم البشر، والفسق بالأهل المحرّم الزواج بهنّ، وأمور لا يليق بنا عدم التحدّث عنها أو التفكير فيها فحسب بل لا نعتقد أنّ أيّ إنسان بشريّ اقترَفها على الإطلاق. وعندما قدّمت هذه التهم هاج ضدّنا كلّ الناس كالوحوش المفترسة، لدرجة أنّه إن وُجد بينهم مَن كان في غاية الاعتدال معنا بسبب الصداقة فقد ثاروا ضدّنا جدًّا وأصرّوا بأسنانهم علينا. وتمَّ ما قاله الربّ: تأتي ساعة فيها يظنّ كلّ مَن يقتلكم أنّه يقدّم خدمة لله. وأخيرًا تحمَّل الشهود الأطهار آلامًا لا توصَف، وكان الشيطان يحاول بأقصى جهده أن تخرج من شفاههم كلمات التجديف.
على أنّ كلّ غضب الغوغاء والوالي والجند انصبّ فوق هامة سانكتوس، وهو شمّاس من فينا، وماتوروس، وهو متنصّر حديث ولكنّه مجاهد شجاع، وأتالوس وهو من أهالي برغامس حيث كان بصفة مستمرّة عمودًا حيًّا وأساسًا متينًا، وبلاندينا التي أظهر المسيح فيها أنّ ما يبدو في نظر البشر حقيرًا ودنيئًا ووضيعًا هو في نظر الله مجيد بسبب المحبّة التي نكنها له التي تظهر في قوّة الافتخار بالمظاهر. لأنّنا إذ كنّا كلّنا مرتعبين، وكانت سيدتها الأرضيّة -وهي نفسها أيضًا كانت ضمن الشهود- خائفة لئلاّ يعوقها ضعف جسدها عن الاعتراف بجسارة، امتلأَت بلاندينا قوّة لدرجة أنّها صمدَت أمام معذّبيها الذين كانوا يتناوبون تعذيبها من الصباح حتّى المساء بكلّ أنواع التعذيب، حتّى اضطرَّتهم إلى الاعتراف بأنّهم قد غُلب على أمرهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيئًا أكثر. وذهلوا من قوّة احتمالها إذ كان كلّ جسدها قد تهرّأ، واعترفوا بأنّه كان يكفي نوع واحد من هذه الآلام لإرهاق الروح، فكَم بالأوْلى كلّ هذه الآلام المتنوّعة العنيفة. على أنّ المرأة المبارَكة جدّدَت قوّتها في اعترافها كمصارعة صنديدة، وقد وجدت تعزية وانتعاشًا وتخفيفًا لآلامها في أن تصرخ: أنا مسيحيّة، ونحن لم نفعل شرًّا.
أمّا سانكتوس فقد تحمّل أيضًا بشكل عجيب، وفوق طاقة البشر، كلّ ما عاناه من آلام. وبينما حاول الأشرار -بالاستمرار في تعذيبه، والإمعان في القسوة- أن يصطادوا منه أيّة كلمة مِمّا لا يجب أن يقوله، فقد سلَّح نفسه بذلك الثبات العجيب الذي جعلَه لا ينطق حتّى باسمه أو اسم شعبه أو المدينة التي ينتمي إليها، ويذكر إن كان عبدًا أو حرًّا، بل أجاب باللغة الرومانيّة على كلّ أسئلتهم بقوله: أنا مسيحيّ، لقد اعترف بهذا عِوضًا عن ذكر اسمه أو اسم المدينة التي ينتمي إليها أو الجنس التابع له أو أيّ شيء آخر. ولم يسمع الشعب منه كلمة أخرى. لذلك تحرّكَت الرغبة في قلب الوالي وقلوب معذّبيه للتغلّب عليه. ولكنّهم إذ لم يملكوا شيئًا أكثر يفعلونه له رَبطوا أخيرًا صفائح نحاسيّة محمّاة إلى أجزاء جسمه الرقيقة. وهذه احترقَت فعلاً، ولكنّه ظلّ متجلّدًا لا يلين ولا يستسلم، ثابتًا في اعترافه منتعشًا متقوّيًا بينبوع مياه الحياة السماويّ المتدفّق من أحشاء المسيح. وكان جسده شاهدًا لآلامه، غذ كان قد تهرَّأ كلّه وتشوَّه بشكل بشع، وكان أبعد ما يكون عن شكل الإنسان. وإذ تألّم المسيح فيه أظهرَ مجده، منقذًا إيّاه من خصمه، وجاعلاً إيّاه مَثلاً للآخرين، ومبيّنًا أنّه حيث وُجدَت محبّة الله فلا يوجد أيّ شيء مخيف، وحيث وُجدَ مجد المسيح فلا يوجَد شيء أليم. وعندما عذّبه الأشرار مرّة أخرى بعد بضعة أيّام، ظانّين أنّهم، وقد انتفخ جسده، والتهب لدرجة أنّه لم يعُد يطيق لمس اليد، قد يستطيعون التغلّب عليه إن وضعوا نفس الصفائح على جسده أو -على الأقلّ- أنّ الآخرين يخافون عندما يرونه تحت آلامه. وهذا أمر لم يكن ممكنًا فقط أن يحدث بل بعكس كلّ انتظار بشريّ انتعش جسده وانتصب وسط التعذيبات المتوالية واستعاد شكله الطبيعيّ، وتحرّكَت الأطراف، وهكذا صارت هذه الآلام الثانية، بنعمة المسيح سببًا لا في التعذيب بل وفي الشفاء. ولكن إبليس إذ ظنَّ أنّه قد التُهمَ فعلاً ببلياس وهي إحدى الذين أنكروا المسيح، وأن يزيد في دينونتها بتحريضها على النطق ببعض كلمات التجديف، فقد دفعَها ثانية إلى التعذيب ليضطرها، بسبب ضعف جسدها، إلى الوشاية بنا. غير أنّها استعادَت قوّتها تحت الآلام، كأنّها قد استيقظَت من سبات عميق، وإذ ذكرَتها الآلام الحاضرة بعذاب جهنّم الأبديّ وقفَت في وجه المجدّفين قائلة: كيف يستطيع هؤلاء أن يأكلوا الأطفال وهم يُحرَمون أن يذوقوا حتّى دماء الحيوانات غير العاقلة، عندئذٍ اعترفَت بأنّها مسيحيّة، فحُسبَت في عداد الشهود. ونظرًا لأنّ المسيح جعل هذه التعذيبات الظالمة عديمة الجدوى بسبب صبر المباركين، اخترع إبليس تدبيرات أخرى، وهي الحبس في أظلم وأقبح مكان في السجن ووضع الأقدام في الثقب الخامس من المقطرة، والتعذيبات الأخرى التي اعتاد أعوانه توقيعها على المسجونين عندما تثور ثائرتهم ويتملّك عليهم إبليس. وقد اختنق الكثيرون في السجن إذ اختارهم الربّ لهذا النوع من الموت ليظهر فيهم مجده.
ورغم أنّ البعض عُذّبوا بمنتهى القسوة، حتّى كان يظنّ أنّه من المستحيل أن يعيشوا مهما بذلت معهم كلّ أنواع العلاج والتمريض، إلاّ أنّهم لبثوا في السجن بعيدين عن كلّ رعاية بشريّة، إذ تقوّوا بالربّ، وانتعشَت أجسادهم وأنفسهم، فشدّدوا وشجّعوا الباقين. أمّا الذين كانوا قد ألقيَ القبض عليهم حديثًا ولم يتمكّنوا من احتمال قسوة السجن لسبب حداثة سنّهم وعدم تمرّن أجسادهم على التعذيب، فماتوا فيه.
أمّا المغبوط بوثينوس، الذي كان قد أوكلَت إليه أسقفيّة ليون، فقد جرّوه إلى كرسيّ القضاء، وكان عمره يزيد على تسعين سنة، وقد وهنت كلّ قواه، يكاد بالجهد أن يتنفّس بسبب ضعف جسده. ولكنّه تقوّى بالغيرة الروحيّة بسبب رغبته الحارّة في الاستشهاد. ومع أنّ جسده قد فتّت في عضده الشيخوخة والأمراض، فقد حُفظَت حياته لكي ينتصر المسيح فيها. وعندما أتى به الجند إلى المحاكمة، يرافقه بعض الولاة المدنيّين وجمهور من الشعب يهتفون ضدّه بكلّ أنواع الهتاف كأنّه هو المسيح نفسه، شهد شهادة نبيلة. ولمّا سأله الوالي: مَن هو إله المسيحيّين أجاب: إن كنتَ مستحقًّا فستعرف. عندئذٍ جرّوه بفظاظة ولطموه بكلّ أنواع اللطمات. فالقريبون منه لكموه بأيديهم، وركلوه بأرجلهم، غير حاسبين أيّ حساب لِسِنّه، والبعيدون منه قذفوه بكلّ ما وصلَت إليه أيديهم، والكلّ ظنّوا بأنّهم يعتبَرون مجرمين إن قصّروا في إهانته بكلّ إهانة ممكنة. لأنّهم توهّموا أنّهم بذلك ينتقمون لآلهتهم. من ثمّ زجّ به في أعماق السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفّس، ثمّ مات بعد يومَين.
بعدئذٍ حدث افتقاد عظيم من الله، وظهرَت مراحم يسوع بشكل لا يوصَف وبكيفيّة يندر أن تُرى بين الإخوة، ولكنّها مع ذلك ليسَت بعيدة عن قدرة المسيح. لأنّ الذين تراجعوا عند القبض عليهم لأوّل مرّة سجنوا مع الآخرين وتحمّلوا آلامًا مرّة. وهكذا صار إنكارهم عديم الجدوى لهم، حتّى في العالم الحاضر. أمّا الذين اعترفوا بحالتهم، فقد سُجنوا كمسيحيّين، ولو توجَّه إليهم أيّة اتّهامات أخرى. أمّا السابقون فقد عوملوا فيما بعد، كقتلة ومجرمين، بقسوة ضعف القسوة التي عوقبَ بها الآخرون. لأنّ فرح الاستشهاد، ورجاء المواعيد، ومحبّة المسيح، وروح الآب سندَت الأخيرين، أمّا ضمائر الأوّلين فقد عذّبَتهم جدًّا حتّى كان يسهل تمييزهم عن الباقين بمجرّد النظر إلى وجوههم وهم يُساقون. فالسابقون خرجوا فرحين، يطفح المجد والنعمة على وجوههم، حتّى كانت نفس قيودهم تبدو كأنّها حليّ جميلة كعروس مزيّنة بحليّ ذهبيّة. وقد تعطّروا برائحة المسيح الذكيّة، حتّى ظنّ البعض أنّهم تعطّروا بعطور أرضيّة. أمّا الآخرون فقد كانوا أذلاّء، منكسري الخاطر، مكتئبين، مملوئين بكلّ أنواع الخزي، وكان الخسيسين يعيّرونهم كخسيسين وضعفاء، حاملين تهمة القتلة، وخسروا شرف ومجد الاسم العظيم واهب الحياة. وإذ رأى الباقون هذا تقوّوا، وعندما عرف أمرهم اعترفوا بلا تردّد، ودون أن يعيروا أيّ التفات لإغراءات إبليس”.
وبعد كلمات أخرى استمرّت في حديثها قائلة:
”وبعد هذا انقسمَت أخيرًا استشهاداتهم إلى كلّ الأشكال، لأنّهم إذ ضفروا إكليلاً من كلّ الألوان وكلّ أنواع الزهور قدّموه إلى الآب. ولذلك كان من اللائق أن ينال هؤلاء الأبطال النبلاء الإكليل العظيم غير الفاسد، بعد أن تحمّلوا آلامًا عنيفة، وغلبوا ببسالة نادرة. وهكذا أخذ إلى المسرح ماتوروس وسانكتوس وبلاندينا وأتالوس، لكي يُعرّضوا للوحوش الضارية، ولكي يقدّم للشعب الوثنيّ منظر من مناظر القسوة، وحدّد لشعبنا يوم خاصّ للصراع مع الوحوش. جاز كلّ من ماتوروس وسانكتوس مرّة أخرى كلّ أنواع العذاب في المسرح، كأنّهما لم يكابدا شيئًا من الآلام من قبل، أو بالأحرى كأنّهما الآن، وقد انتصرا على عدوّهما في عدّة مواقع، يجاهدان من أجل الإكليل نفسه، وتحمّلا ثانية القصاص المعتاد وهو المرور بين صفَّين من الجند فيضربهما كلّ منهم بدوره، ثمّ قسوة الوحوش المفترسة، وكلّ ما طلبَه الشعب الثائر أو أرادوه، وأخيرًا الكرسيّ الحديديّ الذي شُويَ به جسداهما. ولم يقنع المعذّبون بهذا، بل ازداد جنونهم من نحوهما، وعزموا على التغلّب على صبرهما. ولكنّهم حتّى بهذا لم يسمعوا من سانكتوس كلمة سوى الاعتراف الذي نطق به في البداية. وهكذا إذ ظلّت حياتهما تقدّم هذا الصراع العنيف مدّة طويلة، ماتا أخيرًا بعد أن قدّما طول ذلك النهار منظرًا للعالم عوض أنواع الصراع العاديّ المختلفة.

أمّا بلاندينا فقد عُلّقَت على خشبة وعُرضَت لابتلاع الوحوش المفترسة التي تهجم عليها. ولأنّها ظهرَت كأنّها معلّقة على صليب، وبسبب صلواتها الحارّة، فقد ألهبت المجاهدين بنار الغيرة، لأنّهم نظروا إليها في جهادها، ونظروا بأعينهم الخارجيّة ذاك الذي صُلب لأجلهم، في هيئة أختهم، وذلك لإقناع المؤمنين باسمه أنّ كلّ مَن يتألّم لأجل مجد المسيح تكون له على الدوام شركة مع الإله الحيّ. ولأنّه لم يمسَّها وقتئذٍ أيّ واحد من الوحوش المفترسة فقد أنزِلَت عن الخشبة وأودعَت السجن ثانية. وهكذا حُفظَت لصراع آخر، حتّى إذا ما انتصرَت في الجهاد دفعات أخرى جعلت قصاص الحياة الملتوية بلا شفاء. ومع أنّها كانت صغيرة السنّ، ضعيفة ومحتقرة، إلاّ أنّها إذ لبسَت المسيح الغالب المقتدر، استطاعَت أن تثير حمية الإخوة، ونالَت بجهادها الإكليل غير الفاسد بعد أن غلبَت الخصم مرارًا عديدة.
أمّا أتالوس فدعاه الشعب بصوت عالٍ لأنّه كان ذا شخصيّة بارزة. فدخل إلى المحاكمة بكلّ ثبات بسبب ضميره الصالح وسيرته الطيّبة في المسيحيّة، ولأنّه كان دائمًا بيننا شاهدًا للحقّ. اقتيد حول المسرح، وحُملت أمامه لوحة كُتب عليها باللغة الرومانيّة: هذا أتالوس المسيحيّ. فامتلأ الشعب غضبًا من نحوه. ولكن لمّا علِم الوالي أنّه رومانيّ أمر أن يُعاد مع الباقين الذين أودعوا السجن، والذين كتب عنهم على قيصر ولم يصله منه الردّ بعد. على أنّ الفترة المتوسّطة لم تذهب سدًى، ولم تكن عديمة الجدوى بالنسبة إليهم لأنّهم بصبرهم ظهرَت مراحم المسيح التي لا تُحدّ: وإذ ظلّوا أحياء أقيم الموتى، وأظهر الشهود رحمة ومحبّة نحو الذين لم يشهدوا، واغتبطَت الأم العذراء (أي الكنيسة) بمَن قبِلتهم أحياء بعد أن سبق وأخرجَتهم كأموات. لأنّهم بتأثيرهم عاد الكثيرون مِمَّن سبق أن انكروا، وولدوا ثانية، ودبّت فيهم الحياة مرّة أخرى، وتعلّموا أن يعترفوا. وإذ عادَت إليهم الحياة وتقوّوا ذهبوا إلى كرسيّ المحاكمة ليستجوبهم الوالي. والله الذي لا يسرّ بموت الخاطئ، بل يدعو الجميع برحمته إلى التوبة، عاملَهم باللطف. لأنّ قيصر أمر بإعدامهم، أمّا مَن ينكر فيطلق سراحه. ولذلك، ففي بداية العيد العامّ الذي حلَّ وقتئذٍ، والذي حضرته جماهير من كلّ الشعوب، قدّم الوالي المباركين إلى مجلس القضاء ليجعل منهم منظرًا للجماهير، وعندئذٍ فحص أمرهم ثانية، وأمر بقطع رأس مَن كان منهم يحمل الرعويّة الرومانيّة، ولكنّه أرسل الباقين إلى الوحوش الضارية.
وتمجّد المسيح جدًّا في مَن سبقوا فأنكروا، لأنّهم -بعكس انتظار الوثنيّين- اعترفوا. فقد حقّق معهم على انفراد، كأنّه على وشك أن يطلق سراحهم. ولكنّهم إذ اعترفوا حُسبوا في عداد الشهود. واستمرّ البعض خارج حظيرة الشهود، وهؤلاء هم الذين لم تكن لديهم ذرّة من الإيمان، أو أقلّ معرفة عن لباس العرس أو شيء من الإدراك عن خوف الله، بل -كأبناء الهلاك- جدّفوا على الطريق بارتدادهم. أمّا جميع الباقين فقد ضمّوا إلى الكنيسة. وبينما كان يُجري التحقيق مع هؤلاء، كان هنالك شخص يُدعى الإسكندر، وهو فرّيجيّ المولد، تحترف مهنة الطبّ، وكان قد عاش في بلاد الغال سنوات طويلة، معروفًا من الجميع بسبب محبّته لله وجرأته في الكلام، لأنّه لم يكن خاليًا من نصيب في النعمة الرسولية، هذا إذ وقف أمام كرسيّ القضاء يشجّعهم، ببعض الإشارات على الاعتراف، ظهر أمام الواقفين بجواره كأنّه في شدّة وضيق. ولكن الشعب ثار لأنّ الذين سبق أن أنكروا قد اعترفوا الآن، فصرخوا ضدّ الإسكندر، كأنّه هو السبب في كلّ هذا. عندئذٍ استدعاه الوالي وسأله عن شخصيّته. ولمّا أجاب بأنّه مسيحيّ اغتاظ جدًّا وأمر بطرحه للوحوش الضارية. وفي اليوم التالي دخل مع أتالوس. لأنّ الوالي أمر بطرح أتالوس ثانية للوحوش إرضاءً للشعب. فعُذّبا في المسرح بكلّ الآلات المعدّة لهذا الغرض، وماتا أخيرًا بعد أن تحمّلا آلامًا عنيفة. ولم يُصدر الإسكندر أيّ أنين أو تذمّر بأيّ شكل من الأشكال، بل كان يناجي الله في قلبه. ولكن عندما وضع أتالوس في الكرسيّ الحديديّ، وتصاعد الدخان من جسده المشويّ قال للشعب بلغة رومانيّة: إنّ هذا الذي تفعلونه أنتم هو التهام للبشر، أمّا نحن فإنّنا لا نأكل البشر، ولا نرتكب أيّ شيء آخر. وعندما سُئل عن الاسم الذي يحمله الله أجاب: أنّ الله لا يحمل أيّ اسم كما يحمل الإنسان.

بعد كلّ هذا أحضِرَت بلاندينا، في آخر يوم من أيّام الصراع العنيف، مع بونتيكوس وهو صبيّ يبلغ عمره نحو الخامسة عشر سنة. وقد كان يؤتى بهما كلّ يوم ليشهدا آلام الآخرين، ويضغط عليهما ليحلفا بالأوثان. ولكن لأنّهما ظلاّ ثابتَين محتقرَين إيّاها، اشتدّ هياج الجمهور حتّى أنّهم لم يشفقوا على حداثة سنّ الصبيّ، ولم يراعوا رقّة جنس المرأة. لذلك عرّضوهما لأقسى أنواع العذاب، وطلبوا منهم مرارًا أن يحلفا، ولكنّهم فشلوا. لأنّ بونتيكوس كانت تشجّعه أخته حتّى أنّ الوثنيّين كانوا يرونها تثبّته وتقوّيه، وبعد أن تحمّل التعذيب بكلّ ثبات أسلم الروح. أمّا المغبوطة بلاندينا فإنّها أخيرًا، إذ شجّعَت أبناءها كأمّ نبيلة، وأرسلَتهم قبلها ظافرين منتصرين إلى الملك السماويّ، تحمّلَت هي نفسها كلّ صراع، وأسرعَت للّحاق بهم، فرحة ومغتبطة برحيلها، كأنّها قد دُعيَت إلى وليمة عرس، لا على الطرح للوحوش المفترسة. وبعد الجلد، وبعد الوحوش المفترسة، وبعد الشيّ بالنار على الكرسيّ الحديديّ، وُضعَت أخيرًا في شبكة وطُرحَت أمام ثور، وهذا قذف بها هنا وهنالك، ولكنّها لم تشعر بشيء مِمّا كان يحدث لها بسبب رجائها، وتمسّكها التامّ بما اؤتمنَت عليه، وشركتها مع المسيح، وأخيرًا فاضت روحها. وقد اعترف الوثنيّون أنفسهم أنّه لم توجَد بينهم امرأة تحمّلَت مثل هذه الآلام المروعة.
ولكن جنونهم وقسوتهم ووحشيّتهم نحو القدّيسين لم تقف عند هذا الحدّ. لأنّ تلك القبائل المتوحّشة إذ أغراها الوحش المفترس لم يشفِ غليلها بسهولة، ولذلك وجدت وحشيّتهم فرصة أخرى للتمثيل بالجثث. لأنّهم بسبب نقص عقليّتهم ورجولتهم لم يخجلوا أنّهم غُلبوا، بل بالعكس ازداد غضبهم اشتعالاً كوحوش مفترسة، وأثاروا حكم الوالي والشعب لمعاملتنا بمنتهى الظلم ليتمّ الكتاب: مَن يظلم فليظلم بعد. ومَن هو نجس فليتنجّس بعد. ومَن هو بارّ فليتبرّر بعد. لأنّهم طَرحوا للكلاب جثث مَن ماتوا اختناقًا في السجن، حارسينها نهارًا و ليلاً لئلاّ ندفن نحن إحداها. وتركوا الأشلاء التي تبقّت من الوحوش المفترسة والنار في العراء لتتعفّن وتفسد، ووضعوا رؤوس الآخرين بجوار أجسادها وحرسها الجند أيامًا كثيرة بنفس الطريقة لئلاّ تُدفن. وثار البعض، وأصرّوا بأسنانهم عليه، طالبين انتقامًا أشدّ قسوة. وسخر بهم الآخرون، معظّمين أصنامهم التي عزوا إليها قصاص المسيحيّين. وحتّى العقلاء فيهم الذين كان يبدو بأنّهم يظهرون نحونا بعض العطف، كانوا يعيّرونهم قائلين: أين إلههم، وماذا نفعتهم ديانتهم التي فضّلوها على الحياة. هكذا تنوّعت تصرّفاتهم نحونا، ولكنّنا كنّا في أشدّ الألم لعدم تمكّننا من دفن الأجساد. لأنّه لا الليل كان مجديًا في هذا الصدد، ولا المال كان كافيًا للاقناع، ولا التوسّلات حرّكت عواطفهم. ولكنّهم كانوا يعتنون كلّ العناية براسة الجثث كأنّ عدم دفنها كان جزيل النفع لهم”.
وبعد سرد أمور أخرى أضافت:
إنّ أجساد الشهداء إذ تُركت مكشوفة في العراء ستّة أيام أُحرقت وصارت رمادًا، وطرحها الأشرار في نهر الرون الذي اكتسحها، وذلك لكي لا يظهر لها أثر على الأرض. وهذا فعلوه كأنّهم قادرون على غلبة الله وعلى أن يُعيقوا ولادتهم الجديدة لكي، على حدّ تعبيرهم، لا يكون لهم رجاء في قيامة الأموات بالثقة التي فيها قدّموا إلينا هذه الديانة الجديدة الغريبة، واحتقروا الأهوال، واستعدّوا حتّى لملاقاة الموت بفرح. لننظر الآن إن كانوا يقومون ثانية، وإن كان إلههم قادرًا على مساعدتهم وتخليصهم من أيدينا”.
شفاعة الشهيدة بلاندينا وجميع شهداء ليون تشملنا جميعاً آمين.
المرجع: يوسابيوس القيصري، تاريخ الكنيسة ، القسم الرابع، ترجمة القمص مرقص داود.