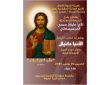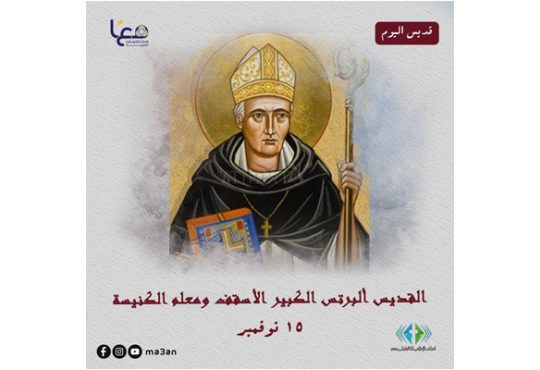تأملات في صلوات البصخة المقدسة ” مضمون بصخة ليلة ويوم الاثنين “

تأملات في صلوات البصخة المقدسة
مضمون بصخة ليلة ويوم الاثنين
عندما أقف مُتأملًا نص الخلق، الذي تقدمة لنا قراءات يوم الاثنين من البصخة المقدسة، يعتريني التعجّب والاندهاش النابع من تساؤلات عديدة تراودني، وربما تراودنا جميعًا، وذلك منذ نعومة أظافرنا:” لماذا خلقنا الله؟”. كانت الاجابة، التي علمتنا إياها الكنيسة، في دروس الإعداد للمناولة الاحتفالية، هي :” لقد خلقنا الله لنعبده ونخدمه ونحبه كما أحبنا”. ظلت هذه الاجابة كامنة في صدري، ولا تروي عطشي. اليوم أقف مُرددًا نفس السؤال. أحاول، معكم انطلاقًا، من قراءات صلوات البصخة، أن أجد إجابة تروي ظمأي وربما ظمأكم أيضًا.
دار في ذهني حوارًا مع الله طارحًا عليه تساؤلاتي، بدأت حواري مع الله، بطوفان من الأسئلة، قائلًا: من أين نبعت فكرة الخلق داخلك يا إلهي؟ ما هو الدافع من ورائها؟ هل كُنتَ مُدركًا معناها؟ ومدى توابعها وغايتها؟ هل تشاركتم كثالوث في اتخاذ هذا القرار والذي من وجهة نظري قرارًا مصيريًا، ليس فقط بالنسبة لنا كبشر، بل ربما أيضًا بالنسبة لك ؟ ما الداعي الذي يجعلك مرتبطًا بالخليقة؟ هل كان أمرًا ضرويًّا بالنسبة لك؟ أم مجرد نزوة ومغامرة لم تحسب لها جيّدًا؟ ما هو تقيمك لما حدث وما يحدث خلال تاريخنا البشري؟ في النهاية، هل أبديت الندم عن ذلك الفعل؟ أبديت اعتذاري على وقاحتي وجرأتي في طره هذه الأسئلة. ثم انتظرت الاجابة.
انتظرت طويلًا، فلم أجد اجابةً، بل ساد صمت طويل وعميق، تردد صدى هذه الأسئلة في اعماقي. أصغيت لصوت خافت داخلي يقول لي: حاول أن تجد اجابة لهذه الأسئلة في أعماقك وخبرتك التي عشتها. بعد قترة صمت طويلة وصلاة عميقة، أشارككم ما سمعته في داخلي. يقول الرب : إذا كانت طبيعتي، أنا الله، هي المحبة، بالتالي هي شركة وتبادل لتيار المحبة فيما بيننا نحن الثالوث. طبيعة المحبة هذه هو تيار مُتنامي وفيّض المستمر، لا ينقطع. هذا الفيّض يتطلب منا في نهاية الأمر، والذي، في الواقع، لا نهاية له، فهو فيض مستمر، فعل خروج دائم، ليس فقط فيّضًا تعبيريًا نظريًا، بل خروجًا كيانيًّا. هذا جراء طبيعتنا التي هي المحبة ( إله ثالوثي – علاقي). نتج عن ذلك، بالطبيعة، ضرورة فعل الخلق التي وصل إلى قمته في الإنسان:” (( لِنَصنَعِ الإِنسانَ على صُورَتِنا كَمِثالِنا))” ( تك 1: 26).هو قرار ثالوثي نابع عن قناعة تامة، ووعي تام، صادر من عمق كياننا، ليس قرارًا حتميًّا قدريًّا خارجًا عن إرادتنا، كما يبدو لأول وهلة، بل نابع من إرادة ووعي صادر عن الحب الفيّاض. إنه تعبير، وفي الوقت نفسه، كشفٌ لذاتنا الإلهية وطبيعتها، التي هي أولًا وأخيرًا حركة حب فيّاض. ربما أن جاز لي القول، الله، بالخلق، أكتشف وحقق ذاته الخلّاقة المُحبّة الفيّاضة. إنه قرار شجاع ومغامرة لا تعرف التراجع، مٌتحملًا مسؤوليتها وتبعاتها، الرائعة والمؤلمة وربما المميتة.
في الواقع، الحب مُكلّفٌ للغاية، فمعالم مسيرته غير واضحة تمامًا، إنه انطلاق نحو المفاجآت، لذلك يطلق علية مغامرة. فالحب هو علاقة بين طرفين، غالبًا تتم بين أشخاص من نفس الطبيعة، يتمتعان بحرية وإرادة خاصة لكل منهما. تنطبق هذه الشروط على الثالوث الإلهي. بينما في الواقع، لا تنطبق، بنفس الدرجة، على العلاقة بين الله الخالق والإنسان المخلوق: إنهما طبيعتان مختلفتان، مع الاخذ في الاعتبار أن الإنسان على صورة خالقه ومثاله. هذه المغامرة، محسوبة ومُحددة المعالم والغاية بالنسبة لله، بالتالي ليست مجرد نزوة. بينما بالنسبة للإنسان، بسبب الخطيئة وطبيعته المخلوقة، قد تبدو هذه المُغامرة غير واضحة المعالم ” وقالَ الرَّبُّ لأَبْرام: (( اِنطَلِقْ مِن أَرضِكَ وعَشيرَتكَ وبَيتِ أَبيكَ، إِلى الأَرضِ الَّتي أُريكَ” ( تك 12: 1)؛ والتي تصل في بعض الأحيان، لدى بعض المُفكّرين إلى مستوى العبثيّة، كما حدث عند المفكر الفرنسي” كامو”، أو الإلحاد لدى ” سارتر”. فأين الحكيم إذن؟ بالتالي تحمل قصة الخلق التي قرأناها اليوم كل ما يحمله الله لنا من حب مجاني فيّاض. أيضًا عمق حكمته الإلهية التي لا تقارن بالحكمة البشرية، لأنها حكمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحب الفيّاض الذي لا ينهزم أبدًا. هي حكمة في خدمة الحب، أي في خدمة العلاقة بين الله الخالق والإنسان المخلوق:” لِمَن كُشِفَ أَصلُ الحِكمَةِ ومَنِ الَّذي يَعرِفُ حِيَلَها؟ واحِدٌ هو حَكيمٌ رَهيبٌ جِدًّا وهو الجالِسُ على عَرشِه” ( سيراخ 1: 1- 24)؛ هكذا ضلّ الانسان البحث عن الحكمة خارجًا عن ذاته والتي هي صورة الله:” أَنَّهم تَرَكوا شَريعَتي الَّتي جَعَلتُها أَمامَهم ولم يَسمَعوا لِصَوتي ولم يَسيروا علَيها، بل ساروا وَراءَ تَطَلُّبِ قُلوبِهم ووراءَ البَعْل، مِمَّا عَلَّمهم آباؤُهم” ( ارميا 9: 13- 19). في الواقع، نكتشف أن عملية الخلق تحمل في طبيعتها الدعوة لأن نكون أو لا نكون:” أيها الإنسان أمامك طريقان: طريق الحياة وطريق الموت، أختر الحياة”؛ ” أنما أتيت لكي ما تكون الحياة، ملء الحياة”؛ فحياة الإنسان هي دعوة ليكون أنسانًا، فقط، في الله، في المسيح، من خلال فعل الحب. علاقة يكتشف فيها الإنسان طبيعته، هويّته ورسالته في آنٍ واحد. إنها دعوة، يدعو فيها الله الانسان لإقامة علاقة حب، بالتالي الإنسان في مسيرة تحقيق، عبر الزمن، لهذه العلاقة من خلال مسيرة الحب. من هذا المنطلق تنبع المغامرة والمخاطرة التي تتعرض فيها هذه العلاقة الحبيّة لخيبات أمل وأحيانًا للفشل.
عند هذه النقطة بدأ شعاع من النور ينبثق في باطني ينير لي ملامح الاجابة على تساؤلاتي السابق طرحها: إنه فعل حب، فيّاض مجاني محض. لقد أخذ الله الثالوث توابع هذا الفعل، لأنه ببساطة فعل حب. فكل فعل حب يحمل في جعبته فعل بذل وتضحية وتواضع غير محدود.. كل ما تناولناه سابقًا هو من منظور إلهي المُبادر دائمًا. يتبع ذلك موقف الإنسان وقصة السقوط ( تك 2: 15- 3: 24)، أنها توابع الخلق، التي تُظهر عدم كفاءة الإنسان، بمفرده، على إدراك سبب وجوده، أي الحب الفيّاض، فالإنسان مخلوق بالحب ولأجل الحب، فالحب هو العلّة أي السبب والغاية، ولا شيء غير ذلك. هذا ما أعلنته كلمة الله المتجسدة والمكتوبة، هذا ما أكتشفه واختبره العديد من القديسين أمثال القديس أغسطينوس القائل:” أحبب وأفعل ما شئت”، أيضًا القديسة تريزا يسوع الطفل:” دعوتي هي الحب”. أغوت الحيّة الإنسان بالتجربة، بانسياقه وراء الفكرة الخادعة، ألا وهي: فكرة الكمال، الاكتفاء الذاتي، والتي لن تتحقق مُطلقًا بانغلاقه وانعزاله عن الآخر- عن الله. فإن كان هناك رغبةً في الكمال، فهو فقط في كمالٌ في المحبة أي في علاقة الشركة، لأن المحبة هي سبب وجوده وهي في الوقت نفسه، غايته الأخيرة، أي حياة الشركة مع الله والاتحاد به (الحياة الأبدية).
لم يتخلْ الله عن الإنسان بسبب محبته الفيّاضة. هكذا ترتبط قصة ومشروع الخلق بمشروع الخلاص، فالمحبة لا تعرف الانكسار. هذا ما أطلقنا عليه آنفًا ( سابقًا) “لإيمان التضامني”، الذي اختبره التلاميذ خلال رحلة حياة يسوع معهم، وما سوف يحققه يسوع خلال رحلة صعوده إلى أورشليم. فإذا كانت المحبة الفيّاضة هي خروج دائم، خروج عن الذات الإلهية، الذي تمّ في تجسد الأقنوم الثاني: ” يسوع المسيح” ” المُخلّص”. في هذا الاطار، يصعد يسوع ليتمم ما قد بدأه الثالوث في الخلق، أي تلك المحبة الفيّاضة، نحو أورشليم. يسوع يقود تلاميذه اللذين يتبعونه خائفين مضطربين، ويقودنا معه:” وكانوا سائِرينَ في الطَّريق صاعِدينَ إِلى أُورَشَليم، وكانَ يسوعُ يَتقدَّمُهم، وقد أَخَذَهُمُ الدَّهَش. أَمَّا الَّذينَ يَتبَعونَه فكانوا خائِفين” ( مر 10: 32). يبدأ يسوع في الإعلان عن تقدمة ذاته من أجل خلاص البشرية:” ((ها نحنُ صاعِدونَ إِلى أُورَشَليم، فَابنُ الإِنسانِ يُسلَمُ إِلى عُظَماءِ الكَهَنَةِ والكَتَبَة، فيَحكُمونَ علَيه بِالمَوت، ويُسلِمونَه إِلى الوَثَنِيِّين، فَيسخَرونَ مِنه، ويَبصُقونَ علَيه ويَجلِدونَه ويَقتُلونَه، وبَعدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يَقوم))” ( مر 10: 33-34)، بينما يسوع سائر في مغامرته إلى النهاية، نحو هدفه الواضح المُؤسس على الحب، نجد رد فعل بطرس الرسول السلبي والرافض للآلام، والذي يجسد مغامرتنا غير واضحة المعالم “.
يا سيد نريد أن نرى يسوع”، هذا ما طلبة اليونانيون من فيلبس، ولما سمع يسوع قال :” قد أتت الساعة التي يتمجد فيها ابن البشر “( يو 12: 20- 36). هكذا يعلن يسوع ويدشن برنامج أسبوع البصخة المقدسة – أسبوع ألامه – رحلة العبور، حملًا معه البشرية، فهو حمل الله الحامل خطايا العالم. هكذا فقدت ذباح العهد القديم فاعليتها أمام ذبيحة المسيح، ابن الله :” قدِ آنقَطَعَتِ التَّقدِمَةُ والسَّكيب عن بَيتِ الرَّبّ وآنتَحَبَ الكَهَنَةُ خُدَّامُ الرَّبّ” ( يوئيل 1: 9). في خلال هذه المسيرة يلتفت يسوع سائلًا تلاميذه :” ((مَن أَنا في قَولِ النَّاس ؟))… ((ومَن أَنا، في قولِكم أَنتُم ؟))” ( مر 8: 27، 29). هذا ما يطرحه علينا نخن أيضًا في مسيرة حياتنا، من أنا بالنسبة لك؟
هكذا يستمر تيار المحبة الفيّاضة كفعل خروج إلهي دائم، والذي يتطلب من الإنسان موقفًا وتجاوبًا، أيّ فعل خروج دائم ، إيّ فعل محبة فيّاض. فقط تحت الصليب أدرك قائد المائة هذه الحقيقة قائلًا:” بالحقيقية كان هذا هو ابن الله”. هكذا يدخل يسوع المسيح أسبوع الآلام كحمل يساق إلى الذبح ولم يفتح فاه… هذه الحقيقة وحدها وأمامها يمكننا أن نستشف سّر الله، وسّر الإنسان. هذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة.
مع محبتي وصلاتي.
الأب / أنطونيوس فايز