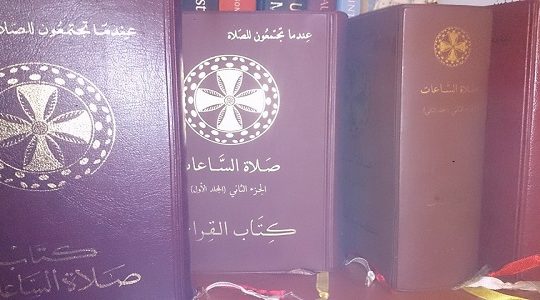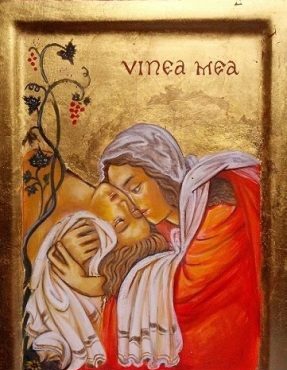من عادة الكنيسة الكاثوليكية أن تضع في آخر السنة قراءات خاصة من الكتاب المقدس تتحدث عن عواقب الإنسان، وهي في التعليم المسيحي: الموت، الدينونة، نهاية العالم، النعيم، الجحيم، المطهر، الثواب والعقاب، مجيء المسيح الثاني… وما إلى ذلك من مواضيع تتعلق بمصير الإنسان بعد الموت، مجيبة بذلك عن الأسئلة الوجودية: ماذا هناك بعد حفنة التراب؟ هل هناك شيء بعد الموت؟ إلى أين يذهب الإنسان بعد الموت؟ هل هناك حياة أخرى أم ينتهي كل شيء بموت الإنسان ودفنه في القبر حيث يتحلل جسده ويرجع إلى التراب؟ وأسئلة كثيرة أخرى يطول الحديث عنها لو أردنا عرضها في هذه العجالة لأنها من المواضيع التي يحاول الإنسان أن يعرفها ليطمئن قلبه ويضمن مستقبله ويروي ظمأ فضوله… فيا ليتنا نعرف؟!
يمكن اختصار الجواب على هذه الأسئلة من “قانون الإيمان المسيحي” الذي نقول في نهايته عن السيد المسيح بأنه “سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات” ويقول على لسان المؤمنين “ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي”. وهذا يدل على أننا نؤمن بمجيء المسيح الثاني، وأنه سيكون دياناً للأحياء والأموات، وأن هناك قيامة للموتى وحياة أبدية في السماء. وبهذا يطمئن قلبنا بأن الموت ليس الكلمة الأخيرة ولا نهاية المسيرة للحياة الدنيوية القصيرة بل بداية حياة أخرى ليس لها نهاية.
ولكني في هذا المقام أريد أن أتوقف فقط عند قضية الحساب وأتحدث عن الثواب والعقاب أنطلاقاً من مثل الوزنات عن الملك الذي يوزع أمواله على عبيده، فيعطي أحدهم خمس وزنات والثاني وزنتين والثالث وزنة واحدة، وعندما يعود من السفر يحاسبهم ويجد أن الأول استثمر الوزنات الخمس وربح خمس أخرى، والثاني استثمر الوزنتين وربح وزنتين أخريتين، فاستحق الأول والثاني ثناء الملك: “أحسنت أيها العبد الصالح الأمين، لقد كنت أميناً على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك”. أما العبد الثالث فقد كان كسلاناً فدفن الوزنة ولم يتاجر بها فاستحق غضب سيده الذي ألقاه “في الظلمة البرانية حيث البكاء وصريف الأنسان”.
إن هذا المثل يدل على أن الله يخلق الإنسان لغاية معينة ولهدف سامٍ في حياته، وأن كل إنسان مهم في عيني الله مهما كانت قدراته وإمكانياته، فهو يوزع على البشر المواهب على قدر طاقة المرء “إن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها”، ويطالب باستثمار هذه المواهب ويحاسب على ذلك كل واحد بحسب ما أعطي “فمن أعطي الكثير يطالب بالكثير ومن أعطي القليل يطالب بالقليل”، ويزن كل شيء بميزان الأعمال، خيراً كانت أم شراً، ومن هنا الربح أو الخسارة، الثواب أو العقاب. إن الحياة فرصة يجب اغتنامها لعمل الخير ولاستثمار المواهب التي يعطينا أياها الله بحيث نكنز لأنفسنا رصيداً ليس فقط على هذه الأرض بل أيضاً في السماء يوم الحساب.
بما أن ساعة الموت حتمية وهي قادمة لا محالة آجلاً أم عاجلاً، وبما أن كل إنسان سيمثل أمام محكمة الله العادلة ليؤدي الحساب عن أعماله خلال حياته الأرضية، فإنه ينبغي أن نكون من الساهرين المتيقظين لأن لا أحد يعرف متى سيكون اليوم ولا الساعة، فقد يأتي كالسارق في الليل أو بغتة كما يأخذ المخاض الحامل. ولكي لا يفاجئنا ذلك اليوم، علينا أن نكون من أبناء النور وأبناء النهار، لأننا لسنا من الليل ولا من الظلمات، وعلينا أن لا ننام كما يفعل سائر الناس بل علينا أن نسهر ونحن صاحون.
علينا أن نقوم بكل أعمالنا بمحبة لأننا سنحاسب على المحبة، على أن تكون هذه المحبة خالصة طاهرة نقية لا تقوم على المنفعة الشخصية ولا المصلحة الخاصة. علينا أن نحب الله لذاته لأن الله محبة ولأنه يستحق محبتنا. إن هذا يذكرني بقصة رابعة العدوية التي عندما بلغت الثمانين من عمرها وصلت إلى الذوبان في الله وبلغت لدرجة عالية من العشق الإلهي، فقد شاهدها أهل بغداد يوما تركض في الشوارع حاملة سطل ماء بيد وسطل جمر نار بيد أخرى، فحسبوا أنها اصيبت بالجنون، فسألوها عن الأمر، فأجابت: إني أحمل سطل الماء وأريد أن ألقيه على السماء لأشعلها وأحمل سطل جمر النار وأريد أن ألقيها على جهنم وأطفئها، لكي لا أعبد الله طمعاً في ثوابه ولا خوفاً من عقابه بل لذاته وحباً به.
وهذا يقودنا إلى أبيات جبران خليل جبران المشهورة في قصيدته “المواكب” حيث يقول بما معناه أن الدين في الناس نوع من التجاره يحسبون أنهم إذا عبدوا الله ربحوا وإذا كفروا خسروا، والسبب هو الخوف من الله: فلولا عقاب البعث ما عبدوا رباً ولولا حساب يوم النشر كفروا. وهذا صحيح في علاقتنا مع الله حتى يومنا هذا إذ أننا نعتبر الدين صفقة تجارية فنحن نرفع إلى الله الصلوات ونقوم بالعبادة طمعاً بنيل الخيرات والبركات على هذه الأرض والنجاة من العقاب والويلات في الحياة الأخرى، وكأننا نسترضيه بهذه الواجبات الدينية لكي يمنحنا مقابلها، تماماً كما نفعل مع التاجر الذي نعطيه مبلغاً من المال لكي يعطينا كمية من السلع، ولا ندري أنه “ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السموات”.
أما بعض الناس فإنهم يعيشون الحياة الدنيا دون أن يحسبون حساباً ليوم الآخرة، فهم يطبقون مبدأ “أرض أرض” ولا يعرفون أن هناك “أرض سماء” وبالتالي يقولون لأنفسهم: “لنأكل ونشرب ونتنعم فغداً نموت” ويسمحون لأنفسم بارتكاب كل الآثام والقبائح ويعملون “السبعة وذمتها” ولا يبالون بشريعة أو قانون أو ضمير ويستهترون بالدين والدنيا بالأرض والسماء، فيحتقرون الإنسان ويظلمون الناس ولا يأبهون لأحد إلا لأنفسهم وكأن لسان حالهم “اللهم نفسي”. ولا يعلمون أن لكل بداية نهاية وأن الظلم لا يدوم، وأن الله سيحاسب كل إنسان على أعماله خيراً كانت أم شراً، وان هناك ثواب أو عقاب، إن لم يكن على هذه الأرض ففي الحياة الآخرى، وأن مصيرهم بين أيديهم فبمقدورهم أن يحصلوا على سعادة السماء أو أن يجنوا على أنفسهم بالهلاك في العذاب الأبدي في دار الجحيم.
وفي حالتنا، فإن الظلم الصارخ الذي يصل عنان السماء ويطالب أصحاب الضمير بالصحوة قبل فوات الأوان وينتظر من العناية الإلهية العدل والإنصاف، فلا يمكن أن يستمر الظالم في غيه إلى أبد الآبدين، ولا بد للحق أن يعلو وللعدل أن ينتصر، عندها سنسمع صوت ملك الملوك ورب الأرباب يقول بحنان: “أحسنت أيها العبد الصالح الأمين إدخل نعيم سيدك” أو نسمع صوته المخيف يجلجل بالحكم: “إذهب عني أيها العبد الظالم المتجبر فليس لك هنا مكان، أدخل جحيم سوء تصرفك”. فطوبى للعبد الأمين والويل للعبد الظالم اللعين.
الأب رائـد أبو ساحلية
مدير عام كاريتاس القدس
موقع ابونا