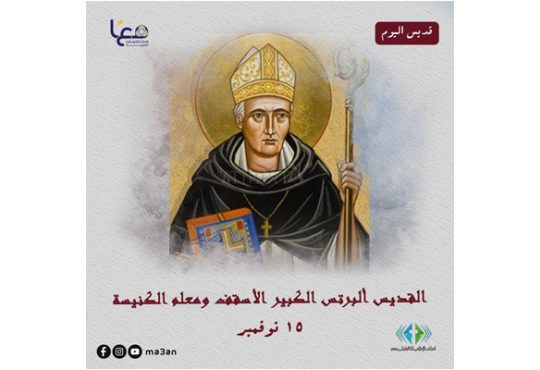الحبّ المثمر من نافذة “فرح الحب”

-تذكير ببعض بمبادئ الحبّ
يتناول الإرشاد الرسوليّ “فرح الحبّ” الصادر عن البابا فرنسيس بتاريخ 19 آذار 2016 (منذ سنة)، قضية العائلة والثنائيّ، اللذين يجتمعان باسم الحبّ وبسببه. إنّ عنوان “فرح الحب” ومضمونه، ما هو إلاّ تأكيد على أهميّة الحبّ وضرورته للحياة البشريّة. من هنا أتى الإرشاد ليوضّح مبادئ الحبّ ومفهومه، ويؤكّد على أهميّة دعم وجود العائلة ومساندتها كي تبقى وتثمر، بالرغم من التحدّيات والصعوبات والعراقيل التي تواجهها. وتبقى مفاهيم الحبّ والزواج غامضةً وملتبسةً لدى الكثيرين، بالرغم من تطوّر العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة.
الإرشاد الرسوليّ، إرشادٌ راعويّ، تعليميّ للمبادئ وللقيم التي يستشفّها مننظرة الخالق وتعاليم السيّد المسيح من خلال الإنجيل، كما هو توجيهيّ للشباب الذي يتحضّر لسرّ الزواج وللمتزوّجين الجدد (المرافقة ما بعد الاحتفال بسرّ الزواج). من هنا يُدخلنا الفصل الخامس، من الإرشاد بعنوان “الحبّ الذي يصبح مُثمرًا”، إلى التوقّف على مفهوم الحبّ ومبادئه. وبما أنّ عنوان الإرشاد، “فرح الحبّ”، يشدّد على إعادة فهم الحبّ وقيمته والالتزام به، لأنّ حياة الثنائي ضمن الحياة الزوجيّة والعائليّة، تتمحور حول الحبّ ونجاحه، الذي يؤدي إلى الإنجاب والسعادة والبهجة والفرح، إذا عرف الرّجل والمرأة عيشه بكلّ أبعاده. فالحبّ المبنيّ على العاطفة والعقل والاحترام، إلى آخره، يبقى نقطة الارتكاز لكلّ علاقة غراميّة تصبو إلى زواجٍ ناجح.
نلاحظ بأنّ الإرشاد الرسوليّ ركّز وسلّط الضوء على معنى الحبّ وأهميّته وأساسه في نجاح الحياة الزوجيّة، كما ذكّر ووضّح معنى الزواج المسيحيّ والعائلة، لأنّ هناك إرادة ونيّة من قبل البعض بتغيير ماهيّة الحبّ والزواج والعائلة والطّعن بهم وبنواتهم وهيكليّتهم وتركيبتهم. لقد أُسيء فهم القيم والمبادئ والمصطلحات، ونتيجة ذلك أتى التطبيق مشوّهًاعند البعض.
من هنا أتى الإرشاد ليؤكّد عقيدة الكنيسة وصوابيّة تعاليمها، فهو بمضمونه أي بكلماته ومواقفه،استباقيّ ووقائيّ يساعد على تفادي فشل الأزواج في حياتهم العائليّةويجنّبهم الوقوع في الضعف ويكفيهم شرّ الهرب إلى الأمام والتخلّي عن العهد والوعد، والانجرار نحو الخلل وعدم الانسياق للحقيقة، وعدم امتلاك القدرة على تخطّي الصّعوبات والمشاكل.
الإرشاد الرسوليّ مطبوعٌ بطابع الحبّ والفرح، الحبّ هو العنوان الرئيس والمفتاح الأوّل لقراءة الإرشاد. هذا الحبّ، الذي يتكلّم عنه البابا فرنسيس، متأصّل في الإنسان في نظام الخلق والنعمة. فالله يهب النعمة للثنائيّ من خلال سرّ الزواج، ليحافظ على “شعلة الحبّ”، لأنّه يضمن استمراريّة فضيلة الحبّ. ويتابع البابا فرنسيس تصويبه لمفهوم الحبّ المنفتح والدائم النّموّ، الذي يُسهم في سعادة أفراد العائلة وإعطائهم القدرة على استقبال الحياة بطريقة متجدّدة، وعيشها بفرح دائم وبهجة متّقدة، بما يؤكّد محبّة الله للإنسان والعكس صحيح. فالله كشف للبشر حبّه الأبويّ الفادي، الذي يخوّلهم العيش معه كأبناء مخلّصين، فهكذا تنمو إنسانيّة الإنسان في الحبّ الدائم والمعطي ثمرًا بمجانية وبذل الذات. يدعو البابا المتزوّجين إلى النموّ في الحبّ الزوجيّ وشركة الحياة، إلى الفرح والجمال والحوار. حثّ البابا العائلة على النموّ في الحبّ تدريجيًّا، فهي ليست واقعًا كاملاً لا عيب فيه. إنّ هذا الحبّ الزوجيّ والعائليّ المسكونين والنابضين من الحبّ الإلهيّ (عدد 315).
ذكّر الإرشاد الرسوليّ أخيرًا، وشرح ووضّح وأكّد، مفاهيم الحبّ كما حثّ المعنيين بالحبّ، على العودة إلى أصول الحبّ وعيشه كما ينبغي. زِد على ذلك تشديده على السعيّ لإدراك قيمة الحبّ على حقيقته من خلال التمسّك بجوهره ومضمونه وتأثيراته الإيجابيّة على حياة النّاس.”فالحبّ – اللقاء أو اللقاء – الحبّ، ينطلق من عوامل إيجابيّةٍ ومنطقيّة، ومن ظروف ملائمة، ومناسبات فريدة، وعلامات مميّزة، وأفكار واضحة، وأساليب صالحة، وتصّرفات منزّهة، ومن الرؤية الواضحة لتحقيق الذات، من خلال الوصول إلى الهدف المنشود لتلك العلاقة التي تؤدّي إلى السعادة “المنشودة”، شرط تكثيف الجهود، وتجنيد الإمكانات، وتسهيل العلاقات، وتنفيذ المشاريع والمخطّطات، وتحقيق المبادئ، والاعتراف بالقيم، وممارسة الحوار الصريح والواضح بين الحبيبين، وعشق الالتزام، والرغبة في البقاء معًا، والمثابرة على التعبير الحيّ، والاستمرار في إنجاح حياة الشراكة.”[1]
لا يمكننا أن نغفل أنّه طرأت على عالمنا تغييرات “جذريّة”، لبعض المفاهيم والمبادئ والتقاليد. إنّ سوء فهم التعاطي مع التفاعلات التربويّة والثقافيّة وسواها، أدّت إلى تفاعلات سلبيّة على جميع الصُّعُد، لا سيّما لمفهوم الحبّ والزواج والعائلة. فهل (تبقى) تصلح مبادئ الكنيسة وتعليمها لمفهوم الحبّ اليوم، بحسب مفاهيم الشباب وعيشهم للحبّ وللمبادئ وللقيم؟ هل يبقى الحبّ، بالنسبة لهم، حالة فرح وسعادة؟ أمّ مجرّد تعاسة وعذاب؟ أو نزوة عابرة؟ ونتساءل كيف يربّي مجتمعنا على الحبّ؟ أي صورة يقدّم؟ وماذا يفعل؟ ما هو دور كلّ فردٍ ناضج ومسؤول؟ كيف يتمّ تأهيل الأمّهات والآباء على تربية أولادهم؟ وتنشئتهم على الإيمان والمبادئ والقيم؟ كيف يساندهم المجتمع؟ (وعلى جميع الصُّعُد). نعم، الأسئلة كثيرة.
3- من ثمار الحبّ
- استقبال حياة جديدة
عرضنا بعض المبادئ والأفكار حول الحبّ الذي يتعلّمه الإنسان لكي يحقّقه، لأنّه حالة فرح. فالحبّ يولّد الفرح والفرح يولّد الحبّ. الحبّ يعطي ثمرًا؛ وهذا يتطلّب الالتزام والمجّانيّة والعطاء والتضحية. بالمطلق، يهدف الحبّ إلى الارتباط الجدّي والعلنيّالمستمر بين الرّجل والمرأة، تحت مؤسّسة الزواج والتي تنبع من الحبّ ويكون الزواج سببه وهدفه وغايته. وهذا الحبّ ضمن سرّ الزواج، ينتج عنه ثمرًا ألا وهو الإنجاب وتبنّي الأولاد وتربيتهم والعلاقة التفاعليّة المتجدّدة دومًا بين الزوجة والزوج، التي تؤدي إلى النموّ والسعادة وتحقيق الذات والقداسة وذلك دائمًا ودومًا باسم الحبّ. يقول البابا فرنسيس في الإرشاد الرسوليّ العدد 31، فقرة “زواج عن حبّ” إنّ جوهر الزواج ]…[ يتضمّن سلسلة من الواجبات التي تنشأ من الحبّ نفسه، من حبٍّ حازم وسخيّ لدرجة أنه قادر على المجازفة بالمستقبل”. ويتابع الإرشاد قوله في (الفصل الخامس) العدد 165 “الحبّ يمنح دومًا حياة. لهذا السبب، الحبّالزوجيّ لا ينتهي عند حبّ الزوجين، ]…[ لأنّهما، فيما يتبادلان هبة الذات، يهبان، أكثر من نفسيهما، الوجود للولد الذي هو صورةٌ حيّة لحبّهما، ورمزٌ دائم لوحدتهما الزوجيّة، وخلاصةٌ حيّة لا يمكن فصلها عن كونهما أبًا وأمًّا”.
ينتقد بعض المتزوّجين الجدد الكنيسة لأنّها تضغط عليهم بالقبول بالإنجاب (الخصوبة)، وأحيانًا نصادف متزوّجين، يرفضون الإنجاب (بإعلانٍ صريح). ما هو موقف رعاة الكنيسة؟ كيف يتعاملون مع تلك “الحالات”؟ وكيف يعالجونها؟ هل هذا عائق لقبول سرّ الزواج؟ هل يحقّ للرّعاة التدخّل في هذا الشأن الخاص؟ وهل رفض الإنجاب هو رفضٌ للحبّ ومبادئه؟
يطمح الحبّ ضمن سرّ الزواج دومًا إلى استقبال حياةٍ جديدة، ينقلها للآخرين، عبر الانسجام والاتّفاق والمودّة والتفاني بين الزوجة والزوج. وهذا يتمّ عبر التحضير لاستقبال تلك الهبة من الله. فالحياة الجديدة تكشف “بُعد مجّانيّة المحبّة”. “إنّ عطيّة طفلٍ جديد، والتي يهبها الله إلى الأب والأمّ، تبدأ بفعل الترحيب به، ومن ثمّ برعايته طيلة فترة حياته الأرضيّة، وهدفها النهائيّ هو بهجة الحياة الأبديّة”.[2]
يتطلّب التحضير لاستقبال حياةٍ جديدة ضمن العائلة، الوعيّ الكافي والمسؤوليّة ومعرفة الانتظار. هذا الاستعداد المجبول بالحبّ والمحبّة والشوق والترقّب المفرح، يعطي علامة حقيقة لولادة جديدة. تلك “الخليقة” مدعوّة مع مرور الزمن، لعيش ملء الحياة.”فكلّ طفلٍ يتكوّن في أحشاء أمّه هو مشروعٌ أبديّ من الله الآب ومن حبّه الأزليّ ]…[ ومنذ لحظة الحمل به في الرحّم، يتحقّق حلم الخالق الأبديّ”.[3] يراود هذا الحلم أيضًا الأمّ والأب، أي بمشاركتهم، لحلم الله ومشروعه للبشر: إعطاء القدرة والمشاركة في الخلق والإبداع. “لا توجد عائلةٌ بدون حلم. فإن فقدت العائلة القدرة على الحلم، فإنّ الأطفال لا ينمون ولا ينمو الحبّ، ويخيّم الظلام وتنطفئ الحياة”.[4]
إنّه من الضروريّ أن يشعر الولد (مستقبلاً) بأنّه كان منتظرًا ومرغوبًا به ومحبوبًا. فالولد “ليس مكمّلاً أو حلاًّ لطموح شخصيّ ]…[، فالابن محبوب لكونه إبنًا”. بالتأكيد، هذا الولد المنتظر، يستقبله الأهل بعناية ودراية واهتمام كبير، فيشكّل فرحة وبهجة واطمئنان وتوازن، وهذا نابع من محبّة عميقة وكبيرة “إنّ حبّ الأهل هو أداة لحبّ الله الآب الذي ينتظر بكلّ حنان ولادة كلّ طفل، ويقبله دون أي شروط ويستقبله مجّانًا”.[5] ولا بدّ للمرأة في فترة الحمل، أن تهتم بصحتها ونفسيتها وحالتها الروحيّة، من أجل تأمين، أفضل المتطلّبات، لتحقيق تلك الولادة الجميلة بحالة من الفرح، وذلك بنقلها للمولود الجديد.
يذكّر الإرشاد، بأهميّة وفاعليّة، حبّ الأمّ والأب للولد، لأنّ هذا، يساعد على نموّه ونضوجه وحقّه الطبيعيّ، بأن يكون له أمٌّ وأبٌ يتحابان “إنّ كلاًّ من الرّجل والمرأة، الأب والأمّ، يساهم في حبّ الله الخالق ويترجمه”. فهما يُظهران لأطفالهما الوجه الأموميّ والوجه الأبويّ للربّ ]…[ فإن غاب أحدهما، لسبب لا مفرّ منه، فمن الضروريّ البحث عن طريقة ما للتعويض، بغية توفير النضج الملائم للطفل”.[6] يتطرّق الإرشاد إلى ضرورة وجود الأمّ، بحياة الولد وعلى جميع الأصعدة. فالمرأة بصفاتها وقدراتها الأنثويّة – لاسيّما الأمومة – تُسهم في بناء الشخص البشريّ باهتمامها وحضورها وتفاعلها، لاسيّما مع فلذة كبدها. من هنا، ومن المستحسن أن لا يُبعدها عملها المهنيّ، عن واجبها الأوّل، وهو حضورها لولدها، وتربيته بشكل سليم وصحيح، مبنيّ على الحنان والعاطفة ومحبّة الآخر والله. إنّها كتلة محبّة وحنان، وبذلك تنقل القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة، وتربّي على الحبّ والإيمان، من خلال الممارسات التقوية، وعيش الأسرار المقدّسة. ” إنّ مجتمعًا بدون أمّهات هو مجتمعٌ لا إنسانيّ ]…[ دون الأمّهات لا نفتقد المؤمنين الجدد وحسب، بل الإيمان أيضًا يفتقد جزءًا كبيرًا من حرارته البسيطة والعميقة”.[7]
تساهم شخصيّة وطباع ودور كلّ من الأمّ والأب، في تكوين شخصيّة الولد وطباعه، كما تؤثّر بهويته المستقبليّة. من هنا، التركيز على المساحة التفاعليّة، بين الأهل والولد، من أجل تعزيز الثقة بذاته وبأهله، لبناء مستقبل زاهر، أي بناء شخصيّة متوازنة، تحمل في طيّاتها المبادئ الصحيحة، والقيم السليمة، والشهادة للحقّ وللإيمان.
رأينا بأنّ الإرشاد، حضّ على حضور الأمّ في حياة الولد، ولكنّه أيضًا أصرّ على حضور الأبّ وسلطته الأبويّة، التي تعطي دفعًا للولد، نحو “الاستقلاليّة” و”بناء الشخصيّة”، كما تزيده عزمًا على اكتساب الفضائل، من أجل التحضير، للانطلاق نحو تركيبة المجتمع ومكوّناته: المدرسة، الجامعة، العمل المهنيّ، الحركات الاجتماعيّة والرسوليّة. إنّ تلك العلاقة بين الأب والولد، المبنيّة على المحبّة والثقة وإعطاء المَثَل والشهادة للحقيقة، بالرغم من تحوّلات العصرتبقى علاقة ضروريّة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها. فحضور الأب أساسيّ في توجيه الولد نحو الحياة، نحو الإيمان بالله، واحترام الآخر. بالتأكيد، تمّر هذه المرحلة (كما مع حضور الأمّ) بصعوبات جمّة، وعدم فهم، وتعترضها مشكلات عميقة، تؤدّي أحيانًا إلى أضرار جسيمة، في شخصيّة الولد. “فليس من الصحيّ تبديل الأدوار بين الآباء والأبناء: هذا الأمر يضرّ بعمليّة نضوج الأطفال، الذين هم بحاجة إليها ويحرمهم من حبٍّ قادر على توجيههم ومساعدتهم على النضوج”.[8]
- خصوبة موسعة
رأينا آنفًا، بأنّ من ثمار الحبّ، استقبال حياة جديدة، أي الخصوبة التي تنتج عن لقاء الحبّ بين الرّجل والمرأة من خلال سرّ الزواج المقدَّس والمقدِّس. بالتأكيد أدّت الأوضاع الاقتصاديّة المترديّة والأزمات الاجتماعيّة المتعثّرة والتغييرات العلائقيّة، إلى إحجام الأب والأمّ (الرّجل والمرأة) عن الإنجاب (وممارسة الإجهاض)، أي تحديد النسل. كيف يُسهم المجتمع في مساندة العائلات؟ وما هو دوره في تشجيعه على الإنجاب؟ بالتأكيد، على المجتمع اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الاهتمام بتفعيل الخصوبة، أي الإنجاب وحتى التبنّي، من خلال وسائل وطرق وتقديمات، كما التصدّي للإجهاض.
يتطرّق الإرشاد إلى الخصوبة التي تجمع الرّجل والمرأة ضمن الحياة المشتركة ولا سيّما العائليّة، التي تتبنى رعاية أولاد الحياة وأبناء الله. ويذكّر بأنّ “العديد من الأزواج ليس باستطاعتهم أن ينجبوا أطفالاً ]…[ فالزواج لم يؤسّس لإنجاب البنين فقط ]…[. لذلك حتى وإن لم يُرزق الزوجان أولادًا، رغم رغبتهما الشديدة فيهم، يبقى الزواج، كجماعة وشركة مدى الحياة، يحتفظ بقيمته وعدم انفصامه. بالإضافة إلى ذلك، الأمومة ليست حصريًّا واقعًا بيولوجيًّا، بل يعبّر عنها بطرق مختلفة”.[9] أمام هذا الواقع، يشجّع الإرشاد على خيار التبني الذي يعتبره فعل حبّ. إنّ قيمة عمل التبني يقوم على استقبال إنسان بطريقة غير مشروطة وبمجانيّة. يقول الإرشاد بهذا الخصوص “إنّ خيار التبني واحتضان طفل، يمثّل نوعًا خاصًّا من الخصوبة في الخبرة الزوجيّة، يتخطّى حالات المعاناة بسبب العقم ]…[ يُظهر التبني والاحتضان المفهومين بشكل صحيح، بُعدًا مهمًّا للأبوّة البنوّة، إذ يساعدان بالفعل على الإدراك بأنّ الأولاد، سواءً كانوا طبيعيين من ولادة بيولوجيّة أم متبنين أم محتضنين، هُم كائنات قائمة بذاتها، ينبغي استقبالهم ومحبّتهم والاعتناء بهم، وليس فقط إنجابهم”.[10] ومن أجل مصلحة الأولاد وكرامتهم ونموّهم، ينبغي منع الاتّجار بهم، كما المحافظة على الإجراءات القانونيّة لعمليّة التبني وما ينتج عنها.
إنّ الإنجاب أو التبني هما من إحدى ثمار الحبّ، ولكن تبقى العائلة أيضًا مكانًا لعيش المحبّة بين أفرادها كما مع سائر مكوّنات المجتمع. فإنّها تحمل حياة المجتمع إلى داخلها، كما تنقل الحياة العائليّة إلى المجتمع. فهي تتكامل وتتكافل مع الحياة الاجتماعيّة وما ينتج عنها. لذا عليها أن تحمل المحبّة وتعيشها، وهذا مردّه إلى عيش الحبّ بين الأب والأمّ، بطريقة ناجحة ومثمرة. وهذا كلّه يؤدي إلى انسجامٍ بين أفراد العائلة. كما يؤثّر إيجابًا في خلق مناخات مواتية لعيش الرحمة والاهتمام بالآخرين، لا سيّما المجروحين في حياتهم اليوميّة “إنّ الزوجين اللذين يختبران قوّة الحبّ، يعلمان تمامًا أنّ هذا الحبّ مدعو لتضميد جراح المنبوذين، وإرساء ثقافة اللقاء، والنضال من أجل العدالة. فالله قد عهد إلى العائلة بمشروع جعل العالم عالمًا عائليًّا”.[11] تعطي الروح العائليّة دفعًا مهمًّا لعيش القيم وتطبيقها. فتلك الروح، تُحدث تغييرًا جذريًّا في توضيح المبادئ والتمسّك بتعاليم الله، من خلال تقبّل الإيمان والتبشير بالإنجيل، وذلك بنسج علاقات مميّزة مع سائر مكوّنات المجتمع، لا سيّما المظلومين والمحتقرين والمهمّشين، والفقراء والمجروحين والمحتاجين إلى شتّى أنواع الاحتياجات “كلّ ما عملتموه لأحد أخوتي هؤلاء الصغار، فلي عملتموه” (متى 25: 40)
تظهر جليًّا للعلن إحدى ثمار الحبّ، ألا وهي الشهادة للحبّ والمحبّة، المتجليّة في فرح الزواج، والعائلة، كما تنقل الكلمة للآخرين، وذلك بتطبيق تعاليم الإنجيل. إنّ حضور الروح القدس وعمله، ضمن حياة الثنائي، يؤكّد بأنّ الحبّ الناضج والعميق، يشارك الآخرين بثماره، كما الله شارك الإنسان، بثمار حبّه “إنّ خصوبتهم تتوسّع وتترجم بألف طريقة لتجعل محبّة الله حاضرة في المجتمع”.[12]
يركّز الإرشاد على حقيقة المشاركة في الإفخارستيّا، التي تجمع وتوحّد، وتخلق التعاضد، والحسّ الإنسانيّ المسيحيّ، تجاه المتشاركين بوليمة الربّ، والتي تحثّ على عمل الرّحمة، والمحبّة والرأفة، تجاه الأخوة، ومن بينهم المحتاجين، إلى التعزية والمرافقة، والتشجيع، والإصغاء، والدعم المعنويّ والماديّ، وأكثر المتعطشين إلى الحياة الروحيّة، والبعيدين عن محبّة الربّ يسوع وحنانه. فالإفخارستيّا نداءٌ للعائلة للانفتاح على الآخرين، وعدم الانغلاق على ذاتها خوفًا من مواجهة التحدّيات، ومتطلبات الحياة المسيحيّة، بل عليها تحقيق مشروع الله للإنسان وتثبيت معنى الإنسانيّة ومفهومها. “… العائلات التي تتغذّى على الإفخارستيّا بتحضير لائق، فهي تقوّي رغبتها في الأخوّة، وحسّها الاجتماعيّ، والتزاماتها تجاه المحتاجين”.[13]
يتوجّه الإرشاد إلى الثنائي والعائلة، بمشاركة الحياة في العائلة الموسّعة، التي تضمّ الجدود، والأعمام والأخوال وأبنائهم، وأيضًا الجيران. وشدّد إلى عدم “الانغلاق داخل عشٍ آمن واعتبار الآخرين كخطرٍ مقلق. بأيّ حال، هذه العزلة لا تقدّم المزيد من السّلام والسّعادة، إنّما تُغلق قلب العائلة وتحرمها من اتّساع أفق الوجود”.[14] ويتابع الإرشاد تذكيره بأنّ الجميع هم أبناء الله. ومن هذا المنطلق، على أفراد العائلة الموسّعة، عدم التنكّر لحقيقة البنوّة، بل اعتبار الجميع أبناء “وهذا يقودنا دائمًا إلى حقيقة أنّنا لم نمنح الحياة لأنفسنا إنّما تلقيناها”.[15] بالتأكيد، إنّ الروابط العائليّة، التي تحت مظلتها، يجتمع الأفراد، من أجل تحقيق أهداف سامية، تطاول الشأن العام والخير العام للمجتمع، وضمان واستمراريّة الحياة، التي رسمها الله لأبنائه، بالعيش في وحدة وتضامن وأخوّة. كما هو حقّقها بإرسال ابنه مخلّص البشريّة. “يعتبر الرابط الخُلقي بين الأجيال هو ضمانة للمستقبل، وهو ضمانة لتاريخ بالحقيقة إنسانيّ. فمجتمع أبناء لا يكون فيه الوالدين هو مجتمع بدون كرامة ]…[ مجتمع مُقدّرٌ له أن يمتلئ بشباب متفرّدين وجشعين”.[16]
لا ينسى الإرشاد، بنظرته إلى الخصوبة الموسّعة، دور المسنّين وأهميّة وجودهم وحضورهم في العائلة. كما يعدو إلى الاهتمام بهم، لا سيّما لأنّهم، يساهمون في تربية الأحفاد، ونقل القيم الكبيرة، والتنشئة على الحياة المسيحيّة. لذا يجب الاهتمام بهم، وتقديم الاحترام والتقدير لأعمالهم السابقة وخياراتهم للمبادئ الصحيحة، والقيم، التي تبني الأفراد، والمجتمعات والأوطان. إنّهم، كنز، وفرحة، وذخيرة، ويجب المحافظة عليهم، بتقديم المساعدة والإحاطة، والمرافقة، لا سيّما المرضى، والمُشرفون على تسليم الوديعة للآب الخالق. “إنّ الاهتمام بالمسنّين هو الذي يصنع اختلاف حضارة عن الأخرى، فهل هناك اهتمام بالمسنين في الحضارة؟ وهل هناك مكان للمسنّ؟ بوسع تلك الحضارة أن تتقدّم إذا عرفت أن تحترم حكمة ومعرفة المسنّين”.[17]
نعم، يلفت الإرشاد انتباه المؤمنين بيسوع المسيح، بأن يكونوا إخوة، لا سيّما الذين ضمن العائلة الواحدة، أي المنبثقة من رابط الدّم والنسل. تُعاش الأخوّة أوّلاً بين الإخوة، ضمن عائلة متضامنة ومتّحدة، في سبيل تحقيق دعوتها. يكتسب الإخوة، صفة الأخوّة، من خلال ممارستهم لإيمانهم، واهتمامهم بعضهم البعض، بروح الإنجيل المنادي بالمحبّة، والخدمة المجانيّة، والحضور الفعّال، من أجل تقديس “كنيستهم البيتيّة”. “ففي العائلة، وبين الإخوة، يتمّ تعلّم العيش الإنسانيّ ]…[ وربما لا نتنبه غالبًا بأنّ العائلة هي بالتحديد التي تُدخل الأخوّة إلى العالم: فمن خلال هذه التجربة الأولى من الأخوّة، والتي تغذّت بالعاطفة والتعليم العائليّ وبنمط الإخوّة، يسطع مثل وعد جميل على المجتمع بأكمله”.[18]
أخيرًا، يدعو الإرشاد، إلى عيش تلك الحالة، بقلبٍ كبير، أي بانضمام الأصدقاء والعائلات الصديقة إلى منظومة التعاون والتعاضد في أوقات الشدّة، معبّرين عن ذلك، بالتزامهم الإيمانيّ، والإنسانيّ، والاجتماعيّ، “بقضايا” الحياة، والمجتمع والوطن. فالعائلة الموسّعة لا يمكن نسيانها أو تجاهلها، بل يجب أن تكون مشاركة وحاضرة في فكر وقلب الدائرة الصغيرة التي يشكّلها الأزواج وأبناؤهم، لأنّ “الحبّ بين الرّجل والمرأة في الزواج، وبالتالي بشكل موسع الحبّ ما بين أفراد العائلة الواحدة – بين الأهل والأبناء، الإخوة والأخوات، وبين الأقارب والأصدقاء- هما مفعمان ومدفوعان بديناميّة داخليّة مستمرّة، تقود العائلة إلى شركة دائمًا أكثر عمقًا وأكثر قوّة، تمثّل أساس وروح الحياة الزوجيّة والعائليّة”.[19] يذكّر الإرشاد أيضًا، العائلة الموسّعة، أن تهتمّ وتستقبل وترافق، جميع الأشخاص، الذين هم بحاجة إلى مساعدة وعضد وتشجيع، من أجل إحاطتهم، وتأمين المناخات الملائمة، لعيش دعوتهم وتحقيقها، والعمل على الحصول على الخلاص، بالرغم من العوائق والحواجز (والتي غالبًا لا تكون نابعة من مسؤوليتهم، إنّما لأسباب خارجة عن إرادتهم) على جميع الصُّعُد، التي تعترض مسيرتهم.
يطلب الإرشاد الاهتمام بالأمّهات العازبات، والنساء الوحيدات، والأطفال دون آباء، والأشخاص العازبين والمنفصلين أو الأرامل، والمرضى، والمسنّين، والشباب الذين يكافحون الإدمان، وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يحثّ على الاهتمام بأقرباء الزوج (الحماة والحمو) لأنّ “طبيعة الاتّحاد الزوجيّ تتطلّب احترام تقاليدهم وعاداتهم، ومحاولة فهم لغّتهم، والحدّ من الانتقادات، ورعايتهم، وإدخالهم بطريقة ما في القلب، حتى أيضًا عندما يتوجّب الحفاظ على الاستقلاليّة الشرعيّة والعلاقة الحميمة بين الزوجين. تُعتبر هذه التصرّفات طريقة جميلة تعبّر للشريك عن سخاء هبة الذات المُفعمة بالحبّ”.[20]
- فرح الحبّ لا ينضب
يُدخل فرح الحبّ الرّجل والمرأة في حالة من الاستقرار والنمّو والسير نحو القداسة. يكتمل الحبّ في سرّ الزواج؛ فيعطي ثمارًا مرئيّةً وملموسةً. من هنا ندرك، بأنّ الحبّ هو قرار، أي يُبنى من خلال إرادة ناضجة وقويّة، أي بفعل حرٍّ ووعيٍ كامل. بالمطلق، يحبّ الإنسان لأنّه أراد أن يحبّ. ينطلق الرّجل والمرأة ليعيشا معًا، بالرغم ما يصادفا في مسيرتهما، وهذا يؤكّد على أهميّة وقوّة إرادتهما في استمراريّة الحياة المشتركة. فالاستمراريّة أو الديمومة، التي تعبّرعن الصمود والصبر، تحتضن الحبّ وينتج عنه ثمارًا مكلّلةً بالأمانة. ومن ثمار الحبّ، الإخصاب، لأنّه من طبيعة الحبّ العميقة، الذي يهب الرّجل والمرأة ذاتهما الواحد للآخر، هبةً كاملة وتامة محقّقين بذلك وحدةً عميقة وغنيّة. إنّ المرأة والرّجل من خلال حبّهما وعلاقتهما الوطيدة، يرغبان وينتظران ويبحثان عن ثمرة حبّهما، ثمرة حياةٍ نابعة منهما، شبيهة بهما، على صورتهما (صورة الله الخالق).
وهذا يؤكّد، بأنّهما “مشاركين” و”خالقين” بعمليّة الخلق، الذي وهبها الله لهما. نعم، إنّ الحبّ بتكوينه يتوق نحو الخلق، لأنّه يريد أن يشارك وينتشر ويمتدّ. يحتاج الطفل إلى حنان وعاطفة أمّه وأبيه وحضنهما، الذين يعيشان الحبّ بكلّ أبعاده في مناخ سلام ومطمئِن ومستقرّ. فهو يحتاج إلى أسرة متّحدة ومنسجمة أي ناجحة.
إنّ فرح الحبّ لا ينضب، لا سيّما عندما تتأمّن له جميع المقوّمات، ويعاش بطريقة صحيحة وسليمة. فمن مظاهر الحبّ التّضحية، أي إعطاء الذات وبذلها من أجل الشريك “ليس أعظم من أن يَبذل الإنسان حياته من أجل مَن يحبّ”. بالمطلق، الحبّ هو عطاءٌ وتقدمة، على صورة حبّ الله الذي يبذل ذاته. نعم، إنّ الحبّ بين الرّجل والمرأة، يتجلّى بوهب الذات للآخر، وهذا تعبيرٌ عن الفرح الأعظم والسعادة العظمى، لأنّ السعادة تكمن في العطاء أكثر منها بالأخذ.”الإنسان الذي يغمره الحبّ يترفّع عن أنانيّته، فلا يعود يطمح إلى الأخذ بل إلى العطاء وربما بلغ به هذا التفاني إلى بذل الذات في سبيل محبوبه. فالعطاء والأخذ هما عنصران مهمّان وأساسيّان في الحياة العاطفيّة – الجنسيّة. فالمحبّ والمحبوب يتبادلان الإيمان المشترك فتتولّد عندهما ثقة الواحد بالآخر بشكل عميق ومميّز. ولكي يكون الحبّ – اللقاء واللقاء – الحبّ فريدين في تملّكهما، لا بدّ لهما من الوقوف على حقيقة الحبّ وجوهره، فهو الذي يهب الفرح للحبيبين، وتبدأ الحكاية. المعرفة تولّد اللقاء، واللقاء يولّد الحبّ، وبالحبّ تتعزّز الثقة، ويترسّخ الإيمان، ويدوم الالتزام. وهكذا يصبح اللقاء عهدًا”.[21]
الأب الدكتور نجيب بعقليني
أخصائي في راعويّة الزواج والعائلة
وكالة زينيت