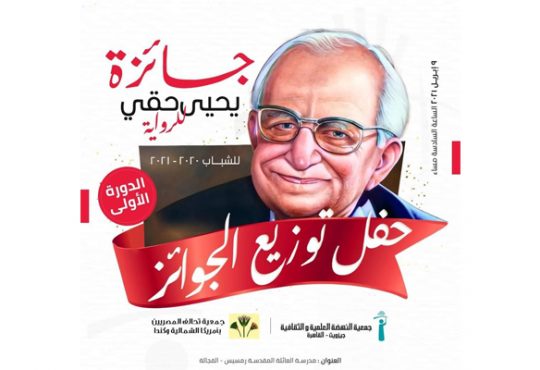سر دعوة الشركة مع الله ومع الإنسان-الأب أندراوس فهمي

 سر دعوة الشركة مع الله ومع الإنسان
سر دعوة الشركة مع الله ومع الإنسان
الأب د. أندراوس فهمي
مقدمة
لقد عرضنا في مقالنا السابق، المناهج المختلفة لدراسة موضوعات اللاهوت الأخلاقي الخاصّ، وفضّلنا أن نتّبع منهج “الوصايا” كقائد وموجّه للموضوعات التي سنختارها. فنؤكّد أن دراسة الموضوعات الأخلاقية لا تأخذ أهميتها من النموذج الذي ندرسها به، ولكن بالأحرى بمدى استعدادنا لفهم الشرح الذي يقدّمه النموذج المعين، أي استيعاب ما قصدته السلطة الكنسية من طرح التعاليم الأخلاقية المسيحية، وأن يصل المؤمن إلى ملء حياته، أن يكون قادرًا على إدراك الشركة مع الله والآخرين.
ثلاثة أهداف يجب تحقيقها
نحاول هنا إظهار الأهداف المرجوة من دراسة الأخلاق المسيحية بشكل مركّز، والتي تحثّ القارئ لينتبه إليها عند الخوض في تفاصيلهم.
أولاً: يشرح علم اللاهوت الأخلاقيّ، الذي تقترحه الكنيسة الكاثوليكيّة، ويفسّر جيدًا دعوة الإنسان (رجل وامرأة) ويساعد على فهم هذه الدعوة وتحقيقها.
إن المتطلبات الأخلاقيّة والسلوكيات التي تطلبها الكنيسة من المؤمنين ليست شيئًا إضافيًا أو ثانويًا، كما أنها ليست مفروضة من خارج الإنسان (من المجتمع أو الأسرة أو المربيين…)، بل تُولد من دعوة الإنسان الشخصية، فالإنسان بطبيعته كائن أخلاقي، أي أنّه قادر على التعقّل والسلوك. ولذلك فالوصايا العشر ليست غريبة عن طبيعة الإنسان، فهو يحملها في جوهره، وتشكّل جزءًا أساسيًا من طبيعته. وحتى نتأكّد من ذلك، فنحن نعرف إن هناك اختلافًا كبيرًا بين الإنسان والحيوان، فبالإضافة إلى الفكرة التقليدية التي تميّز الإنسان عن الحيوان بأنه عاقل واجتماعي، فهو أيضًا كائن له سلوك أخلاقي. فيوجّه الإنسان حياته بحسب متطلبات أخلاقية، أمّا الحيوان فهو غالبًا مدفوع من الغريزة، وفي ذلك يقول لنا أرسطو في كتابه “السياسة”، الجزء الأول: “الإنسان هو أفضل الحيوانات عندما يحيا بحسب الأخلاق، وهو أسوأ منها عندما يترك نفسه منقادًا لغريزته”[1].
ينطلق لاهوت الأخلاق من حقيقة هامّة: وهي أن الله قد ثبّت وأكّد منذ البدء على أن يسلك الإنسان بصورة أخلاقية، ولذلك فقد عاقب آدم وحواء عندما أكلا من “شجرة معرفة الخير والشر” (تك 1:3-5)، وهذا لأنه لم يكن من حقهما، فهي ليست ملكًا لهما بمجرد أن أوصاهما الله ألا يأكلا منها، فهما لم يسلكا بصورة أخلاقية مناسبة. وكما هو ملاحظ في هذا النصّ الكتابيّ (تك1:3-5) أن الله لم يُرغم ولم يضغط أو يتحكم في سلوك الإنسان، فقد ترك له مجالاً للحرية. ولأنّه الخالق، ووحده يعرف ما هو خير وما هو شر، فقد حذرهما “لا تأكلا من ثمرة الشجرة ولا تمساه لئلا تموتا” (تك3:3). أي أنه وضع لهما المبدأ الشهير في تعليم الكنيسة الكاثوليكية والمشترك بين البشر جميعًا، وهو “اصنع الخير وامتنع عن فعل الشر” “Buonum Facendo, malum evitando”.
فيصيب عمل الشر الإنسان بالسوء، ويساعد صنع الخير على حياة أفضل، وتحقيق لكيان الفرد. وكما لاحظنا أيضًا في هذا النصّ الكتابي، أن الله يقوم بتقديم المعرفة للإنسان، وهذا ما تقوم به الأخلاق أيضًا، فتحاول أن تضع المسيحي في “حالة المعرفة”، أي تجعله يتعرّف على الحالات والمواقف التي فيها عليه أن يصنع الخير، وعلى تلك المواقف والظروف التي فيها يجب أن يمتنع عن فعل الشر.
يحاول علم اللاهوت هنا أن يساعد الشخص على النمو، والوصول إلى حالة الكمال المرغوبة، وعلى تمجيد الله، ومن ثم إدراك السعادة الأبدية بمعونة الله. وفي الوقت ذاته، فهو يؤكّد للإنسان أنّه عندما يقترف الخطيئة يدمّر نفسه، ويمزّق وحدته الداخلية.
ثانيًا: علم اللاهوت الأخلاقي يعلّمنا أن السلوك الأخلاقي يجعل علاقة الإنسان بالله علاقة صداقة.
يعطي السلوك الأخلاقي الجيد للرجل والمرأة، إمكانية الحياة في شركة مع الله، لأن فيه يجدان أصلهما، بل ويتوجّهان إليه كهدف لحياتهما، ومن خلال هذه الشركة يكتشفان أنّهما أبناء لله. يجعل السلوك الصالح والمستمر الشخص ثابتًا في صداقته مع الله، والعكس صحيح، فالخطيئة تُبعده عن الله. وبالعودة إلى مثال الإنسان الأول (آدم وحواء) فكلاهما كان يعيش في اتحاد بالله حتى اللحظة التي فيها اقترفا الخطيئة، فعندما ترك كل منهما ذاته لتجربة الشرير شعرا ببعدهما عنه، وكانت النتيجة أنهما رفضا الإجابة على نداء الله ولذا غطاهما الخجل.
ثالثًا: السلوك الأخلاقي الصالح يمثّل عنصرًا أساسيًا في الوصول إلى حياة شركة وسلام مع البشر.
وهذا ما نراه واضحًا في قصة الخلق والسقوط، فعندما خلق الله الكون والإنسان، تهلل آدم فرحًا عندما قدّم الله له حواء، وكان الاثنان يعيشان في سعادة في الفردوس، أمّا بعد الخطيئة فبدأ يتهم كل منهما الآخر. وذلك ما يحدث دائمًا في حياة البشر، فالشر الأخلاقي يولّد التفكّك ويتسبّب في ظهور حالة الفوضى التي كانت قبل خلق الكون.
خاتمة:
حتّى نلخّص كل ما سبق، نؤكّد أن الحياة الأخلاقية هي المجال الطبيعي الذي فيه يقوم الفرد بمحاولة الوصول إلى الكمال، تلك المحاولة التي تعني أن يعيش الشخص في علاقة حميمة مع الله، وفي سلام ووفاق مع البشر. وهذا هو ثمر حفظ وتطبيق الوصايا. فهذا النوع من الحياة يكون نتيجة طبيعية عندما يعيش الإنسان حياة الفضيلة، تلك الحياة التي تتطلب منه سلوكيات معينة يقوم بها أمام الله. ولا تقتصر هذه السلوكيات على مكان معين أو على جماعة معينة، بل هي سلوكيات تنبع أساسًا من كونها متأصلة في عمق أعماق الإنسان الذي يؤمن ويعيش إيمانه. وحتى نكون أكثر واقعية، نتذكّر أن كل ما حاولنا وصفه حتى الآن ليس نوعًا من “الأوتوبيا” أو وصفًا نظريًا لحياة مثالية غير قابلة للتحقيق الفعلي، فالخبرة تؤكّد لنا أن هناك أشخاصًا عاشوا في عالمنا بحسب الإنجيل ومتطلباته الأخلاقية، ولذا فقد تميّزت حياتهم بتناغم وسلام عميق، وعلى العكس هناك أيضًا من الفترات التي طالما سيطر فيها الشر وقلّت فيها حياة الفضيلة، ومن ثم سادت فيها الفوضى الاجتماعية والفساد.
إن ممارسة الفضائل وحفظ الوصايا هي الطريقة المُثلى للوصول إلى تكوين ضمير صالح قادر على التمييز بين الخير والشر، ومن ثم السعي وراء نوال الحياة الأبدية (الحياة في المسيح). فالحياة- بحسب الأخلاق المسيحية- هي في نهاية الأمر محاولة جادّة للوصول إلى السعادة التي يريدها الله لنا، تلك السعادة التي هي هدف الحياة الإنسانية. فقد خلق الله الإنسان لهذا الهدف، ومن ثم فإن ثمر هذه السعادة يكمن في الحياة بوفاق وسلام مع الآخرين من خلال السلوكيات الصالحة:
“إنّ السعادة الموعودة تضعنا أمام خيارات أخلاقية حاسمة. فهي تدعونا إلى تنقية قلبنا من الغرائز الشريرة، والتماس محبة الله فوق كل شيء. وهي تعلّمنا أن السعادة الحقيقية ليست في الغنى أو الرفاهية أو المجد البشري أو السلطة، وليست في أي عمل بشري مهما كان مفيدًا، مثل العلوم والتقنيات والفنون، وليست في أيّة خليقة، وإنّما هي في الله وحده ينبوع كل خير وكل حب”[2]
—————————————
[1] Aristotele, Politica-I, 1, 20, 1253 a.
[2] كتاب “التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية”، رقم 1723.