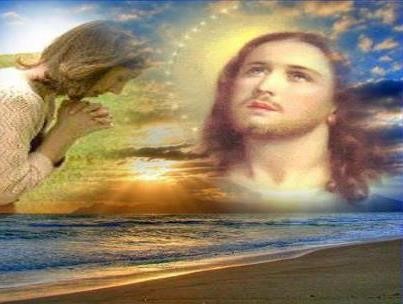سلسلة تأملات بحسب الطقس اللاتيني- الأب داني قريو السالسي

أنا وإله الأنا، أم أنا ولله؟ تأمل لإنجيل الأحد حسب الطقس اللاتيني Lc 18, 9-14
الأب داني قريو السالسي
إنَّ إنجيل هذا الأحد يقدم لنا كلمتين، اسلوبين من الصلاة والايمان. وهو تتمة إنجبل الأحد السابق (مثل الارملة والقاضي الظالم الذي أنصفها)، ليقول لنا أنَّه على الإنسان أن يتقدم في مسيرة صلاته وإيمانه. هاتين الكلمتين تلخصان حياة ناجحة وسعيدة أو حياة فاشلة وتعيسة. فمثل اليوم يقول لنا: “صعد رجلان إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشار”. الشخصية الأولى: هي من فئة الفريسين. وكلمة فريسي تعني المفصول عن الشعب، المميز، الطاهر، النقي. حتى أنَّ البعض منهم لا يقبل ان يصفاح بقية الناس كي يظل طاهراً، لا يريد أن يتدنس من الشعب العادي. هو إنسان متفرغ لدراسة الكتب المقدسة وتفسيرها. بالتالي إنسان صالح في نظر المجتمع. الشخصية الثانية: هي من فئة العشارين. العشار هو محصل الضرائب، من كان يجمع الضرائب، من أبناء دينه ليسلمها للمحتل. هو موظف عند الرومان (خائن)، يقبل الرشاوي (مرتشي، غير أمين)، كثير من الأحيان كان يأخذ بقية الضريبة وضعها في جيبه متذرعاً بعدم وجود (ترجيعة، فكة، الحساب 98،5 يأخذ مئة) بالتالي إنسان خاطئ في نظر المجتمع.
فريسي المثل، يظن أنَّه على صواب مئة في المئة، لكنه في الحقيقة يخفي العشار الذي في داخله. يبدأ بصلاة جمفي يدين، يشعر أنَّه على حق، فهو مكمل لواجباته، يقوم بما تقتضيه الشريهة 100%، لكن للأسف لا يعرف حقيقته 100% فهو يخفي العشار الذي بداخله. يبدأ صلاته بشكل جميل جداً “اللهمَّ، شكراً لك” ولكن ينتهي بشكل تعيس جداً جداً جداً. لأن مرجعية الصلاة ليس لله، إنما له، ولللآخرين. “إني لست كسائر الناس السراقين الظالمين الفاسقين، ولا مثل هذا العشَّار! فأنا أصوم مرتين في الأسيوع وأؤدي عُشر ما أقتني” وكأنه يقول: انظروا لي، انظروا إلى الأعمال الخيرة التي أعملها أنا، لا أحد يعمل مثلي، فأنا لست بلص كسائر الناس (يتهم كل الناس، هل فعلاً سائر الناس سراقين، ظالمين، زناة؟!) فأنا انسانٌ عادل، أمين، محافظ … لست منافق ولست ظالم ولست ولست… يقارن ذاته بالآخرين.
آه كم المرات كانت صلاتنا مقارنة بمن حولنا! فكثير من المرات نميل لأن نطلق أحكاماً على الآخرين إن لم تكن عبوننا موجهة لله. إن الكاهن الصالح، أو الأب الصالح، أو المربي الصالح هو مَن يحاول أن يرفع نظر أبنائه ليقارن نفسه بما قاله وعمله يسوع، وليس بأبناء عصره. كم المرات يتشجاحر الأولاد مع ذويهم لأنهم قائلين: لماذا صديقي لديه كذا وكذا، وانا ليس لدي؟ لماذا تشترون لأخي الذي يريده وانا لا؟ لماذا ابن جارنا لديه … وانا لا؟ وقس على ذلك من قبل الاولاد لذويهم أو الزوجة لزوجها، او المظف لرب العمل، او الشعب لحكومته… اسمعوا كيف يصلي، “فانتصب الفريسي قائماً يصلي” واقف أمام الله، لكن لا يخاطب الله، لا يصلي لإلهه، انما يخاطب نفسه، يصلي لأناه الخاص، لأله الأنا الذي شكّله. يرى نفسه، فلا يطلب شيئاً من الله، فقط يقدم الآخر لله، (هذا الآخر الذي هو بنظره سارق، ظالم، فاسق). كم من المرات يتهم الأولاد ذويهم قائلين: لمذا تعمل لأخي ولي لا؟ لماذا طلبات أختي مسوعو وطلباتي لا؟ ينظرون للآخر ولا ينظرون لمحبة ذويهم لهم، منحصرون بالمقارنة، لا بكتشفون نوع المحبة، نوع العطية المختلفة والمميزة التي يقدمها الأهل لابنائهم.
إنّ الفريسي يقدم لله كشف حساب عن ذاته، تقريراً كتبه عن ذاته، قائلاً: انظر انا لا أخطئ! الخطر الكبير عندما نكون في حضرة الله ولا نشعر بوجوده، أمام الله ونخاطب أنفسنا. هكذا تصبح صلاتنا مونولوج وليس حوار. الصلاة الحقيقة، هي هذا الحوار، هذا الشعور بأني قائمٌ في حضرة الله، أخاطبه أناجيه، يايسوع إن كنت مكاني في هذا الموقف كيف كنت ستتصرف؟ امام هذه المشكلة، ماذ ستفعل؟ امام تصرفات ابني المراهق، كيف كنت ستوجهه؟ مع زميلي في العمل الذي يغار مني لأني ناجح، كيف كنت تعامله؟ أما العشار، كان يعلم أنه خاظئ، انه عميل للرومان، انه مرتشٍ … بالتالي كان واعٍ لإثمه. لكن أمام الله لم يقل: الكل يعمل هكذا، وانا واحد منها! لم يقل الحياة صعبة، إذا لا أعمل هذا سأموت جوعاً! لم يقل لماذا تنظر هناك الكثير والكثير أسوء مني، لماذا تنظر إلي أنا الذي اختلس القليل؟ إن هذا العشار لم يجرأ أن يرفع ناظريه إلى الأعلى، لم يبرر نفسه، ولم يدن أحداً، أنما قرع صدره. دخل إلى عمق أعماقه، دخل إلى حميميته الخاص، فعرف نفسه، أدرك مقدار إثمه. فنطق، أجمل صلاة “اللهمَّ، ارحمني، انا الخاظئ!” اللهمَّ، أشفق علي أنا البائس! اللهمَّ، أعطني سلامك! اللهمَّ، أعطني صبرك! اللهمَّ، أعطني محبتك! اللهمَّ أعطني نعمتك، فأنا لا شيء من دونها! الفريسي لم يطلب شيء، لأن أناه طغى وتضخم حتى أعماه، العشار، رغم كل شيء، فإيمانه لم يتزعزع بإلهه، إله الرحمة، إله الشفقة.، فلنجعل هذه الصلاة، صلاتنا لهذا الأسبوع “اللهمَّ، ارحمني، انا الخاظئ!” وأقول لكم “إنَّ هذا نزل إلى بيته مبروراً، وأما ذاك فلا”. فلننزل نحن أيضاً إلى بيوتنا مبررين مسرورين، وقد غمرتنا نعمته الخلّاقة
——————-
تلاقي النظرات… وانبعاث فرح جديد!
الأب داني قريو السالسي
إنَّ إنجيل اليوم يبين لنا طريقة جديدة، أسلوباً مميزاً لمعالجة الخطيئة, طريقة فريدة بإمكانها أن تليّن الصخر. ألا وهي نظرة الثقة، نظرة المحبة، نظرة المودة.
إنَّ إنجيل هذا الأحد يقدم لنا نموذجاً رائعاً لعدم الإستسلام، منطقاً جديداً لتجاوز اليأس والكآبة، يقدم لنا مثالاً يحتذى به، يقدم لنا نموذج زكا، ليساعدنا على أن نفهم حياتنا، على أن نفهم مامعنى ان نكون تلاميذ حقيقيين للرب يسوع.
إن القديس لوقا يصف لنا ماجرى في أريحا بينما كان يسوع متجهاً إلى اورشليم. وفي تلك المدينة يلتقي برئيسٍ للعشارين. وكلنا نعلم كيف كانت سمعة العشارين (جباة الضرائب) آنذاك.
إن زكا هو من طبقة الأعيان. لأنه معروف من قبل الضباط الرومان، رئيس للعشارين أي له شأنه، غنيٌ له من الأموال ما يكفيه ويزيد. ونستطيع أن نقول أنه شخص قد وصل.
إن كوني ككاهن وكمدرس، جعلني ألتقي بأناس كثيرين منهم مَن أصبح مديراً لشركة ضخمة ومنهم مَن أصبح تاجراً مشهوراً، ومنهم مَن وصل إلى مركز مرموق في المجتمع ومنهم مَن صار مسؤولاً مهماً… ورغم كل هذا كلٌ منهم يسأل ذاته: بعد أن حققت كل هذا النجاح، ما معنى حياتي؟ وزكا واحد منهم، هذا الشخص الذي يتساءل! كوّن لكن بالغش، هو عشار، أي محصل ضرائب للرومان (في ذلك الزمان كان العشار يجمع الضرائب حسبما يشاء، لأن الرومان لم يكن لديهم الوقت للتدقيق والمراجعة، فكان يجمع ويستغل ويتلاعب بالفواتير كيفما يشاء، والمحتل كان همه أن يصل الى جيبه مبلغ كبير دون الاكتراث بالطريقة التي وصل بها). من هنا نستطيع أن ندرك كم كانت شخصية العشارين محبوبة!! بالتأكيد كانت مكروهةً جداً من قبل الجميع. لأنها كانت متعاونةً مع العدو بالإضافة إلى أنَّها شخصية مختلسه من النوع العلني. ولكن بنفس الوقت كانت لها مهابتها. لأن العشار كان يستطيع وضع أي شخص في السجن بتهة عدم دفع الضرائب أوما شابه ذلك. وزكا كان واحداً من هؤلاء الشخصيات. ليس فقط عشارا وإنما رئيساً لهم.
“فإذا رجلٌ يدعى زكّا وهو رئيس العشارين غني”
ويتابع الانجيل في وصف زكا قائلاً:
“قد جاءَ يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام، لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعاً وصعد جميزة ليراه” ملفت للنظر دقة وصف المشهد، قصير القامة. لو تخيلنا المشهد، كيف أن زكا كان يحاول أن يرى يسوع والجمع لا يدعه، تعبيراً عن كرههم له، أو كنوع من الثأر، تريد أن ترى؟ لن ندعك! أقله عِش مرة الظلم الذي ظلمتنا إياه كل هذه المدة.
كم كانت قوية عزيمته، كم كانت شديدة رغبته في رؤية يسوع. تحدى الصعاب، تحدى كلام الناس، تحدى المجتمع وصعد فوق الشجرة. صعد وبدأ يراقب، بدأ يسبر الوضع من الأعلى. وبينما هو فوق الجميزة يصل يسوع.
من أعلى الجميزة زكا ينظر يراقب يتحرى عن يسوع. وفي هذه الأثناء تحدث المفاجآة
“فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه” يسوع رفع نظره، وزكا ينظر، فتتلاقى النظرات. لقد تعود زكا على نظرات الناس، نظرات الخوف، نظرات الإدانة، نظرات السخط والغضب. أما هنا فنوع جديد من النظرات لم يختبر قط. يراه يسوع ليخطفه، ينظر إليه ليهبه نعمته، يحدق به ليمنحه حياةً جديدة، يتأمله ليهديه الخلاص. يسوع ترك الكل، ترك الجمع وتطلع إلى زكا، نظر إليه وناداه بالاسم قائلاً:
“يا زكّا انزل على عجل، فيجب عليَّ أن أقيم اليوم في بيتك” يالها من مفاجأة، شيءٌ تقشعر له الابدان! وكأننا مجتمعون بانتظار أن يعبر موكب الرئيس وعندما يعبر يتوقف الموكب وينظر إليك الرئيس قائلاً “شو رأيك تعزمني على فنجان قهوة!” شيء لا يصدّق! وهنا يسوع لا يقول سأحتسي معك فنجان القهوة وأرحل، إنما يقول سأقيم، سأبقى، سأمكث معك. زكا لا يعرف ماذا يفعل من شدة فرحه. إن الفعل اليوناني المستعمل هنا
“فنزل على عجل وأضافه مسروراً” هو الفعل المستعمل حينما تنضج الثمرة وتسقط من على الشجرة. وكأنه يقول سقط من الشجرة ليستضيفه، وكأنه يقول لم يعرف ماذا فعل فقد طار من الفرح مسرعاً لإستقباله. مندهشا من هذا الكلام، مبهورا من هذه الزيارة.
وللأسف، الشعب كعادته يبدأ بالإنتقاد بالتذمر. لكن زكا ينتصب وكأنه يقدم إعترافاً علنياً، ووعداً رسمياً
“يارب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإن كنت قد ظلمت أحداً شيئاً، أرده أربعة أضعاف” بفضل نظرة يسوع إرتدّ زكا وعاد إلى ماكان يجب عليه أن يكون. إن أسم زكّا بالعبرية يعني النقي، البار، المعطي. وهنا نجد زكّا يدخل إلى أعماق نفسه فيجد زكا الحقيقي. فيعلق يسوع قائلاً:
“اليوم حصل الخلاص لهذا البيت”.
كثيراً من المرات نظن أنَّ منطق الله نحو الإنسان هو أخطئ ثم أتوب ونتيجة توبتي يمنحني الله الغفران. أي (خطئية ß توبة ßغفران) لكن لو أمعنا النظر في أيقونة زكّا فسنجد منطقاً آخر لله. أخطئ والله يغفر لي فأتوب أي (خطئية ß غفران ß توبة).
إن يسوع لم يعرض أي شرط لمنحه الغفران. لم يقل له: إني أعرفك، إنك عشار، إن أرجعت كل ما سرقت سآتي الى بيتك. بالتأكيد زكا لن يبالي بكلام يسوع ولن يستقبله في بيته. لكن زكا فدهش، طار من الفرح، نتيجة غفران يسوع له، لم يستقبله فقط في بيته بل استقبله في قلبه، وحدثت المعجزة، حدث التغير، حصل الارتداد الحقيقي. أعطي نصف ما أملك، وإن ظلمت أحداً فسأرد أربعة أضعاف. وكأنَّه يقول سأعطي كل ما أملك وابقى على الحديدة.
إن المسيحية ليست ديانة شرائع، أو قوانين يجب تطبيقها بحذافيرها. إنَ المسيحية هي لقاء، هي لقاء مع حي، ونتيجة هذا اللقاء يحصل الارتداد، نتيجة هذا اللقاء ينبعث الفرح وتعم السعادة والسرور. هذا هو منطق الله. هذا هو اسلوب الله.
أهناك أجمل من أن نعيش لقاء يسوع مع زكا هذا الأسبوع؟ أهناك أجمل من أن نبث نظرة يسوع المملوءة ثقة ومسامحة لأخوتنا، عوضاً عن أن نحكم وندين ونطلب شروطاً وضمانات؟ أهناك أجمل من أن تفوح السعادة من خلال معاملتنا المسيحية؟ فلنعش تلاقي النظرات هذا الأسبوع، ولنسمح ليسوع بأن يعبر وينادي ويعلن الخلاص من خلالنا.
لو 19، 1-10
—————-
الأحد الثاني والثلاثون من زمن السنة العادي: رجاءٌ جديد… أنا معكم، لن أموت!
الأب داني قريو السالسي
يقدم لنا لوقا البشير هذا الأحد موضوع القيامة. إننا مهما تكلمنا عن مفهوم القيامة فليس بالأمر السهل. لأنه لم يختبرها أحدٌ قط. ممكن الحديث عن أمورٍ عديدة كالألم أو الحزن أو الفرح أو السعادة أو… لكن الكلام عن مفهوم القيامة فهو أمرٌ يصعب على العقل البشري تصديقه. حتى أنَّ بعض الرسل – كما يخبرنا القديس مرقس على لسان بطرس ويعقوب وبوحنا وهم نازلون من جبل التجلي – كانوا محتارين من هذه الكلمة: “… وأخذوا يتساءلون مامعنى القيامة من بين الأموات” لأنَّها خبرة بعيدة كلَّ البعد عن ثقافتهم ولغتهم وتصوراتهم. هذه كانت إحدى معتقدات الصدُّوقيين. “ودنا بعض الصدُّوقيين، وهم اللذين يقولون بأنّه لا قيامة”.
إن الصدُّوقيين كانوا من الطبقة الراقية المحافظة، من الطبقة الكهنوتية المرموقة، من الطبقة المثقفة من رجال الدين المفكرين. الَّذين لا يؤمنون بمفهوم القيامة من بين الأموات.
كان الصدُّوقيين يستعملون الطريقة الربينية بطرح مسألةٍ نظرية، وكثيراً من الأحيان يستخدمون موضوعاً محبكاً بطريقة شديدة التعقيد، أي موضوعاً مصطنعاً. كثيراً من الأحيان يخترعون موضوعاً عبثياً، ليصلوا إلى ما أرادوا أن يصلوا إليه. وهنا يعرضون مسألة الزواج، حيث من خلالها يؤكدون انَّه لا وجود للقيامة، أو حتى لا داعي للإيمان بهذه العقيدة. فنجدهم هنا يأتون الى يسوع ليس للتعلم او الأرتداد إنَّما للسخرية منه، لعلمهم أنَّه لامفرَّ من هذه القضية. مستشهدين بقانون الصهر كما ورد في (تثنية 25، 5-9) “إذا مات لامرئ أخٌ له امرأة وليس له ولد، فليأخذ أخوه المرأة ويقم نسلاً لأخيه”. لكن يسوع لا ينجرف مع خرافاتهم – تبهرني طريقته في الرد- حيث يبدأ بالحديث عن السماء قبل أن يبرهن عن هذا بما كتبه موسى. مبتدءاً بالمقارنة بين هنا وبين هناك، بين الأرض وبين السماء “إن الرجال من أبناء هذه الدنيا…. أما الذين وجدوا أهلاً… ” إنَّ هناك ليس كهنا. حياة السماء ليست كحياة الأرض. هناك النور ساطع من كلِ جهة، أما هنا فنحن نستنير من نور الشمس. وكما قيل في سفر الجامعة (1، 9) “لاجديد تحت الشمس” منذ بدء الأنسانية وهناك من يسرق، وإلى اليوم نجد من يسرق. الانسان سرق دائماً حتى من أقرب الناس اليه. منذ بدء الأنسانية وهناك من يقتل، وإلى اليوم نجد من يقتل. الانسان سفك الدماء دائماً. منذ بدء الأنسانية وهناك من يفعل الخير، وإلى اليوم نجد من يفعل الخير. هناك من لا يستسلم للشر ويفعل الخير دائماً. منذ بدء الأنسانية وهناك من يمرض، وإلى اليوم نجد من يمرض. المرضى موجودون دائماً. إنَّ البشر هم هم منذ بدء الإنسانية حتى اليوم، فليس من جديد تحت الشمس. أما في السماء فكلُّ شيءٍ جديد.
أبناء هذا العالم، وأبناء العالم الثاني ليسوا متشابهين أو حتى متساوين! هناك من لا يؤمن بالقيامة، أو بالحياة الأبدية، لأنه يحتج ويقول: لم يخبرني أحدٌ عن السماء، لهذا لا أؤمن!
حادثةٌ طريفةٌ حدثت مع أحد زملائي الكهنة عندما كنّا نتخصص في إيطاليا. روى لي أنَّه ألتقى بشخص في أحدِ المقاهي، ودار بينهما حديث وعندما أكتشف هذا الشخص أنّ زميلي كاهن، إبتدأ يستهزئ به ويقول: أنت متعلمٌ ومثقفٌ ومع هذا تؤمن؟! هل تظنُّ أنَّ هناك قيامة؟ فلم يرغب أن يفتح معه موضوعاً لاهوتياً عميقاً، لكن قال له: أنا أفضل أن أؤمن وأنا هنا، وإن أكتشفت بعد مماتي أنَّه لايوجد قيامة، فلن أخسر شيئاً؛ لكن إن لم أؤمنْ هنا وبعد مماتي أكتشفت أنَّه يوجد قيامة فسأخسر الكثير والكثير.
ويتابع يسوع في دحض معتقد الصدُّوقيين مستشهداً بسفر الخروج (3، 1-10) حينما عرّف الله نفسه لموسى من وسط العليقة قائلاً: “أنا الرب إله ابراهيم، وإله إسحق وإله يعقوب.”
إنَّ المقياس البشري الأرضي هو في الأخذ والإمتلاك “إذا مات لامرئ أخٌ له امرأة وليس له ولد، فليأخذ أخوه المرأة…” أما المقياس الإلهي السماوي هو في الانتماء “الرب إله ابراهيم، وإله إسحق وإله يعقوب”. كثيرٌ من الناس يفكرون أنَّ الحياة تكمن في الأخذ والإمتلاك والسيطرة. لديك قرش تساوي قرشاً لديك مليون تساوي مليوناً. للأسف كثيرٌ من الناس يسيرون على هذا المنحى. أما المنحى الذي يعرضه الرب فهو منحى آخر، إنّه منحى الإنتماء.
كم هو كبيرٌ ألم الوالدين عندما لا يشعر الأولاد بالانتماء لأسرتهم. يعيشون في البيت وكأنَّه مطعم أو فندق. يأتون إليّه فقط لسد إحتياجاتهم المادية من طعام وشراب، ليس لأنهم أبناء هذه العائلة، يدخلون ويخرجون لكن دون الاكتراث بشيء (فخار يكسر بعضو).
أذكر جيداً إحدى زياراتنا لأحد أديرة الناسكات في ضواحي تورينو، أننا ألتقينا بمعلمة الابتداء وسألتها عن كيفية معرفتها أنَّ هذه الفتاة[1] لها دعوة للحياة النسكية أم لا (لأنهنَّ يعشن حياة عزلة، حياة صلاة وتأمل) فأجابتني بكل بساطة؛ عندما تشعر الفتاة أنَّ هذا الدير هو بيتها، أي تعتني به كأنَّه جزء لايتجزأ من حياتها.
المسيحي هو الشخص المنتمي كل الأنتماء للمسيح. أي أنا جزء من المسيح، جزءٌ لا يتجزأ من المسيح القائم. جزءٌ لا يتجزأ من المنتصر على الموت على الألم على الظلم. هذا هو إيماننا.
يالهذا النور العظيم الذي يأتينا من إنجيل هذا الأحد. لا للأخذ إنما نعم للأنتماء. حياتي هي جزءٌ من حياة المسيح، حياتي هي مشاركة مع حياة المسيح. إني شريك معه في القيامة.
إنَّنا شعب مرتبط بعضه ببعض برباط المحبة. كل الخلافات وجميع النزعات بسبب نقص أواصر المحبة. كلٌّ منّا ينتمي إلى أبٍ وإلى أمٍ وهذا الرباط لن ينتهي أبداً، سيدوم ويستمر ويتغلغل في الصميم.
منطق الأخذ هو منطق السوق، لكن منطق الانتماء هو منطق البيت والعائلة. عبارة كانت ترن في ذهني عندما كنت في دمشق كان المربون يقدمون الأولاد لنا قائلين: هذا من صنع أولادي! لهذا كانت روح العائلة تشع في المركز ومن المركز. إنْ مارسنا روح الانتماء، إنْ عشنا أربطة المحبة ستصبح بيوتنا مصدر إشعاعٍ لأله ابراهيم واسحق ويعقوب. لأنه لم يكن: “إله أموات، بل إله أحياء، فهم جميعاً عنده أحياء، فأجاب بعض الكتبة: أحسنت يا معلم، ولم يجترئوا بعد ذلك أن يسألوه عن شيء”. لأن هذه هي الحقيقة الباقية، والتي كلّنا بحاجة إليها في هذه الدنيا وفي الآخرة؛ أنْ أنتمي لشخصٍ، (كم هي سعادة الفتاة عندما تربتط بحبيبها!) أنْ أنتمي لعائلةٍ! (كم من الأبناء يعيشون في أسرٍ ولكن يتألمون من التفكك الاسري وروح الامبالاة الموجودة)، أنْ أنتمي لله، أن اشعر فعلاً ومن كلِ قلبي أني الأبن الحبوب لديه، أني الأبنة المدللة عنده. إلهي وأبي.
كل يوم أحد تقام الذبيحة الإلهية في كل انحاء العالم، هل الكل يأتي ليشارك بالقداس؟! كثيرون لا يأتوا، يفضلوا النوم على المشاركة، لأنهم لا ينتمون لله، لا يشعرون بهذا اللإنتماء. إنَّ كلَّ الذين ينتمون لله يعيشون له.
كتب الأب [2]Don Oreste Benzi في مذكراته – عن عمرٍ يناهز 82 سنة – عشية مماته، قائلاً: عندما أموت، أي عندما لن أتنفس أو لن أتحرك، عندما وتبرد أطرافي ويزرق وجهي. ستقولون: إنَّه مات. أعزائي، هذه ستكون الكذبة الأكبر التي ستشاع أنذاك. لأني عندما لن أرى أحدٌ من هذا العالم، ثقوا أني في العالم الآخر، ثقوا أني بدأت أرى الله وجهاً لوجه.
سأصبح اقرب لكم…
لأني سأنتمي لله
——————-
خيبة أملٍ؛ أم رجاءٌ حي؟
الأب داني قريو السالسي
لقد أقتربنا من نهاية السنة الليتورجية : ففي الاحد المقبل سنحتفل بعيد يسوع الملك، وفيه نختتم السنة الليتورجية. ونبدأ زمن المجيء، زمن التحضير لعيد الميلاد.
إنَّ خطاب يسوع لنا هذا الأسبوع هو على غير عادته، فهذا الخطاب لا يخلو من الحزن والحسرة. يخبرنا لوقا البشير أنَّه بمجرد وصول التلاميذ إلى هيكل أورشليم، أصابتهم الدهشة من روعة بنائه ورونق نقوشه. كما يقول المؤرخ جوزيف فلافيو: أن رخام الهيكل كان مرصعاً بالذهب حيث أنَّ تألقه كان واضحاً على بعد كيلومترات. إن كلَّ من نظر إليه بُهر بالفن الهندسي والجاه المعماري، من تحف النذور وتيجان الأعمدة، من الجدران المرصعة والأسقف البهية. كان إحدى عجائب الدنيا في عصره. لهذا كان الرمز الديني الأكبر لليهود، إذ كان محط افتخارهم أمام العالم.
عند وصول التلاميذ إلى الهيكل، دهشوا من هذا العمل الفني، وكانوا يقولون: ما هذه الروعة! ما هذا الجمال! يالهذه الزخارف وهذه التحف الثمينة! إنها أحجارٌ كريمة! إنها ثروة ضخمة!
إنَّ هذا الإندهاش الذي رافق الرسل، كان يرافق أيضاً كلّ حاج وكلّ زائرٍ لهذا الهيكل. كان التلاميذ مندهشين بتواجدهم أمام هذا الصرح الضخم. وفجأة نجد أنَّ يسوع يداهم صفاءهم، يفاجئهم بإنذارٍ فظيع، بخبر مشؤوم، قائلاً لهم: “ستأتي أيّامٌ لن يُترك منهُ حجرٌ على حجر، بل يُنقضُ كلُّه”. لنضع أنفسنا مكانهم، في ذروة نشوتنا يأتي أحدهم وينذرنا بنذير شؤم! إنَّ خبر تدمير الهيكل بالنسبة إليهم هو كتدمير الفاتيكان، وكنيسة المهد والقيامة معاً. إن زوال الهيكل بالنسبة الى اليهود يعني زوال المرجعية الدينية. لأنه لم يكن فقط رمز الأيمان، إنّما أيضاً مقر سكنى الله. أي مركز الإيمان ومصدره. بالتأكيد كان هلع التلاميذ كبيراً لدى سماعهم هذا الكلام! كانوا لتوهم قد وصلوا وماكادوا يستمتعون بهذا المشهد الفتّان، واذا بهذه الصدمة تداهمهم. وما زاد الطين بلة، أنَّ يسوع تابع كلامه بخطاب طويل ومفزع، محذراً إياهم قائلاً: “ستقوم أمةٌ على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل شديدة، وأوؤئة ومجاعاتٌ كثيرة…” ماهذا الشؤم؟ كيف سيحدث هذا؟ أين الله؟ هل نسانا؟ أي ذنب أقترفنا حتى يعاقبنا بعقوبة كهذه؟
اني لا أخفي عنكم ما شعرت به أثناء قراءتي هذا المقطع الانجيلي. فللوهلة الأولى إنتابني شعورٌ بالغضب، شعرت بنوعٍ من الغم والهم. “لماذا يارب؟ لماذا كلُّ هذا؟ ألا يكفي كل ما نسمعه في نشرات الأخبار؟ ألا يكفي ما نقرأه عبر صفحات الانترنيت، من قتل وتفجير وتهجير، من حروب وكوارث، من معاهدات سرية لتلبية مآرب شخصية؟ وفي هذا الأحد نسمعك تتوجه إلينا بهذا الخطاب المظلم! لا يارب، هذا كثيرٌ علينا يارب!
كنت أناجي الله قائلاً: يارب، ماذا تريد أن أقول للناس. ما الرسالة التي تريد أن توجهها إلينا؟ هؤلاء الناس الذين هم محاطون بكل أنواع المعانات والألم والعذاب. وأنت إله التعزية تخاطبهم بهذه الكلمات الحادة! وبينما كنت في لوعتي وكربي. شعرت بنورٍ خفيفٍ يتسرب إلى قلبي وينيرني لأفهم هذه اللوحة الإنجيلية الرائعة. إنّ الرب يتوجه الينا بهذا الكلام بالذات، لأن ما يدور حولنا هو هذا بالذات، هو هذا عينه، أخبارٌ محزنة تقشعر لها الأبدان. كنيسة تتفجّر، بيوتٌ تدمر، أساقفة تؤسر، كهنة تسشهد، أبناءٌ وبنات يتيتمون، اخوة وأخوات يتشتتون ويتبعثرون في كل الأرض. نفوسٌ ضعيفة ومريضة يدمرون حياة الكثيرين… حروب هنا وهناك، إلحاد وشذوذ في الشرق والغرب، قيمٌ تنهار وأخلاق تزول وتضمحل!
بهذه النبوءة لا يقصد يسوع أن يفزعنا بل أن يطمئننا. إنَّها صفحة رجاءٍ، صفحة ينبعث منها الأمل والثقة بالنفس. صحيح ماقاله يسوع “… سيكون هناك حروبٌ… زلازل… مجاعات… أوبئة” ولكن “سأوتيكم أنا من الكلام والحكمة، ما يعجز جميع خصومكم عن دفعه أو نقضه” لا تقلقوا، لا تغتموا، لا تسمحوا للاضطراب أن يتسرب إلى نفوسكم. قال هذا لتلاميذه وهم في اورشليم، ويكرره ويقوله لنا اليوم نحن ابناء القرن الحادي والعشرين.
إنَّ الإنسان عندما يقلق، لايستطيع أن يعقّل الأمور، لايستطيع أن يفهم ويدرك الحدث بموضوعية، يشعر بأنه ضعفيف. لهذا يحاول أن يبحث عن شخص يتشبث به، عن قشةٍ يستعين بها.
إنَّ يسوع يعلم هذا جيداً، ويعرف حق المعرفة، أنَّ هناك مَن ينتظر هذه الفرصة ليقتنصها ويستغل مخاوفنا. كم من مرة أختبرنا هذه الخيانة! إثر فشلٍ في إمتحانٍ ما، نجد مَن يتهافت لإنقاذنا ثم يبدأ بالتلاعب بنا. كم من مرة أمام ضعفٍ ما نجد من يفتح كلتا ذراعيه ليحتضننا، لكن، ويا للأسف، لا محبةً لنا إنَّما تلبية لمآربه المزيفة. كم من مرة أختبرنا إلتباساً في صداقاتنا، فنجد من يسرع ليستغل هذه الالتباس لينخر فينا وينفث غيرته في آذاننا ليشوه سمعة صديقنا القديم. كم من مرة وقعنا في مشكلة عويصة فنجد أحدهم يقول: لا تهتم أنا سأتدبر الأمر، فنسلمه مشاعرنا وعواطفنا وآمالنا ونظنه المخلص المنتظر، لكن، ويا للأسف، لا نجد في النهاية سوى دموعنا تسيل وحدها. لهذا يحذرنا يسوع ويوصي بقوة “…أياكم أن يُضلَّكم أحد! فسوف يأتي كثيرٌ من الناس منتحلين أسمي…” وكأن يسوع يسلم وصيته الأخيرة قائلاً: “انتبه من رفاق السوء، احذر ممَن حولك (اوعى يضحك ع