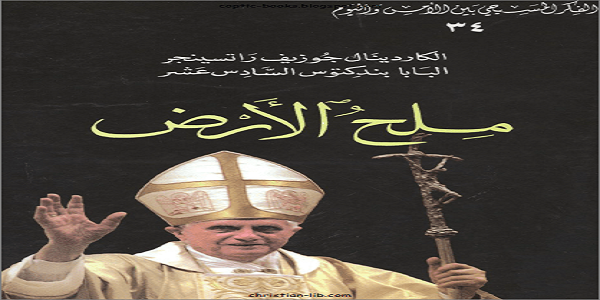عظة البابا بندكتس السادس عشر في ختام السنة الكهنوتية


أيها الإخوة الاعزاء في الخدمة الكهنوتية،
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء،
إن السنة الكهنوتية التي احتفلنا بها، بذكرى 150 سنة على وفاة خوري آرس، نموذج الخدمة الكهنوتية في عالمنا، قد آلت إلى نهايتها. لقد تركنا لخوري آرس أن يقودنا، لكي نفهم من جديد جمال الخدمة الكهنوتية. الكاهن ليس فقط حامل خدمة، مثل تلك الخدمات التي تحتاج إليها المجتمعات لكي تتم خدماتها. بل يقوم الكاهن بخدمة لا يستطيع أن يقوم بها أي كائن بشر بحد ذاته: أن يتلفظ باسم المسيح بكلمات الحلة من خطايانا ويحول بهذا الشكل، انطلاقًا من الله، حالة حياتنا. يتلفظ على الخبز والخمر بكلمات شكر المسيح التي هي كلمات التحول الجوهري – كلمات تجعله حاضرًا، هو القائم من الموت، في جسده ودمه، وتحول بهذا الشكل عناصر العالم: كلمات تشرّع العالم على الله وتوحده به. الكهنوت ليس إذًا مجرد “خدمة”، بل هو سر: الله الذي يستعين بكائن بشري فقير لكي يضحي حاضرًا من خلاله للبشر ولكي يعنى بهم. يا لشجاعة الله هذه، التي من خلالها يوكل نفسه للبشر! رغم أنه يعرف ضعفنا، يعتبر أننا كبشر نستطيع أن نتصرف وأن نكون حاضرين في مقامه – شجاعة الله هذه هي الأمر الأعظم الذي يتستر وراء كلمة “الكهنوت”.
أن يعتبرنا الله قادرين على هذا الأمر؛ أن يدعو بهذا الشكل البشر إلى خدمته وأن يرتبط بهم من الداخل: هذا هو ما أردنا اعتباره وفهمه من جديد خلال هذه السنة. لقد أردنا أن نوقظ في ذواتنا فرح أن الله هو قريب بهذا الشكل، وأن نوقظ العرفان لأنه يوكل نفسه إلى ضعفنا؛ وأنه يقودنا ويسندنا يومًا فيوم. أردنا بهذا الشكل أيضًا أن نبين من جديد للشباب أن هذه الدعوة، هذه الشركة في الخدمة من أجل الله ومع الله هي واقع حقيقي، لا بل أن الله ينتظر نَعَمنا.
مع الكنيسة أردنا من جديد أن نبين كيف أنه يترتب علينا أن نطلب هذه الدعوة إلى الله. نطلب عملة في حصاد الرب، وهذا الطلب إلى الله هو في الوقت عينه عمل الله الذي يقرع على قلب الشباب الذين يعتبرون أنهم يستطيعون أن يقوموا بما يعتبر الله أنهم يستطيعون القيام به. وكان من المتوقع ألا يروق “للعدو” هذا الإشعاع الكهنوتي الجديد؛ فهو يود أن يختفي الكهنوت، لأنه اختفاؤه سيكون كما وكأن الله قد دُفِع خارج العالم. وهذا ما حدث، في سنة الفرح هذه لأجل سر الكهنوت، ظهرت خطايا الكهنة – وخصوصًا الاعتداءات الجنسية على القاصرين، حيث ظهر عكس مهمة الكهنوت الذي يجب أن يبين عن اعتناء الله بالإنسان. يجب علينا نحن أيضًا أن نطلب الغفران إلى الله وإلى ضحايا هذه الاعتداءات، بينما نقصد أن نعد بأن نقوم بكل ما هو ممكن لكيما لا تتم هذه الاعتداءات من جديد؛ أن نعد ، في قبول المرشحين إلى الدرجات الكهنوتية وفي التنشئة خلال مسيرة الاستعداد للكهنوت، بأن نقوم بكل ما بوسعنا لكي نتأكد من أصالة الدعوة ونعد بأننا نريد أن نرافق الكهنة أكثر في مسيرتهم، لكيما يحميهم الرب من الحالات المؤلمة وأخطار الحياة.
لو كانت السنة الكهنوتية وسيلة لتمجيد عملنا البشري البحت، لكانت هذه الأحداث قد دمرته. ولكن الأمر كان عكس ذلك بالضبط: أردنا أن نضحي أكثر عرفانًا نحو هبة الله، هبة تختبئ في آنية من خزف، تجعل محبة الله ملموسة في هذا العالم من خلال كل الضعف البشري.
وهكذا نعتبر ما حدث وكأنه واجب تطهير، واجب يرافقنا نحو المستقبل، ويجعلنا نكتشف من جديد ونحب هبة الله العظيمة. بهذا الشكل، تضحي الهبة التزامًا للإجابة على شجاعة وتواضع الله من خلال شجاعتنا وتواضعنا.
إن كلمات المسيح التي رنمناها كنشيد دخول إلى الليتورجية، تستطيع أن تقول لنا في هذه الساعة ما معنى أن نضحي كهنة: “احملوا نيري عليكم وتعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب” (مت 11، 29).
نحتفل بعيد القلب الأقدس ونلقي من خلال الليتورجية، إذا جاز التعبير، نظرة داخل قلب يسوع، الذي فتحته في الموت حربة الجندي الروماني. نعم قلبه مفتوح لنا وأمامنا – ومع هذه انفتح لنا قلب الله بالذات. الليتورجية تفسر لنا لغة قلب يسوع، الذي يتحدث فوق كل شيء عن الله كراعٍ للبشر، وبهذا الشكل تبين لنا عن كهنوت المسيح، الذي هو متجذر في حميمية قلبه؛ وهكذا تبين لنا الركيزة الأزلية والمعيار الصحيح لكل خدمة كهنوتية يتوجب عليها أن تكون موطدة في قلب يسوع وأن تعاش انطلاقًا منه.
أود اليوم أن أتأمل بشكل خاص بالنصوص التي تجيب من خلال الكنيسة المصلية على كلمة الله التي تقدمها القراءات. في تلك الأناشيد تتداخل الكلمات والإجابات. من ناحية، هذه الأناشيد هي مستوحاة من كلمة الله، من ناحية أخرى، هي في الوقت عينه جواب الإنسان على تلك الكلمة، جواب تُمنح فيه الكلمة عينها وتدخل في حياتنا. أهم هذه النصوص في ليتورجية اليوم هو المزمور 23 (22) – “الرب راعيّ” – الذي قبل فيه إسرائيل المصلي كشف الله عن ذاته كراعٍ، وجعل من هذا الراعي وجهة حياته. “الرب راعي، لا يعوزني شيء”: في هذه الآية الأولى يتم التعبير عن الفرح والعرفان لأن الله حاضر ويعتني بنا. إن القراءة المستمدة من كتاب حزقيال تبدأ بالموضوع نفسه: “أنا بالذات سأبحث عن نعاجي وسأعتني بها” (حز 34، 11). الله يعتني بي، بنا وبالبشرية بشكل شخصي. لست متروكًا وشأني، ضائعًا في الكون وفي المجتمع الذي أبقى دائمًا أمامه تائهًا شاردًا. هو يعتني بي. ليس إلهًا بعيدًا، لا تعني له حياتي شيئًا. إن ديانات العالم، كما يمكننا أن نلاحظ، عرفت دومًا في المقام الاخير أن هناك إله واحد. ولكن هذا الإله بعيد. ظاهريًا يبدو وكأنه يترك العالم لسلاطين وقوى أخرى، لآلهة أخرى. ولهذا كان يجب التوصل إلى مساومة. الإله الوحيد كان صالحًا، ولكنه بعيد. لم يكن يشكل خطرًا، ولكن لم يكن عونًا أيضًا. ولذا كان من الضروري أن نعتني به. لم يكن ضابطًا للكل. الغريب أن هذا الفكر قد عاود الظهور في عصر الأنوار. كانوا يعون أن العالم يتطلب خالقًا. ولكن هذا الإله كان قد بنى العالم ومن الواضح أنه ابتعد عنه في ما بعد. للعالم الآن قوانينه التي يسير بحسبها والله لا يتدخل، لا يستطيع أن يتدخل. الله هو مجرد أصل بعيد. والكثير ربما لم يكونوا يتمنون أن يعتني الله بهم. لم يكونوا يودون أن يزعجهم الله. ولكن حيث يشعر الإنسان بأن عناية الله وحبه هما عنصر إزعاج، فهناك يتدمر الكائن البشري. من الجميل والمعزي أن نعرف أن هناك شخص يحبني ويعتني بي. ولكن أهم بكثير أن يكون موجودًا ذلك الإله الذي يعرفني، يحبني ويهتم بي. “أنا أعرف خرافي وخرافي تعرفني” (يو 10، 14): هذا ما تقوله الكنيسة قبل الإنجيل مستخدمة كلمة من كلمات الرب. الله يعرفني، يهتم بي. هذه الفكرة يجب أن تفعمنا فرحًا. لنسمح لها أن تتغلغل في صيميمنا. وعندها نفهم ماذا تعني: الله يريد من ككهنة في نقطة صغيرة من تاريخ البشرية، أن نشارك البشر همومهم. ككهنة، نريد أن نكون أشخاصًا، في شركة مع اهتمام الرب بالبشرية، أن نعتني بهم، وأن نقدم لهم خبرة ملموسة لعناية الرب بهم. وفي الإطار الموكل إليه، يجب أن يستطيع الكاهن أن يقول مع الرب: “أنا أعرف خرافي وخرافي تعرفني”. “عرف”، في الكتاب المقدس، ليس مجرد فعل معرفة خارجية، كما نعرف على سبيل المثال رقم هاتف شخص ما. “عرف” يعني” أن نكون قريبين داخليًا من الآخر. أن نحبه. يجب أن نسعى لكي “نعرف” البشر من قبل الله ولأجل الله؛ يجب علينا أن نسعى لكي نسير معهم في سبيل صداقة الله.
لنعد إلى مزمورنا. يقال فيه: “يهديني في الدرب القويم لأجل اسمه. إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءًا لأنك معي. عصاك وعكازك هما يهباني الأمان” (23 [22]، 3+). الراعي يدل على الدرب القويم أولئك الموكلين إلى عنايته. يتقدمهم ويقودهم. فلنقل الأمر بطريقة أخرى: الرب يبين لنا كيف نحقق بشكل صحيح كينونتنا البشرية. يعلمنا فن أن نكون أشخاصًا. ماذا يجب أن أفعل لكي لا أنحط، لكي لا أبذّر حياتي في فقدان المعنى؟ هذا هو بالتحديد السؤال الذي يجب أن يطرحه كل إنسان على ذاته وهو سؤال يجوز في كل فترات الحياة. وكم من الظلام يحيط بهذا السؤال في زمننا هذا! كل مرة من جديد تتوارد إلى ذهننا كلمات يسوع، الذي يحن على بشريتنا، لأنها كقطيع لا راعي له. يا رب تحنن علينا نحن أيضًا! دلنا على السبيل! نعرف من الإنجيل هذا الأمر: المسيح هو الحياة. العيش مع المسيح، اتباعه – هذا هو معنى إيجاد الدرب الصحيح، لكي تحوز حياتنا المعنى ولكي نستطيع أن نقول يومًا: “نعم، لقد كانت الحياة أمرًا جيدًا”. شعب إسرائيل كان ممتنًا لله، لأنه من خلال الوصايا دله على سبيل الحياة. المزمور الكبير 119 (118) هو تعبير فريد عن الفرح الذي يولده هذا الأمر: نحن لا نتعثر في الظلام. لقد أرشدنا الله على السبيل، وأرشدنا كيف يمكننا أن نسير بشكل صحيح. ما تقوله الوصايا يتلخص في حياة يسوع الذي صار مثالاً حيًا. هكذا نفهم أن توصيات الرب ليست قيودًا، بل هي طريق يدلنا هو عليه. يمكننا أن نفرح ونتهلل لأنها حاضرة أمامنا في المسيح كواقع معاش. فهو الذي ملأنا فرحًا. في المسيرة مع المسيح نختبر فرح القيامة، وككهنة يجب علينا أن ننقل للناس الفرح الذي يتولد من اكتشافنا للطريق المستقيم.
هناك من ثمّ كلمة تتعلق بـ “وادي ظلال الموت” التي يقود الرب من خلالها الإنسان. طريق كل واحد منا ستؤدي بنا يومًا إلى وادي ظلال الموت حيث لا يستطيع أحد أن يرافقنا. وهو سيكون هناك. يسوع بالذات قد نزل إلى وادي ظلال الموت. وهناك أيضًا هو لا يتخلى عنا. هناك أيضًا يقودنا. “إذا نزلت إلى الجحيم، فأنت هناك”، يقول المزمور 139 (138). نعم أنت حاضر في النزاع الأخير، وهكذا يستطيع مزمور القراءات أن يقول: هناك أيضًا، في الوادي المظلم، لا أخاف سوءًا. ولكن بينا نتحدث عن الوادي المظلم نستطيع أيضًا أن نفكر بأودية التجارب المظلمة، أودية تثبط العزيمة، التجارب، التي يجب على كل إنسان أن يمر فيها. حتى في هذه الأودية المظلمة في الحياة هو هناك.
نعم، يا رب، في ظلام التجربة، في ساعات الظلمة حيث تخفت كل الأضواء، اكشف لنا يا رب عن حقيقتك. ساعدنا، نحن الكهنة، لكي نستطيع أن نكون إلى جانب الأشخاص الذين أوكلتهم إلينا في هذه الليالي الحالكة. لكي نستطيع أن نبين لهم نورك.
“عصاك وعكازك هما يهباني الأمان”: يحتاج الراعي إلى العصا ضد الحيوانات البرية التي تريد أن تعتدي على القطيع؛ ضد اللصوص الذي يطلبون غنيمتهم. وإلى جانب العصا هناك العكاز الذي يسند ويساعد على تجاوز المعابر الصعبة. كلا الأمرين يدخلان في إطار خدمة الكنيسة، في الخدمة الكهنوتية. وعلى الكنيسة أيضًا أن تستعمل عصا الراعي، العصا الذي تحمي من خلالها الإيمان ضد المزورين، ضد النزعات التي هي بالواقع تشتيت. استعمال العصا يستطيع أن يكون خدمة محبة. نرى اليوم كيف أنه ليس تعبيرًا عن الحب عندما نتحمل تصرفات لا تليق بالحياة الكهنوتية. كما وأنه ليس حبًا عندما نسمح للهرطقات أن تتفشى، ونسمح للإيمان أن يضيع الهدي وأن ينحلّ، كما ولو كنا نبتكر الإيمان من تلقاء نفسنا. كما ولو لك تكن عطية من الله جوهرة الإيمان. في الوقت عينه، العصا يجب أن يضحي دومًا عكاز وسند الراعي – عكاز يساعد البشر لكي يسيروا في الدروب العسرة ويتبعوا الرب.
وأخيرًا يتحدث المزمور عن الوليمة المعدة، عن الزيت الذي يمسح فيه الرأس، عن الكأس الفائضة، عن إمكانية السكنى مع الرب. يعبر هذا الأمر في المزمور بشكل خاص عن وجهة فرح العيد النابع من سكنانا مع الرب في الهيكل، حيث نكون ضيوفه وحيث يخدمنا هو بالذات، ونستطيع أن نقيم معه. بالنسبة لنا، إذ نصلي هذا المزمور مع المسيح ومع جسده الكنيسة، بات لوجهة الرجاء هذه سعة وعمقًا أكبر. نرى في هذه الكلمات استباقًا نبويًا لسر الافخارستيا حيث يستقبلنا الرب مقدمًا ذاته لنا كطعام – مثل ذلك الخبز والخمر اللذيذين الذي وحدهما يستطيعان أن يقدما ذلك الجواب الأخير على جوع وعطش الإنسان. كيف لنا ألا نفرح بأننا نستطيع أن نكون كل يوم ضيوف الرب بالذات، وأن نقيم معه؟ كيف لنا ألا نفرح بأنه أوصانا: “افعلوا هذا لذكري”؟ نفرح لأنه أهلنا أن نعد وليمة الرب لأجل البشر، وأن نعطيهم جسده ودمه، وأن نقدم لهم هبة حضوره الثمينة. نعم، نستطيع بكل القلب أن نصلي سوية كلمات المزمور: “الجودة والرحمة تتبعانني جميع أيام حياتي” (23 [22]، 6).
وأخيرًا نلقي نظرة إلى نشيدين المناولة الذين تقدمهما لنا الكنيسة اليوم في الليتورجية. هناك أولاً كلمة القديس يوحنا الذي يختتم خبر صلب يسوع: “طعنه جندي بحربة في جنبه وخرج فورًا دم وماء” (يو 19، 34). قلب يسوع يُطعن بالحربة. يُفتح، ويضحي نبعًا: الماء والدم الخارجان منه يدلان على السرين الأساسيين اللذين تعيش منهما الكنيسة: المعمودية والافخارستيا. من جنب يسوع الممزق، من قلبه المفتوح يتدفق النبع الحي الذي يجري على مدى العصور ويؤلف الكنيسة. القلب المفتوح هو نبع نهر حياة جديد؛ في هذا الإطار يلمح يوحنا بالتأكيد إلى نبوءة حزقيال الذي يرى نهرًا يحمل الخصب والحياة ينبع من الهيكل الجديد (حز 47): يسوع بالذات هو الهيكل الجديد، وقلبه المفتوح هو النبع الذي يتدفق منه نهر الحياة الجديدة، التي تُعطى لنا في المعمودية والافخارستيا.
ولكن ليتورجية عيد قلب يسوع الأقدس تتضمن أيضًا، كنشيد للمناولة، كلمة أخرى، قريبة من المذكورة أعلاه، وهي مأخوذة من إنجيل يوحنا: إذا عطش أحد فليأتي إلي ويشرب. من يؤمن بي، كما يقول الكتاب: “ستتدفق من جوفه أنهار ماء حي”” (راجع يو 7، 37+). بالإيمان نشرب من الماء الحي المتدفق من كلمة الله. وهكذا يضحي المؤمن بدوره نبعًا، يهب أرض التاريخ العطشى الماء الحي. نرى هذا الأمر في القديسين. نراه في مريم، امرأة الإيمان والحب العظيمة، التي صارت على مر العصور نبع إيمان، حب وحياة. كل مسيحي وكل كاهن يجب أن يكون، انطلاقًا من المسيح، نبعًا يعطي الحياة للآخرين. يجب أن نعطي ماء الحياة للعالم العطشان. يا رب، نشكرك لأنك فتحت قلبك لأجلنا؛ لأنه في موتك وقيامتك أضحيت نبع حياة.
اجعل منا أشخاصًا أحياء، أحياء بفضل نبعك، وهبنا أن نكون أيضًا ينابيع تستطيع أن تهب لزمننا ماء الحياة. نشكرك لأجل نعمة الخدمة الكهنوتية. يا رب، باركنا وبارك جميع البشر في هذا الزمان الذي يعيشون العطش والبحث. آمين.
نقله من الإيطالية إلى العربية روبير شعيب – وكالة زينيت العالمية (Zenit.org)