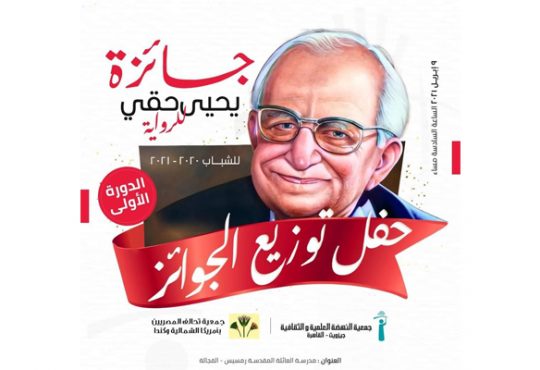الوصايا العشر- ترجمة الأب/د.أندراوس فهمي

 الوصايا العشر- ترجمة الأب/د.أندراوس فهمي
الوصايا العشر- ترجمة الأب/د.أندراوس فهمي
مقدمة
كانت سلوكيات شعب إسرائيل خلال زمن العبودية في مصر، وفي مسيرتهم الطويلة نحو “أرض الموعد”، نابعةً من تقاليد الشعب العبري القديمة نفسها، تلك التي بدأت مع إبراهيم. فتقبّل الشعب الوحي في الصحراء، حيث أعلن الله نفسه للشعب وأعطاه وصاياه.
وسط علامات وظهورات فائقة، وعلى جبل سيناء، يخاطب الله موسى ويسلّمه كتاب الوصايا (لَوحَيّ الشريعة)، والتي أطلق عليها الشعب العبري “الكلمات العشر”. ترد هذه الرواية في (خر1:20-18)، حيث يُعلن الله لموسى أنه الإله، الذي كلّمهم ويجب عليهم ألاّ يصنعوا لهم آلهة من فضة أو ذهب، ويقيموا هيكلاً ليقدّموا عليه الذبائح والقرابين (خر22:20-23).
لقد كان الشعب الإسرائيلي يخاف عقاب الرب، فجعل له من الوصايا العشر قانونًا يحكم سلوكه الأخلاقيّ، ويشكّل حقيقة وجوده. كما يضيف التقليد العبري أن الله ذاته هو الذي كتب الكلمات العشر بإصبعه (خر18:31)،
كما يذكّر موسى الشعب كيف أن الله كتب الوصايا وسلّمها إليه (تث22:5).
لقد أقام الله عهدًا مع شعبه من خلال الوصايا، ولهذا دُعيت الوصايا بـ “لوحي العهد” أو “لوحي الشهادة” (خر18:31؛ 15:32؛ 19:34). وقد حُفظَ لوحا العهد في التابوت، المصنوع من خشب السنط والمغطّى بذهب خالص، من الداخل والخارج، ويحيط به من أطرافه شريط من ذهب (خر10:25-26)، وكان يوضع وسط الخيمة التي تمثّل المعبد (خر1:40-2). ولقد ارتبط مستقبل شعب إسرائيل بحفظ الوصايا (تث16:30-17)، وهذا ما كان يذكّر به الأنبياء الشعب، وما يتطلّب حفظ الوصايا من سلوك أخلاقيّ (أر9:7، حز5:18-9، هو2:4).
إلزاميّة الوصايا
لقد ظلّت الوصايا العشر محتفظة بقيمتها في تاريخ شعب إسرائيل، ومازالت تحتفظ بهذه القيمة إلى اليوم. لذلك لم تتوقف الكنيسة عن إعلانها، بل وتحث دائمًا على تطبيقها، وتحاول تحت قيادة الروح القدس أن تفهم عمقها وتبحث عن طرق ومناهج متجددة لمعايشتها، آخذةً في الاعتبار المتغيرات والقضايا الأخلاقية المستحدثة.
إنّ السبب المنطقي والأساسي لهذا الإلحاح على وجوب إتباع الوصايا، هو تناغم مضمونها الأخلاقيّ مع متطلبات كرامة الإنسان. فالله لا يطلب من الإنسان إتباع وصايا صعبة التطبيق، وبالأخص من الشعب الإسرائيليّ الذي لم يكن لديه، في هذه الفترة التاريخية، نفس الفهم ولا الحساسية التي لدينا اليوم لمفهوم لأخلاق. فقد كان خارجًا لتوّه من عبوديّة، وعليه أن يحيا فترة طويلة في الصحراء (ترحال)، ولم يكن قد استقرّ بشكل نهائيّ في فلسطين.
تتضمن الوصايا العشر بعض الوصايا التي تتوافق مع ما نسمّيه “الشريعة الطبيعية” (الناموس الطبيعيّ). وهذا ما يؤكّده تعليم الكنيسة الكاثوليكية “الوصايا العشر تنتمي إلى وحي الله. وفي ذات الوقت تعلّمنا كيف تكون إنسانية الإنسان الحقيقية. وكذلك تُظهر إلى النور الواجبات الأساسية، ومن ثم، وبشكل غير مباشر توضّح الحقوق المرتبطة بطبيعة الشخص. إن الوصايا تحوي تعبيرًا مميزًا للناموس الطبيعي”.
ويؤكّد القديس إيريناوس “أنه منذ البدء، والله قد زرع في قلب البشر وصايا الناموس الطبيعي. ثم استدعاها إلى العقل من خلال الوصايا العشر”.
أعطى الله الوصايا العشر حتى يستطيع الإنسان، أن يكتسب معرفةً ووعيًا فيما يخصّ الواجبات الأخلاقية، التي تتطلّب تناغمًا مع الله واحتياجات الإنسان.
وقد أظهر يسوع، بسلوكه أو بتعليمه، احتراماً كبيرًا للوصايا العشر ولم يلغِها. ورجع إليها وحثّ على حفظها. الشاب الغني الذي طرح عليه تساؤلاً أخلاقيًّا: “يا معلم، ماذا أصنع لأرث الحياة الأبدية؟” أجابه يسوع “إذا أردت الحياة الأبدية، احفظ الوصايا”. ثم أكمل يسوع واستشهد ببعض الوصايا (مت16:19-19).
وأيضًا حين سأله الفريسيون عن أعظم الوصايا، استشهد يسوع بالوصايا العشر بشكل غير مباشر(مت34:22-40).
فقد أعلن يسوع أنّه لم يأتِ لينقض الوصايا بل ليكملها (مت17:5). ففي حديثه عن التطويبات أكمل الشريعة القديمة. مثلاً وصية القتل، فبدلاً من إدانة الشريعة القديمة للقتل، أدان أيضًا مجرد الغضب والكره للأخ (مت21:5-26). وفيما يخصّ الوصية السادسة، والخاصة بالزنى، فقد أكّدها وأعلن رفضه للنظرة الشريرة التي تغلق الإنسان على ذاته، ليصل إلى معايشة العفة كانفتاح على الآخر (مت33:5-37). وفيما يخصّ القَسم الذي كان يستخدمه الشعب العبري بتواتر، اقترح يسوع شريعة المحبة والتي يسود فيها الحب لأجل الحقيقة. ولتعديل الشريعة القديمة (شريعة “تاليون” التي كانت في قانون حمورابي والتي أكّدت على مقابلة الشر بالشر) قام يسوع بتعديلها إلى مقابلة الشر بالخير (مت38:5-42). وأدان “كراهية الأعداء”، ومن ثم فعلى المسيحي أن يحب عدوّه كما يحب صديقه (مت43:5-48).
لا تناقض هذه الوصايا، الفضائل أو التطويبات ولكنها تكمّلهما، وسوف نعرض ذلك باختصار شديد:
1. الوصايا العشر والفضائل
إن الوصايا العشر لها طابع ملزم، يجب على المسيحيّ أن يحفظها (يطبقها)، في سبيل حياة متوافقة مع حب الله. إن تتميم القواعد الأخلاقية بممارسة أعمال متكررة، يخلق ما نُطلق عليه “عادة”، بمعنى الكلمة الإيجابي، أي يصبح سلوك المسيحي جزءًا منه، ويتحوّل إلى تصرفات عفوية غير منفصلة عنه. ويتحقّق ذلك من خلال “الفضيلة” التي تصبح هي الأخرى “عادة”. فالفضائل تتمايز عن الوصايا ولكنها لا تتناقض معها، بل تكمل إحداهما الأخرى، فمن خلال حفظ الوصايا يكتسب المسيحي الفضائل، ومن يمارس الفضائل يسهل عليه حفظ الوصايا.
2. الوصايا والتطويبات
إن الوصايا والتطويبات حقيقتان متمايزتان. تحمل الوصايا بداخلها قوة تعمل على الاستدلال الأخلاقي؛ أمّا التطويبات تختص بالأحرى بما يجب أن يكون عليه المسيحيّ، ليحيا ما تتطلبه الأخلاق الموجودة في الوصايا. وبهذا المعنى أيضاً، فالوصايا والتطويبات يكمّل كل منهما الآخر، حيث يتجه كل منهما نحو الهدف نفسه. وكما تقوم الوصايا بالتأثير والتحكّم في الضمير، تقوم التطويبات بتهيئة الجو المناسب لتطبيق الوصايا بصورة أكثر كمالاً. ولدينا في التعليم الكنسيّ الوارد في وثيقة “تألق الحقيقة”، وفيها يوضّح قداسة البابا كيف أن التطويبات تفتح آفاقًا جديدةً على الحياة الأخلاقية، حيث أنها تمثل نوعاً من الصورة الواقعية والحقيقية، وتقود بشكل مباشر إلى الاقتداء بالمسيح، ولذلك فهي دعوة لاتباعه والدخول في شركة معه.
الإلحاد، والغنوسية، والعلمانية
نود أن نتعرّض أيضاً لبعض الإيدولوجيات والتيارات الفكرية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على مفهوم ومعايشة الوصايا: فهي عكس الوجود المسيحي الذي يدعو الشخص إلى الإصغاء إلى وحي الله والعيش وفق إرادته، نجد أنفسنا اليوم أمام بعض الظواهر الثقافية التي تقف حيال الله، ولا تأخذ في الاعتبار الوصايا الأخلاقية. ومن بين هذه الظواهر نجد الإلحاد والغنوسية والعلمانية.
1. الإلحاد
“الملحد” هو الذي يقول “لا” لله، فبالنسبة له الله غير موجود. والإلحاد ليس ظاهرة أصيلة في الإنسان، فالإنسان منذ وجوده- وفي كل الثقافات- يظهر كائنًا متدينًا، حتى أن هناك بعض المعلومات التي كشفها علم الحفريات، إذ اكتشف جسد إنسان قديم وغالبًا معه بعض المواد أو العناصر التي تدل على تدينه. وعلى نفس المنوال، يخلص كل من علم الأديان والفلسفة أنّ الإنسان كائن متدين.
إن الإلحاد كظاهرة لها بنيتها في عصرنا، ترجع جذورها إلى الماضي سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. “إن الشرير الشامخ بأنفه لا يبحث عن شيء. وجملة أفكاره أن لا إله” (مز4:10). ففي العصر اليوناني، كانت هناك بعض التيارات الفلسفية التي تنكر وجود الله، ولكن هذا النكران لم يكن هو ذاته الإلحاد ببنيته التي نفهمها اليوم، ولكنهم كانوا ينكرون وجود الآلهة التي كانت مقبولة لدى الشعوب الوثنية وفي المجتمعات السياسية.
وفي أيامنا هذه، فقد اكتسب الإلحاد قدرة كبيرة وخاصة في اختراق الدول التي ظلّت لفترات طويلة متمّسكة بالإيمان المسيحي. فالإلحاد بشكله الرسميّ قد بدأ مع “نيتشه”، واستمر ووجد تبريره مع “ماركس”، ثم وصل إلى قمّته في القرن العشرين. ولهذا، يؤكّد تعليم المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني أن “الإلحاد أصبح آفة من آفات زمننا تستحق البحث باهتمام كبير”. كما يميّز بين أنواع الإلحاد المختلفة، ويعرض الأسباب المختلفة التي أدّت لوجوده، وتأخذ الكنيسة في عين الاعتبار وتدين هذه الظاهرة “إنّ الكنيسة في إخلاصها لله وللإنسان على حدٍ سواء، لا تستطيع أن تكف عن استنكارها في حزن وبكل حزم، كما فعلت في الماضي، تلك المذاهب والأساليب التعسفية الوخيمة التي تتنافى مع العقل والتجارب الإنسانية، وتهدر الكرامة الطبيعية وسمو الشخص الإنساني”.
2 الغنوسية
لقد استبدل جزء كبير من ذلك المدعو إلحاداً بما نسمّيه الغنوسية. فالغنوسيون لا ينكرون وجود الله، بل يؤكّدون أن الفكر الإنسانيّ أو العقل البشريّ لا يمكنه أن يثبت أو يُنكر بشكل جازم وجود الله انطلاقًا من واقعهم الحياتيّ. فحال الغنوسية أسهل من الإلحاد، حيث إنّها لا تجتهد كثيرًا لإيجاد براهين على عدم وجود الله كما يفعل الملحد. ولا تحمل على عاتقها الميراث المؤلم للإلحاد (حيث أن الإلحاد تميّز في تاريخه باضطهادات وأحداث قتل كثيرة).
تحمل الغنوسية بداخلها رذيلة رافقتها منذ نشأتها: ثقة زائفة في العقل. ولذلك فمن المهم دعوة الشخص المقتنع بالغنوسية لاستخدام عقله كاملاً في كل المجالات، فمن غير الممكن أن يستخدم العقل بصورة هائلة في مجالات المعرفة التقنية فقط، وعند الحديث عن الإنسان والقيم الروحية، يُقال إن العقل البشري عاجز عن شرح المشاكل الخطيرة، وكذلك شرح معنى الحياة البشرية.لقد اهتم قداسة البابا يوحنا بولس الثاني بهذه القضية، محاولة منه لمساعدة إنسان العصر الحديث، ليكتشف أهمية العقل لمعرفة الحقيقية، والابتعاد عن الاهتمام الهزيل بجزء من الثقافة الحالية لمعرفتها، وفي نفس الوقت يهمل الاهتمام بتطوير العقل والفكر، ويكتفي فقط بوضع حدود عليه. وفي الواقع، فقد انبثق من الغنوسية ما نسميه النسبية، هذا التيار الذي يبدأ نظرياته بمحاولة معرفة الحقيقة، ثم بعد ذلك يحاول توضيح نسبيتها. وتبع ذلك تيار “النسبية الأخلاقية”، والذي ينادي بأن الخير والشر يفقدان موضوعيتهما، بمعنى آخر أنّ نطلق على شيء أو حدث ما، أنه خير أو شر، فهذا يعتمد على رأي كل فرد وبحسب الظروف التي يوجد فيها…إلخ. فالنسبيّة الأخلاقية هي بمثابة سرطان الحياة الأخلاقية، حيث إنّها تعمل على تآكل نظام القيم الأخلاقيّ. وقد عبّر عن ذلك البابا يوحنا بولس الثاني موضحاً:
“لابد من الإشارة إلى بعض الاستنتاجات غير الجائزة في مجال علم الإنسان. فانطلاقاً من التنوع الكثير في الأخلاق والعادات والثقافات السائدة بين البشر، يصل بعضهم إن لم يكن إلى التنكر للقيم الإنسانية الشاملة فأقلَّه إلى اعتبار الشأن الأخلاقي أمراً نسبياً”
.تُمثّل النسبية بكل أفرعها الأخلاقية والفلسفية والمعرفية، شرًا كبيرًا يُسيء إلى الحقيقة والواقع وإلى العيش المشترك. فإذا اعتبرنا أن كل شيء نسبي، فلا يوجد ما هو مهم أو محدّد. ولهذا ففي الثقافة النسبية لا توجد إجابة أكيدة أبدًا؛ والأكثر سوءًا من ذلك أنه لن توجد أيضًا أسئلة أساسية. وعندما لا نجد في ثقافة ما أن التأكيدات ليس لها محل كبير، فتتولد في ذلك المجتمع الكآبة والقلق، لأنّ الإنسان في كل زمان يبحث دائمًا عن الأمان، أمّا النسبية فهي تلغي وتنكر أساس الوجود ذاته وكذا المعنى الأخير للحياة.
3. العلمانية في العصر الحديث
والذي قسمت عناصره وأجزاؤه، فكريًا، إلى ملحدين وآخرين غنوسيين…إلخ نجد آخرين من فئات ثقافية مختلفة، يريدون أن يكونوا خارج أي تأثير ديني. وهنا تأتي العلمانية لتغزو مجالاً كبيرًا من الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية والثقافية. وتجتهد لتنظيم العالم والبنيات الاجتماعية بعيدًا عن الله.لقد قام كل من البابا بولس السادس ويوحنا بولس الثاني، بإنكار دائم للعلمانية التي تفترض غياب الله عن حياة شعبه. حتى وإن كان في بعض المواقف والظروف، وجد بعض التشويش والاختلاط بين المحيط الإلهي (كل ما يخصّ الله) والمحيط الزمني (كل ما يخصّ الحياة المادية).
والمجمع المسكوني الفاتيكاني الثانيّ قد أشار رغم هذا إلى استقلالية كل الحقائق الزمنية. ولكن وضّح المجمع أن أي حقيقة مخلوقة لا يجب أن تقطع علاقتها الأصيلة بالله ولهذا السبب، نجد أنّه بين ما يدعى باللغة الأجنبية “clericalizzozione” (أي إضفاء طابع الإكليروس على المجتمع، وعلى أساسه يجب أن تقوم السلطة الكنسية لتعبّر وتقرّر في الأشياء والمسائل الزمنية)، وبين “العلمانية” Secolarizzazione (التي تنكر أي تدخّل من الله في حياة البشر والتعايش بين الشعوب)، فبين هذين البعدين حدود. فلا يتفق التعليم الأخلاقيّ المسيحيّ مع العلمانية المطلقة أو التسلط الإكليريكي المطلق. ولهذا فاختيار العلمانية هو الآخر يقف حائلاً دون فهم وتطبيق الوصايا.
خاتمة
تعبّر الوصايا العشر ليس عن مشروع الله فيما يخصّ السلوكيات الواجبة فقط من الكائن البشري، بل تؤكّد أن وصايا الله تحمي الإنسان وتعطي حريته معنى. لذلك، فهي لا تمثّل عبئًا أو تلغي استقلالية الأشخاص، بل تجيب على التساؤل الكياني للإنسان. إن حفظ الوصايا (تطبيقها) يضمن للشخص كماله وسعادته.
لقد عرضنا وبصورة مركزة جدًا، نظرة شاملة عن الفكر اللاهوتي حول الوصايا وعلاقتها بالفضائل والتطويبات، وأهم ما يعترض هذا الفكر من تيارات مختلفة، وكيف أن الوصايا هي صالحة أيضاً اليوم. ولكن كل ما يجب أن نقوم به، هو عرضها بصورة تناسب كل التغيرات الموجودة، دون أن نفقد جوهرها وأهميتها لحياة المسيحي الأخلاقية. وسوف نتناول في المقالات القادمة كل وصية، مستخلصين منها أهم القضايا الأخلاقية الخاصة، وكيف نقرأها ونفسرها على ضوء الإيمان والعقل، وكيف السبيل إلى تطبيقها بصورة عملية.
للمقال بقية،،،
عن مجلة صديق الكاهن 1/ 2008