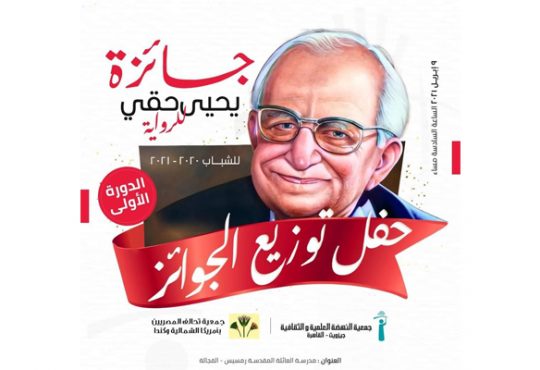سُلطة أم تسلّط أم مسئوليّة؟-د. الأب أندراوس فهمي

 سُلطة أم تسلّط أم مسئوليّة؟- الأب أندراوس فهمي
سُلطة أم تسلّط أم مسئوليّة؟- الأب أندراوس فهمي
لماذا “السُلطة”؟
نقرأ في سفر التكوين أنّ الله أعطى الإنسان سُلطة على المخلوقات (تك 1: 26)، وعندما نتمعن في فهم النص نجد أنّ غاية الله من تسليط الإنسان على المخلوقات لم يكن أبداً تنصيب آدم متحكماً في الكون ليصنع به كما يشاء، بل مديراً له، وشتان ما بين التحكّم والإدارة. فالله قد خلق كل الأشياء بعناية وحكمة، وقد أقرّ هو ذاته بأنّ كلّ ما صنعه هو حسنّ، لذلك كان دور السُلطة هو الحفاظ على الخير الذي صنعه الله، وهنا يمكننا فهم معنى وغاية السُلطة، فهي أمانة يضعها المالك في يد وكيل يحفظها ويديرها وينميها ويعمل على جعلها أكثر صلاحاً.
وفي العهد الجديد، نجد مفهوماً أعمق للسُلطة، وهو ما يمكن أن ندعوه “الاختيار”. فيسوع يقيم من بين كل أحبائه أشخاصاً يختارهم حتى يكونوا وكلاءً أمناءً على الرسالة التي بدأها هو بتجسده (مر 3: 14). وهذا المعنى لا يختلف كثيراً عن سابقه، فالتلاميذ والرسل وخلفاؤهم هم أشخاص مختارون من الله ليحافظوا على وديعة ولذلك لا يجب أن يغيب عن أعينهم مضمون الرسالة. فإذا كان يسوع قد جاء إلى العالم ليعيد له الحياة، بل ملء الحياة (يو10:10)، فعلى وكلائه السهر بجديّة والعمل على نشر ثقافة الحياة والحياة المثُلى.
إذا السُلطة مهمة للحفاظ على الخيرات الزمنية وأيضاً على الخيرات الروحيّة. ومن هنا جاء فكر الرسل الذين نادوا دائما باحترام الرؤساء: ” أطيعوا مدبريكم وأخضعوا لهم، فإنهم يسهرون على نفوسكم سهر من سيحاسب عنكم حتى يفعلوا ذلك بفرح ولا يئنون, لأن هذا نافع لكم (عب13: 17(، ومن هنا جاء فكر الكنيسة الكاثوليكيّة ليضع مبدأً من مبادىء السلوك الأخلاقيّ الأساسيّة وهو “احترام الرؤساء”، وذلك انطلاقاً من المفهوم المسيحيّ للسُلطة، وأنهم مختارون بتدخل إلهيّ، وأنّ مسئوليتهم كبيرة ومهمة ويجب أن ننظر إليهم من هذا المنطلق، ولا يجب أن ننظر إلى مسئولياتهم انطلاقاً من شخصيّة كل منهم أو قدرته على الإدارة، أو نجاحه أو فشله…فكلها فروق شخصيّة، لكن النظرة الإيمانيّة المطلوبة يجب أن تكون أبعد من مجرد التركيز على شخصيّة المسئول.
عندما تتحول السُلطة إلى تسلط؟
هنا نعود معاً للواقع، وللتساؤل الذي خطر في ذهن القارىء العزيز عندما عرضنا الجانب الإيجابي للسُلطة: ماذا لو تحول الوكيل الأمين إلى وكيل خائن للوكالة؟ (لو16: 1-9). فالمسئول هو أيضاً إنسان وله حدوده وضعفاته، بل وأحياناً تكون السُلطة عاملاً مساعداً لفساده وبالتالي تدمير وكالته. هذا بالطبع ما نريد معالجته. فنحن معاً في سفينة الحياة، وإذا كان القبطان مخطأً فليس الحل أن نترك السفينة تغرق، أو نعزل القبطان، فكلا التصرفيّن خاطىء. فمن جهة لا يمكن أن نتخلى عن مسئوليتنا في أن نعيش ونعيش حياة كريمة، ومن جهة أخرى لسنا كلّنا مؤهلين لتحمل مسئوليّة قيادة السفينة. ولذلك المعالجة الأخلاقيّة لهذا الموضوع يجب أن تكون من جانبين:
أولاً: من جانب المسئول نفسه
انطلاقاً من المعنى الإنسانيّ والكتابيّ للمسئوليّة، فعلى المسئول تفهم بعض النقاط التي ربما تكون تاهت من كثرة المسئوليات والأعباء. فالكل يعلم أن أي مسئوليّة تحمل معها هموماً كثيرة وتتزايد هذه الهموم والانشغالات مع الوقت، وأحياناً يقع المسئول فريسةً للانعزال داخل دائرة مسئوليته، فتراه غارقاً في انعزالية رهيبة عن وكالته، وذلك – من وجهة نظرنا- يأتي أحياناً كنتيجةً تلقائيّة لسعيه لحل المشكلات بمعزل عن الجماعة التي يتولى مسئوليتها. ولا يخفي على الجميع أن الشخص المسئول لا ينظر إلى الأمور الإداريّة والتنظيميّة بنفس النظرة التي يراها بها من هم تحت مسئوليته، فكل مسئوليّة لها حسابات ظاهرة (يراها المرؤوسين) وحسابات غير ظاهرة (يراها فقط المسئول)، وهنا يمكن أن نجد جسراً للتفهم المشترك. فأحياناً يريد المرؤوسون أن تعالج الأمور كما يروها هم، في الوقت الذي يحتّم واجب المسئول الاحتفاظ بأسرار وأشياء لا يجب أن تُعلن للجميع، ولذلك وَجَبَ على المسئول توضيح ذلك من حين إلى آخر.
من جهة أخرى، فالمسئول مطالب ضميرياً أمام الله أن يراجع حساباته من حين إلى آخر. ومراجعة الذات لا تعني فقط المحاسبة على الأخطاء الشخصيّة، بل بالأحرى إعادة تقييم لهدف وغاية الوكالة، أو بمعنى أوسع التساؤل المستمر عن حسابات الوكالة ومدى الأمانة في إدارتها.
الكنيسة كمثال
السُلطة الكنسيّة -التي لا تعني السُلطة الكهنوتيّة فقط، بل أي سلطة داخل الكنيسة بكل خدماتها- تعني مسئوليّة الحفاظ على الإيمان وإدارة كل ما هو لخدمة هذا الإيمان بالشكل السليم لصالح الإنسان. كثيراً ما نفقد هذا الهدف بسبب التحوّل من وكيل إلى مالك. فعندما تمارس السُلطة داخل الكنيسة بأسلوب فرديّ لا يأخذ في الاعتبار الجماعة التي نعمل لأجلها، والجماعة التي تشترك معنا في الخدمة، وكذلك الهدف الذي نسعى إليه يمكن أن تتحول أنشطة الكنيسة ومؤسساتها إلى أنشطة عقيمة لأنها في واقع الأمر تختزل المسئوليّة وتجعل منها وسيلة لفرض السُلطة الشخصيّة التي لا يمكن أن تنجح، لأنها بهذا الأسلوب تناقض ذاتها. فالكنيسة تهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة الإنسان من خلال روحانيتها العميقة المنبثقة من محبة المسيح، فإذا غاب المسيح عن أنشطتها غاب معه الهدف.
وإذا كنا نتأمل في التطويبات، فدعونا نرى ما كان عليه رأس الكنيسة في معالجة أمور السُلطة. فهو الذي مارس سلطة المحبة بوداعة القلب: “تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب”. إنّه المسيح الذي كان في رئاسته للكنيسة الناشئة يخاطب قلب الإنسان، وكم نفتقد كمسئولين مخاطبة القلوب! كان يعمل يسوع على ضمير الإنسان فتراه لا يحكم ولا يدين بل يخط بأصبعه على الأرض فيدخل الفريسيّ إلى ذاته ويقتنع أنّه هو أيضاً خاطىء ولا يجب أن يدين تلك المرأة المسكينة التي لم تسلم من قسوة القانون (يو 8: 3-11). إنّه يسوع الذي يقبل الضعيف ولا يتركه إن لم يستعيد صورة الله بداخله، فبوداعته حوّل مريم المجدليّة وجعله خليقة جديدة. فهكذا كان يتعامل يسوع مع رعيته: لا يُدين، يخاطب قلوبهم، يعيد إليهم ما فقدوه ويعطي قيمة كبيرة لهم كأشخاص.
أمّا شركائه في العمل فكان يقودهم بصبره ودماسة أخلاقه وبحب، فتراه تارةً يشفق عليهم وعلى ضعف إيمانهم، وتارةً أخرى يشرح لهم ويشركهم، وتارةً أخرى يعنّفهم لأن أفكارهم ليست صافية (موقف بطرس مت 16: 21-23). إنّ سلطته كانت تتميز بالأبوة الرحيمة، والتعليم السليم، والحكم الصائب. فيسوع كان يدير كنيسته كأبٍ، وكمعلمٍ، وكقاضي عادل. ولا يضرنا التكرار أنّ كل هذا كان يتم بوداعة القلب.
وفيما يخص الهدف، نجد يسوع لم يغب عنه أبداً أنّه جاء لخلاص الإنسان، فتراه لا يستسلم لتجارب إبليس التي أرادت أن تحيد به عن الهدف، ولا تراه يستسلم للسلطة الزمنيّة، ولا تراه يفقد الأمل عندما لا يفهمه حتى أهل بيته، فقد أكمل رسالته في صبراً ومثابرة حتى إلى الصليب (يو19: 30). وكل هذا كان يتم بوداعة القلب وبصبر الأب، وأخلاق الحكيم. أنّه الراعي الصالح.
ونخلص من كل هذا أن المسئول داخل الكنيسة لا يجب أبدًا أن ينسى أنّه وكيل وليس مالك، وأنّه يعمل مع جماعة وليس بمفرده، وأنّه لا يعلم كل شيء ويجب أن يعطي صلاحيات لآخرين، وألا يضيع عنه هدف تكوين الإنسان وليس فقط البنيان، وترتيب أولويات… وكل هذا يجب أن ينبع من خلال محاسبة الذات في إطار هدف الخدمة الموكلة، وذلك بوداعة قلب المسيح ودماسة أخلاقه وصبره اللانهائي. فلو تحوّلت مسئوليّة المحبة داخل الكنيسة إلى تسلّط، وجد المتسلّط ذاته وحيداً منعزلاً بل ويحكم على ذاته بتلك العزلة، وبالتالي يصل إلى مرض السُلطة الذي يؤدي به إلى “اللا حريّة” فهو أسير لأفكاره، وسجين عالمه، وفاقد لآليات النجاح. وهذا النوع غالباً ما يصاب مع الوقت باكتئاب ورغبة دائمة في الانسحاب من العلاقات السويّة وتجده يهرب ليبحث في قشور الحياة وليس في معناها.
وما يقال على المسئوليّة الكنسيّة يقال أيضاً على المسئوليّة في معركة الحياة، فلابد لأي مسئول أن يضع الله أمام عينيه ويحاسب ضميره من وقتٍ إلى آخر، وكيف أنّ الله ائتمنه على أشخاص وأعمال وغيرهما. فكيف لي أن أستغل سلطتي في قهر الأشخاص، ولماذا لا أنظر إلى الخير العام وليس إلى خيريّ الخاص الأنانيّ، وهل ستكون حياتي كريمة إذا ما سلبت وسرقت وقهرت ولم أضع الله أمام عينيّ؟؟
ثانياً: من جانب المرؤوسين
انطلاقاً من مبدأ “اصنع الخير وتجنّب الشرّ”، نجد أنّ صنع الخير يتطلب الشعور المتبادل بين الرئيس والمرؤوس. فحتى نصنع الخير معاً يجب أن نعمل معاً، وبالتالي نلغي من قاموس مفرداتنا كل ما هو ضد “نون الجماعة”! أي كل ما هو ضد العمل المشترك. فما أسهل أن نرى مسئولاً متسلطاً ونقطع معه كافة العلاقات ونسكّن أنفسنا بالتخلي عن أداء الدور المناسب. فكم من كنائس وخدمات ومسئوليات هوّت بسبب الانسحاب والتخلي عن أداء الدور المطلوب، خاصةً وأن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم يقدم لنا بدائل أكثر سهولة.
ماذا نفعل أمام التسلط الغير مسئول؟
عندما سأل أحدهم المسيح: كم مرّة أسامح أخي الذي أخطأ؟ أجاب يسوع: “سبعين مرة سبع مرات” (مت 18: 24)، أي تسامح دائم وبلا حدود. فالمسيح يعلّمنا المثابرة والوداعة في معالجة الأمور. وبناء على هذه الروح الإنجيليّة هناك نهجٌ ربما يكون من المفيد اتباعه في حالة التعامل مع أشخاص مُتسلّطين:
1. القيام بعمليّة نقد ذاتيّ:
فقبل أن أقوم بأي سلوك، سيكون من المفيد جداً أن أتساءل مع نفسي وبصدق عن حكمي الذي أصدرته على هذا المسئول: هل هو حكم نابع من عدم قبول لشخصه؟ هل درست الموضوع بكافة جوانبه؟ هل تشاورت مع آخرين حتى لا يكون حكمي مطلقاً؟ هل المسئول على حق، أم أتجنى عليه؟ هل أُضخّم في حجم المشكلة أم أعطها الحجم السليم؟…إلى آخره من هذه الأسئلة التي يجب أن تحملنيّ إلى الوصول إلى نوعِ من الحياد والموضوعيّة في تحليليّ للمشكلة. لأنّه إن لم أقم بهذه الخطوة فمن المؤكد أنّ الخطوات اللاحقة ستكون خاطئة لأنها ستفتقد للموضوعيّة وللتأكيد الأدبيّ الضروريّ.
2. أسلوب صادق للحوار:
من الأشياء التي نختبرها جميعاً هي أن أغلب الحقوق تضيع ونفقدها بسبب أسلوب الحوار. فكم من المرات ندفع بالمسئول (عن قصد أو غير قصد) لأن يغلق باب الحوار مستخدماً سلطته لأنّنا لم ننطلق بصورة صحيحة في الحوار. فأي حوار لابد وأن ينطلق من هدفٍ واضحٍ وصالحٍ، فإذا بدأت حواري بنقدٍ هدّام أو بإلقاء الاتهامات على الشخص، فلا يجب أن أتوقع ثماراً من هذا الحوار، لكن إذا كان فكري وذهني وعواطفي كلّها موجّهة نحو إثبات الحقيقة، فهنا أنا مطالبٌ من الناحية الأدبيّة أن أبحث بجديّة عن الأسلوب المناسب والوقت المناسب والمكان المناسب لعرض أفكاري. وهنا من المهم التذكّر أنّ الشفافيّة والصدق هما أقصر طريق للحقيقة، كما أنّ الاحترام المتبادل في الحوار هو أفضل الوسائل للوصول إلى الثمرة المرجوّة من هذا الحوار.
3. البحث عن عدم تعثير الآخرين:
أحياناً الاندفاع في إثبات الحقيقة يصيب الشخص بنوع من الغشاوة التي تجعله يركز على موقفه محاولاً إثبات وجهة نظره لدرجة أنّ ذلك ربما يجعله لا يرى أيّ شيءٍ سواها. وقد يؤدي به أحياناً إلى إهمال “مُستقبِل الحقيقة” أي الأشخاص الذين يهمهم الموضوع. فقد قال يوماً يسوع: “الويل لمن تأتي منه العثرات” (مت 18:7)، فهيّ خطيئة عظيمة جداً في نظر الربّ، لأنّ تشكيك الآخرين في واقع الأمر يؤدي إلى خلط وتشويش وانزعاج في قناعات الأشخاص وما يؤمنون به وما اختبروه، لذلك لابدّ أن تكون الحقيقة موضوعيّة وفي نفس الوقت يجب أن تُعرَض بطريقة تناسب مُستَقبلها. وإلا ستفقد قيمتها وتبلبل إيمان الأشخاص.
4. أخيراً وضع الموضوع أمام الله:
فالإنسان محدود، ويحتاج دائماً لإرشاد الروح القدّس الذي ينير الطريق ويكشف خبايا القلوب. فإذا أخذ الله مكانه في هذا الحوار فلنتأكد أنّ ثماره ستكون أكيدة، لأنّ الله هو “الطريق والحق والحياة” (يو 14: 6)، فإذا آمنّا بذلك وكان لدينا الامتثال الكاف أمام الله، فإيماننا به وبقدرته كفيلٌ بخلق إمكانات أخرى لإثبات الحقيقة.
أخيراً طوبى لفقراء الروح الذين يصغون إلى صوت الحقّ ويهتمون بما هو لله، طوبى لفقير الروح القادر أن يتخلى عن روح التسلّط ويصغي إلى صوت راعيه الوديع، وطوبى لفقير الروح القادر أن يبني رُغم كل الصعوبات والمشقّات… نعم فلكل هؤلاء ملكوت السموات.