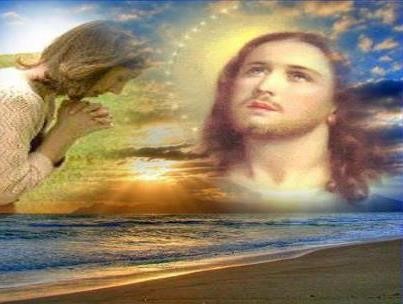أما أنا فأقول لكم… رهافة تعليم يسوع-الأب داني قريو

أما أنا فأقول لكم… رهافة تعليم يسوع
الأب داني قريو
إنّ الكنيسة في هذا الأحد السادس من الزمن العادي، تتابع في الفصل الخامس، حسب القديس متى الذي موضوعه الأساسي “الشريعة” أو الوصايا، الوصايا العشر التي أعطاها الله لموسى النبي. هذه الوصايا التي تعتبر قوانين الحياة الموحى بها من السماء، التي تعتبر معيار الحياة التي تصبو إلى الكمال.
كان موضوع الوصايا في زمن يسوع، يشغل حيزاً هاما من حديث الساحة، لهذا كان على يسوع أن يُشكِّل أو يعيد تكوين الرسل على حس قوي للهوية الدينية، مختلف عماكان يعرضه الكتبة والفريسيون. كان يتمتع كل من الفريسيين والكتبة وكذلك الصدوقيون بسحرٍ خاص، بهيبة خاصة لدى الشعب. بإعتبارهم الأشخاص الذين سبروا الكتب المقدسة والشرائع حتى أدق التفاصيل لكي يصلوا إلى الكمال. ونتيجة لذلك، كان الشعب يحيطهم بهالة من الوقار والاحترام. كان الشعب مسيَّرا منهم، لأنهم عرفوا وغرفوا من كنوز الحكمة الإلهية. لكن الحقيقة أنهم كانوا أبعد مايكون عن الحقيقة لأن قلوبهم كانت ممتلئة من عجرفتهم. يكفي أن نتذكر صلاة الفريسي مقارنة بصلاة العشار “اللهمَّ، شكراً لك لأني لست كسائر الناس السراقين الظالمين الفاسقين، ولا مثل هذا العشَّار! فأنا أصوم مرتين في الأسيوع وأؤدي عُشر ما أقتني” وكأنه يحمّل الله جميل “منّيّة” ما يفعل. بنظره لقد وصل وليس محتاجا لأي شيءٍ من الله. وليس فقط أنهم كانوا متعالين على الله بل كانوا أيضا يحملون أعباءً ثقيلة على كاهل الناس “يحزمون أحمالاً ثقيلة ويلقونها على أكتاف الناس، ويأبون تحريكها بطرف الاصبع. جميع أعمالهم يعملونها لينظر الناس إليهم…”. كانوا قد عرضوا في السوق ليس الوصايا العشر، إنما 613 وصية لبلوغ طريق الكمال!!
ففي زمن يسوع كانت هناك مدرستان رسميتان ومتعارضتان في نفس الوقت. مدرسة الرابي “المعلم” شمّاي، الذي كان متشدداً صارماً في تطبيقه لهذه الوصايا. ومدرسة الرابي هلّيل الأكثر تساهلاً والأخف وطأة في تتميم احكام الشريعة. فما كان على تلاميذ يسوع إلا أن يتبعوا إما المدرسة المتشددة واما المدرسة المنفتحة لحل المسائل التي كانت تعترضهم في الحياة.
إن يسوع كان على علمٍ بكل هذا لذا نجده يقول: “”لا تظنوا أني جئت لأبطل الشريعة أو الأنبياء: ماجئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم: لن يزول حرفٌ أو نقطة من الشرريعة…” كان يؤكد أنه لا يمكن التبديل، الالغاء، أو التلاعب في أي بند من بنود الشريعة.
إن خمير الفريسيين ومثلهم الصدوقيون كان مغرٍ (لأنه كان من المفترض أنهم منفذو الشريعة بحذافيرها) أي بنظر الناس هم المقبولون عند الله، والله راضٍ عنهم! لهذا كان ينقدهم يسوع لأن برّهم كان مزيفا.
يسوع لم يغير الشريعة “فإن من يقتل يستوجب حكم القضاء” هذه الوصايا يجب ألا تتغير أو تتبدل. انه يعطي هذه الوصية معنى أوسع ، يغير مفهوم القتل. لم يقتصر على قتل الجسد إنما امتد إلى القلب، الذي يمكن أن يجرح من جراء إهانة “أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القضاء، ومن قال لأخيه: ياأحمق….”. يسوع لا ينحصر في الظاهر إنما يوسع أفقه لينزل إلى عمق الإنسان، يتابع في الخط العبري لكن يصححه، لا يكتفي بالحرف (القتل المتعمد، الانتقام الشخصي). كم مرة بكلامي، أقتل الآخر، من مجرد الافتراء عليه، تشويه سمعته، أليس في ذلك قتل للآخر؟ عندما أستهزئ بالآخر واجعل منه موضع سخرية الجميع بحجة (عم نمزح، عم نكت عليه، منشان نخلق جو حلو…) من أجل إظهار نفسي أقتل الآخر، ألغي كرامته، كيانه كإنسان وأحوله إلى مجرد سلعة ألعب بها لأتسلى، أليس قتلاً هذا؟ كم مرة بفورة غضبي أهنت أمي، أو أبي، اللذين ربيانني وأهرقا حياتهما من أجلي، أليس قتلاً هذا؟ وكثير وكثير من هذه الأمور.
أقتل الأخربعدم محبتي له، بمحبتي المبالغة لذاتي، بنرجسيتي المفرطة. لو سألتك عزيزي القارئ: ماهو عكس المحبة؟ يمكن أن تأتي أجوبة متعددة: الحقد، البغض، الكره، الحسد… كلها ممكنة لكن عكس المحبة هو اللامبالاة! عندما أسير ولا أرفع الآخر من أرضه. أسير ولا أنظر عليه، ولا أعيره أي اهتمام. إن أكره شخصاً، فقد يأخذ حيزاً من تفكيري، من حياتي. يمكن أن أتجنبه، يمكن أن أذكره في صلاتي… أما إن كنت لا مبالٍ بشخص. فأنا لا أعتبره موجودا بتاتاً. هو ميت من حياتي، قتلته وطردته من عالمي. كم نشعر بصغرنا عندما نتكلم مع شخص وهو لا يعيرنا أي اهتمام، ولا يصغي لنا. كم من الألم الذي نتكبده من جراء سلامنا على الآخر (وخاصة إن كنّا برفقة صديق) والآخر لا يرد السلام علينا. أليس قتلاً هذا؟ إن يسوع واعٍ الألم والجراح التي تكبدها حركات كهذه، لهذا يتجرأ ويقول: أما أنا فأقول لكم”. تصوروا، أن أحد الآباء الكهنة خلال الوعظة يقول: إعزائي البابا يقول كذا وكذا، لكن أنا فأقول لكم!! إخوتي مكتوبٌ في الكتاب المقدس: كذا وكذا. أما أنا فأقول لكم!
نحن لدينا الوعي الكامل، الوعي الثقافي والطبي أنّه إن وقع أحدنا وكسر ساقه، عليه أن يذهب الى الطبيب ويجبرها وإلا سيكون أعرج طول حياته. لكن مع الأسف ليس لدينا الوعي الكافي لكيما اذا كُسر قلبنا وتهشم من… ومن… نهرع للذهاب الى من يشفيه، لا نعي أننا سنكون عرجا روحياً ونفسياً إلى الأبد. وكم من القلوب تهشمت، وكسرت، وتحطمت من جراء، كلمة، نظرة، حركة… دون أن نعي أن فلانا (الذي جرحناه) سيبقى مكسوراً روحياً ونفسياً مدى الدهر.
البعض من المسيحيين يعيشون مسيحيتهم بالشكل الحرفي، تطبيقهم للوصايا هو تطبيق رابي شمّاي حتى على ذاتهم. يوماً ما وكنت أعرّف (أقول هذا الحادث، لأن المعترف كررها عدة مرات أمام الأخوية) جاءني تائب يقول: أبونا أنا أذهب كل أحد للقداس، أحترم أهلي لا أسرق، لا أقتل، لا أزني، لم أشهد بالزور أبداً…. وعندما أنهى قلت له، برافو، انت يهودي تقي 100%، فنظر إلي مستغرباً من هذا الكلام، وتابعت قائلاً: الآن انتهينا من العهد القديم فلننتقل للعهد الجديد وبدأت تعليما مسيحيا معه! إن هذا الشخص في عدة لقاءات أعطى شهادة إعتراف عن إعترافه هذا، وتبديل نظرته للوصايا، للمسيحية. المسيحية ليس دين وصايا، أوامر ونواهي! هي المحبة، المحبة فقط.
إن أعش مسيحيتي فقط كتنفيذ للوصايا، فيا حسرتي على حالي. أما إن عشت المحبة فالوصايا ستعاش في حياتي عفوياً. فإن أحب الأخ أخاه من المستحيل أن يفتري عليه، أو يضربه، أو يستهزئ به ويقتله! يسوع يهاجم المحافظة المتحجرة في تطبيق الوصايا، يسوع يحارب انحطاط الامتثال للقانون الجامد، يسوع ينقد المحافظة الشكلية الخالية من المحبة الصادقة، من الايمان العميق. يسوع يريد أن يعلم أن الكمال هو في جوهر الوصايا ليس في الوقوف على حذافير الأمور. كم من حماة عابت كنتها فقط لأن الكنه لم تقم بواجبها 100%. فالحماة تريد أن تنفّذ الوصية بحذافيرها، 100%. لكن المحبة؟ لكن جوهر العلاقة؟
أختم بما كان يقوله القديس أغسطينوس: أحبب وافعل ما تشاء.